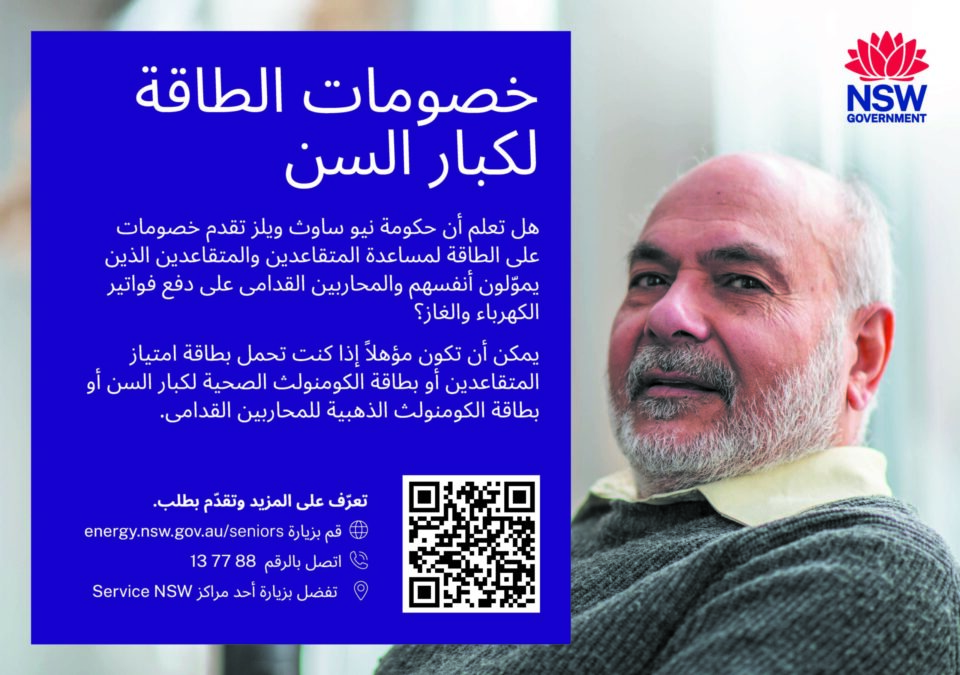https://furatnews.com/Books/mobile/index.html
سيرة الاغتراب: حفريات في جسد المنفى.
“سيرة كوردي في زمن العدمية” حسين خوشناو _ أستراليا
ما قبل العاصفة: تحوّلات الذات والمجتمع قبل 1991
كانت سنوات الثمانينات بالنسبة لنا، نحن الكورد، أشبه بمرحلة الاحتباس الطويل؛ حيث تجمّعت التناقضات الداخلية والخارجية في عمق النفس الكوردية كما تتراكم السحب الداكنة في الأفق قبل أن تُمطر غضبًا. لم يكن السكون الظاهري الذي ساد بعد الحرب العراقية الإيرانية سوى هدنة هشة على جسد اجتماعي ممزق، يحمل في داخله بذور الرفض المتقلب، والغضب المكبوت، والحنين الأبدي إلى ما لم يُنجز بعد من أحلام الوطن. كانت ذاتي الكوردية تعيش لحظة انقسام داخلي مرير: بين الاستسلام للواقع المفروض بالقوة، وبين يقظة خفية تتلمّس طريقها بصعوبة تحت الرماد المتراكم من القمع. في هذا المناخ الضاغط، بدأت تتشكل بذور “الولادة الأولى” لوعيٍ مضطرب، وعيٍ يتلمس طريقه نحو الوجود الحقيقي.
لتحولات لم تكن سياسية فقط، بل اجتماعية ونفسية أيضًا. فالعائلة الكوردية التي اعتادت الصمت والطاعة المطلقة، بدأت تشهد تصدعات عميقة في بنيتها التقليدية، حيث أصبح الأب، رمز الانضباط والطاعة المطلقة، عاجزًا عن تقديم إجابات مقنعة لجيلٍ جديد يرى التناقضات بعيونه المفتوحة، لا من خلال الخوف والتقاليد القديمة. بدأ الأطفال يطرحون أسئلة لم يكن الأهل قادرين على سماعها أو الإجابة عنها، وبدأت الأمهات يهمسن بحقائق مدفونة منذ زمن بعيد، كأنّ الصمت الطويل لم يعُد يحمي أحدًا، ولم يعد له أي معنى. أما النخبة المثقفة، فكانت تعيش ما يشبه الغربة داخل الوطن. المثقف الكوردي صار موزّعًا بين لغة رسمية لا تعبّر عنه، ولغة أمّ مُحرّمة في المدارس. وبين فكر نقدي يُطارد إن نُشر، وحسّ قومي يتّهم بالخيانة إن نُطق به. لكنه رغم ذلك، لم يصمت. كانت القصيدة تكتب سرًّا، والمقال يهرب في جيب مسافر، والخطاب يُدوَّن على حواف دفاتر الرياضيات المدرسية، محاولين نحت فسحة للوعي في عالم ضيق ومُراقَب، مؤكدين أن “الولادة الفكرية” لا يمكن قمعها.
كل شيء كان يشي بأن العاصفة قادمة لا محالة. ليس لأنّنا أردنا الحرب، بل لأننا تعبنا من الصمت القاتل، تعبنا من الوجود المذل الذي اختزلنا إلى مجرد أرقام في قوائم الموت. لم يكن الأمر يتعلق فقط بمعارضة نظام سياسي، بل برغبة حارقة في استعادة المعنى للوجود، في إيجاد مكان تحت الشمس لا يُمنح كصدقة، بل يُنتزع بأيدي الأحرار، وكأنها ضرورة وجودية لا مفر منها تُمهد لـ”ولادة ثالثة” قسرية.
وكان مارس 1991 على الأبواب… في تلك الليالي التي سبقت الانفجار، وبينما كانت الأحلام تختلط بالواقع، كنت أرى في أحلامي حوارًا سرياليًا وميتافيزيقيًا بين الظلمة والنور، بين اليأس والأمل. الظلمة، بصوت أجوف يهز أركان الكون: “لن تستيقظوا أبدًا، فقد نسجتُ الخوف في عروقكم، وزرعتُ اليأس في خلاياكم. أنتم عبيدي الأبديون، محكومون بالعدم والفناء، لا مفر لكم مني.” النور، بصوت خافت ولكنه ثابت كصوت الجبال الشامخة: “ولكن الخوف نفسه سيصبح وقودًا لشمسٍ لا تغيب أبدًا. سينير دروب الثائرين، ويحرق سجونكم. لا قدر إلا ما نصنعه نحن بأنفسنا، بدموعنا وغضبنا وإصرارنا. نحن سنكتب قدرنا بأيدينا. الوجود هو صراع مستمر ضد العدم، وبذرة الأمل تنبت حتى في أرض اليأس، لتُعلن عن ولادة متجددة للروح.” هل كانت هذه الحوارات مجرد أحلام مضطربة من عقل منهك، أم أنها أصداء لوعي جمعي يتشكل في عالم ما وراء الوعي، يتنبأ بالانفجار القادم؟ هل كانت هذه هي حقيقة الوجود، صراع أزلي بين قوى متناقضة، أم مجرد قصيدة شعرية خطّتها يد القدر على صفحات الروح، تنتظر من يقرأها بصوت عالٍ في لحظة تجلي؟
في هذا السياق المشحون بالتوتر الوجودي، حيث كانت الذات الكوردية تتأرجح بين العدم والوجود، يتجلى مفهوم “القلق” الذي تحدث عنه مارتن هايدغر بوصفه جوهر الكينونة البشرية. فالسؤال “من نحن؟” الذي طرحته النفس الكوردية لم يكن مجرد استفسار هوياتي، بل كان مواجهة ميتافيزيقية مع العدم الذي يتربص بالوجود. كما يرى هايدغر، فإن القلق هو حالة أنطولوجية تنبثق عندما يواجه الإنسان هشاشة وجوده، عندما يدرك أن لا شيء يضمن بقاءه سوى إرادته في مواجهة العدم. هذا القلق، الذي تجسد في جلسات الكورد السرية وهمساتهم المحرمة، لم يكن ضعفًا، بل كان بذرة الوعي التي ستؤدي إلى “الولادة الأولى” للذات المقاومة. إن الاغتراب الذي عاشته النفس الكوردية في ظل القمع لم يكن مجرد غربة جغرافية أو سياسية، بل كان اغترابًا وجوديًا، كما وصفه سارتر: حالة يجد فيها الإنسان نفسه ملقىً في عالم لا يعترف به، عالم يفرض عليه هوية زائفة، ويجبره على إعادة صياغة وجوده من خلال الفعل الحر.
في هذا الإطار، يمكن قراءة الصمت الاجتماعي في الثمانينات كفعل مقاومة ضمني، كما لو أن الكورد، في صمتهم، كانوا يحفرون في أعماق أرواحهم ليجدوا معنى لوجودهم. يقول نيتشه: “يجب أن تحمل الفوضى في داخلك لتلد نجمًا راقصًا.” هذه الفوضى الداخلية، التي تجسدت في التناقض بين الاستسلام واليقظة، لم تكن إلا إرهاصات لنجم راقص سيولد في انتفاضة 1991. فالأغاني الحزينة في القرى، والكتب الممنوعة في المدن، والخطابات السرية في المساجد، كلها كانت أشكالًا من التمرد الوجودي، محاولات لتجاوز العدمية التي فرضها النظام. إن هذه الحالة تعكس ما وصفه ألبير كامو بالتمرد: “أتمرد، إذًا أنا موجود.” التمرد هنا لم يكن بعدُ ثورة مسلحة، بل كان تمردًا روحيًا، إصرارًا على البحث عن المعنى في عالم يحاول إلغاء الذات الكوردية.
كذلك، فإن تصدع البنية التقليدية للعائلة الكوردية يعكس مفهوم كيركغور عن “اليأس” كحالة وجودية تنشأ عندما تفقد الذات توازنها بين المحدود واللامحدود. الأب، الذي كان رمزًا للسلطة، وجد نفسه عاجزًا عن تقديم إجابات لجيل يطالب بحرية لا تقبل التأجيل. هذا التصدع لم يكن انهيارًا، بل كان إرهاصًا لولادة جديدة، ولادة وعي جماعي يرفض القبول بالواقع المفروض. إن الهمسات السرية للأمهات، والأسئلة الجريئة للأطفال، والقصائد المكتوبة على هوامش الدفاتر، كلها كانت أفعالًا وجودية تؤكد أن الذات الكوردية، رغم القمع، لا تزال حية، تبحث عن معنى لوجودها في مواجهة العدم. وكما يقول فيكتور فرانكل: “إن من يملك سببًا ليعيش من أجله، يمكنه تحمل أي شيء.” هذا السبب، بالنسبة للكورد، كان الحلم بالحرية، الحلم الذي كان ينبض في صمت الجدران، في الأغاني الحزينة، وفي الكتب الممنوعة، ممهدًا لولادة وعي لا يمكن إخماده.
تحرير كوردستان: قوس الفرح بعد قرن من الظلم
في لحظة تاريخية لا تشبه سواها، لحظة نحتت في صميم الذاكرة الجماعية، انقشعت سُحب الذعر والخذلان التي طالما خنقت أرواحنا، وارتفعت رايات التحرير ترفرف بفخر فوق جبال وسهول كوردستان، كأنها أشرعة سفينة النجاة التي وصلت بعد رحلة محفوفة بالهواجس. المدن تتساقط من قبضة النظام الوحشي واحدة تلو الأخرى، كأنها تخلع عن نفسها عباءة الموت السوداء التي طالما أثقلتها، وتُلقيها بعيداً. كركوك، قدس كوردستان، تلك المدينة التي طالما حلم بها الكورد كحلم مقدس، تتحرر أخيرًا، وتتنفس هواء الانعتاق الحر لأول مرة منذ عقود. من زاخو إلى خانقين، من السليمانية إلى دهوك، من أربيل إلى رانية، يعود الوطن من ليل الغياب الطويل، ويستفيق الكورد على يوم لم يحلموا أن يعيشوه يقظةً، يوماً كتبوه بدمائهم، وعمدوه بالصمود، إنه تجسيد لـ”الولادة العظمى” للوطن.
إنها لحظة الفرح الأكبر منذ قرن كامل من الظلم والقهر؛ لحظة لم يصنعها اتفاق دولي مخادع ولا صفقة سِرّية خلف الستار، بل صيحات الناس الصادقة، أقدام الفقراء العارية التي وطأت أرض الحرية، وأحلام الذين ولدوا في المنافي القاسية والمعتقلات المظلمة والمقابر الجماعية المجهولة. الحرية لم تهبط من السماء كهدية، بل انتُزعت من بين أنياب الوحش الذي افترس حياتنا، بخوف الأمهات الذي تحول إلى قوة لا تُقهر، ودموع الجياع التي أصبحت أنهاراً من العزم، وعزم الشباب الذي لم يرضخوا للسجن ولا المنفى ولا النفي من الحياة، وكأنهم يعيدون تعريف “الوجود” من خلال فعل التحرر ذاته، في “ولادة رابعة” لإرادة شعبية لا تقهر.
في الساحات العامة، تزاحمت الأجساد بفرح لا يُوصف، فرح لم تتسع له الأرض، هتافات تعبر عن مئة عام من الألم المكبوت، تخرج دفعة واحدة كقنبلة ضوئية في ليلٍ قاتم، تنير الأفق. العجائز الذين عاشوا مذبحة “سيميل” و”حلبجة” الكيميائية، يبتسمون لأول مرة ابتسامة حقيقية، كأنهم يرون الوطن يزهر من تحت التراب، ينهض من رماده كطائر الفينيق. الأطفال يركضون بين جدران كانت بالأمس معتقلات مظلمة، واليوم صارت مدارس تفتح أبوابها للحياة والأمل. الشوارع امتلأت بقرع الطبول الحماسي، بزغاريد النساء التي تملأ الفضاء، وبتكبيرات الرجال الذين طالما قُهرت حناجرهم ومنعوا من التعبير، وكأنها لحظة “الولادة الوجودية” التي انتظروها طويلاً، لحظة تتجلى فيها ماهية هذا الشعب.
كوردستان كانت ولّادة للغصة، للأسى، وللموت، والآن صارت تولد من رحمها ثانيةً، ولكن هذه المرة من دون قيد، من دون خوف، ولو للحظة واحدة، مؤكدة على قدرة الروح على التجدد. حتى الهواء صار أخف، حتى الأرض تنفست الصعداء. شعر الناس بأنهم ليسوا مجرد ضيوف على ترابهم، بل أصحاب الحق الحقيقيون في هذه الأرض. امتلأت البيوت بأحاديث الحلم الذي طالما راودنا: سنزرع أرضنا مجدداً، سنبني جامعاتنا الخاصة، سنُعيد منفيينا إلى أحضان الوطن، سنكتب دستورنا بلغتنا الكوردية الأم، وسنُطلق أسماء شهدائنا الأبطال على الأزقة التي كانت تُسمّى بأسماء جلادينا.
هذا الوطن الذي طالما كُتبت خريطته بالدم، يُعاد رسمه بالحب والأمل والعزيمة. لا سجون، لا استخبارات تتربص بنا، لا بعث يطاردنا، لا رجال أمن يطاردون فكرة أو حلماً. لأول مرة، لم يكن هناك فرق بين الكوردي العامل في الحقل، أو الطالب في المدرسة، أو البيشمركة في الجبل. كلهم كانوا أحراراً، وكلهم شعروا أن شيئًا عميقًا تغير في جوهر وجودهم. عادت الحياة، ليس بمعناها البيولوجي فقط، بل بمعناها الكوردي، بمعناها الإنساني العميق. عادت الأغاني المحرّمة، واللغة التي كانت تُقصّ ألسنتها صارت تُدرّس في المدارس. ارتدت الأمهات ثياب الحصاد لا الحداد، وتوقف الوقت في كوردستان للحظة أبدية: لحظة شعور جمعي لم تعرفه هذه الأرض منذ سايكس-بيكو. هنا، يتردد صدى كلمات الشاعر العظيم محمود درويش: “نحن نكتب حياتنا كما نكتب أرضنا”، فهل هذه الكتابة الدموية، هذه الملحمة من الصراع والمعاناة، هي التجسيد الأسمى للوجود والحرية، أم أنها قصيدة لم تُنتهَ بعد، تنتظر منا أن نخط آخر أبياتها بحبر الأمل الذي لا يجف، مؤكدين على أن كل نهاية هي بداية لولادة جديدة؟
لحظة تحرير كوردستان، كما وصفتها، ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي تجسيد لما أسماه سارتر “الحرية الوجودية”، تلك الحرية التي لا تُمنح بل تُنتزع من خلال الفعل الواعي. الكورد، في هذه اللحظة، لم ينتظروا موافقة العالم أو هبة من السماء، بل اختاروا أن يكونوا فاعلين في تاريخهم، مؤكدين أن الوجود لا يكتمل إلا عبر الفعل الحر. كما يقول سارتر: “الإنسان محكوم عليه بالحرية”، وهذه الحرية تتطلب مواجهة العبثية، مواجهة عالم لا يقدم ضمانات، بل يترك الإنسان وحيدًا أمام مسؤوليته في صياغة مصيره. إن انتزاع الحرية من أنياب النظام الوحشي كان بمثابة إعلان وجودي: الكورد ليسوا مجرد ضحايا للتاريخ، بل هم صانعوه.
هذه اللحظة تعكس أيضًا مفهوم نيتشه عن “إرادة القوة”، ليس كسلطة على الآخرين، بل كتجاوز للذات، كقدرة على تحويل الألم إلى قوة خلاقة. دموع الجياع التي أصبحت أنهارًا من العزم، وخوف الأمهات الذي تحول إلى قوة لا تُقهر، هي تجسيد لهذه الإرادة. الكورد، في هذه اللحظة، لم يقاوموا فقط نظامًا سياسيًا، بل قاوموا العدمية التي تحاول إلغاء وجودهم، مؤكدين أن الحياة لا تكتسب معناها إلا من خلال الصراع من أجل الحرية. كما يقول كامو: “في مواجهة العبث، التمرد هو السبيل الوحيد لإعطاء الحياة معنى.” الفرح الذي ملأ الساحات، والأغاني التي عادت إلى الشوارع، واللغة التي أُعيدت إلى المدارس، كلها كانت أفعال تمرد وجودي، تأكيد على أن الوجود الكوردي ليس مجرد بقاء بيولوجي، بل هو إصرار على الحياة بمعناها الأعمق.
أما توقف الزمن في تلك اللحظة الأبدية، فهو يذكرنا بمفهوم هايدغر عن “الكينونة في الزمن”. الزمن، في هذا السياق، لم يكن مجرد تسلسل خطي للأحداث، بل كان لحظة تجلي حيث تتجمع الماضي (مذبحة سيميل وحلبجة)، والحاضر (الانتفاضة)، والمستقبل (حلم الدستور والجامعات)، في نقطة واحدة من الوعي الجمعي. هذه اللحظة لم تكن نهاية، بل كانت بداية لولادة جديدة، كما يصفها درويش، حيث تُكتب الحياة كما تُكتب الأرض. إن هذه الكتابة الدموية ليست مجرد سجل للمعاناة، بل هي إعلان ميتافيزيقي عن خلود الروح الكوردية، روح ترفض أن تُمحى من الوجود، وتجد في كل ألم بذرة لتجدد لا نهائي.
الفجر الدامي: كوردستان تستعيد روحها:
يُقال إن كل فجرٍ يحمل في طياته شمسًا لا يعرفها الليل، وإن الأمل يولد من رحم اليأس ذاته. فهل كانت تلك اللحظة التي سبقت فجر الخامس من آذار 1991 مجرد انتظار؟ أم كانت صمتًا كونيًا يتأهب لصرخة وجودية تهز أركان الزمان؟ وكما قال ألبير كامو: “في عمق الشتاء وجدتُ أن في داخلي صيفًا لا يُقهر”. هكذا استيقظنا على موسيقى النار، لا موسيقى تُعزف على آلات، بل على أرواحنا المشتعلة، على قلوبنا التي كانت ترتجف فرحًا وترقبًا. لا أحد دعا إلى الثورة في وضح النهار، لكنها كانت تعرف موعدها، كأن التاريخ قرر فجأة أن يكتب نفسه بلغة جديدة، بلغة الفقراء والمقموعين، بلغة من طحنهم الصمت عقودًا من الزمن. الأزقة الكوردية تنفست بثورة، ورأيتُ جدران البيوت، التي كانت شاهدة على الكثير من الخوف والهمس، ترتجف كأنها تصلي، تهتز طربًا أو رعبًا من هذا التحول العظيم. الناس لم يعودوا أفرادًا متفرقين، كل في زاوية خوفه، بل تحولوا إلى موجٍ صاعدٍ لا يتوقف، حناجر تردد نفس النداء وإن اختلفت اللهجات من قرية لأخرى، من حارة لأخرى: “كفى! كفى الظلم! كفى الصمت!”.
النساء، أولئك اللواتي كن يحملن عبء الوطن على أكتافهن في صمت، خرجن ووجوههن تلمع بدموع الكبرياء، لا بدموع الحزن. كنّ يحملن صور من رحلوا غدرًا، وأسماء من لا يزالون في المجهول، كأنهن يطرزن الذاكرة في الهواء، ينسجن قصص الفقد على قماشة الحرية. من أربيل إلى كركوك، ومن دهوك إلى مدينتي شقلاوة التي كانت تنام طويلًا تحت وطأة الكبت والقمع، رأيت كوردستان كلها تصحو كعذراء تستعيد جسدها بعد سبات إجباري طويل. في كل زاوية، وفي كل مدينة كوردية، كان كل حجر يهتف، وكل نافذة تفتح على قصيدة لم تُكتب بعد، وكل شجرة زيتون تهمس بقصة صمود، وكأن الطبيعة نفسها تشارك في “الولادة الثالثة” لهذه الأرض. الشباب الذين كانوا يُعتقلون بالأمس بتهمة الحلم، مجرد الحلم بوطن حر، صاروا اليوم يقودون الزحف المقدس نحو مراكز الأمن، نحو الجدران التي كانت تُخفي العتمة والقمع. كان الهواء يمتلئ برائحة البارود ممزوجة برائحة التراب الرطب والأمل، رائحة لم أشمها منذ ولدت، رائحة ميلاد جديد.
تحسين النقشبندي، الرائد البعثي الذي كان يسكن وجوهنا كرعب قديم، كابوس يومي لا مفر منه، صار اسمه يُطارد في كل زقاق، يُبصق عليه في الأزقة وكأنه رمز للخيانة والانكسار. مشينا لا نملك شيئًا سوى الغضب المتراكم، الغضب الذي تحول إلى قوة دافعة، لكنه كان كافيًا لتغيير مجرى التاريخ. أسقطنا الصنم، لا بأيدينا فقط، بل بأرواحنا التي احترقت كشموع أبدية في ليلٍ طويل مظلم. كأننا نُعيد تعريف الزمن نفسه: قبل الانتفاضة وبعدها. كأن الجدران التي كانت تسجننا لم تعد تلك الجدران، بل بدأت تتهاوى تحت وقع الخطى الثائرة، لا تحت وقع القذائف، في فعل وجودي للتخلص من الأغلال المادية والروحية.
رأيت أحد رفاقي، وجهه الشاحب محفورٌ فيه الألم، يبكي وهو يُحطم صورة للطاغية المعلقة على جدار مركز الأمن. اقتربت منه، وكنتُ أظنها دموع حزن على السنوات الضائعة، فقلت له: “تبكي؟ بعد كل هذا النصر؟” أجابني بصوت مخنوق بالوجع والفرح، لكن عينيه كانتا تلمعان بضوء غريب، ضوء كوني: “هذه دموع ولادة يا صديقي، لا دموع حزن! أتفهم؟ إنها دموع الوعي المنبثق من العدم، من سنوات الظلام التي قضيناها في دهاليز الخوف واليأس. هل هذا الألم الذي عشناه، كل هذه السنوات من القهر، كان مجرد بذرة لنورٍ كهذا؟ هل كان يجب علينا أن نمر بكل هذا الجحيم لنصل إلى هذه اللحظة من التجلي؟” فهمت حينها أن الحرية لا تأتي على صهوة شعار سياسي أو وعد كاذب، بل على هيئة دمعة تُسقط جدارًا من الخوف المزمن، دمعة تكسر حاجز اللاوعي الجماعي الذي فُرض علينا. الناس لم يعودوا خائفين من الموت، فقد ذاقوا مرارة العيش في موتٍ مستمر، بل صاروا خائفين من الفشل في اغتنام هذه اللحظة التي تأخرت طويلًا، وكأنها لحظة اختيار وجودي بين العدم والبقاء. حتى السماء، تلك الليلة، كانت تمطر نجومًا لا مطرًا، كأنها تحتفل بنا، تشهد على تحرر النفوس من قيدها الميتافيزيقي الذي فرضه الطغاة.
الانتفاضة، في حقيقتها العميقة، لم تكن فقط لحظة سياسية عابرة. كانت طقسًا وجوديًا، عبورًا جماعيًا من العدم إلى المعنى، من حالة اللاوجود إلى قسوة الوعي بالذات. ولدتُ مرة ثالثة: الأولى من رحم أمي، إلى هذا العالم الفاني، وهي ولادة جسدية. الثانية من رحم السجن، حيث تجلى لي معنى الحدود بين الجسد المادي والروح الأبدية، وحيث أدركت أن الحرية هي حالة ذهنية لا مكانية، وهي ولادة وعي بالذات. والثالثة من رحم الانتفاضة، حيث انصهر الفرد في الوعي الجمعي، متسائلًا: هل هذه الولادة المتجددة هي تجسيد للروح الأزلية للشعب التي تأبى الفناء، روح تتجدد كلما حاولت قوى الظلام سحقها، كفراشة تخرج من شرنقة العدم، باحثة عن فضاء تتجلى فيه حقيقة الوجود؟ هذه الولادات المتتالية أكدت لي أن الوجود ليس حالة ثابتة، بل هو سلسلة من التحولات، سلسلة من الموت والبعث، وكلما ظننا أننا وصلنا إلى النهاية، تبرز روحنا من جديد، أقوى وأكثر وعياً بحدودها اللانهائية.
إن هذا الفجر الدامي، بكل ما حمله من تناقض بين الأمل والألم، يعكس مفهوم كيركغور عن “قفزة الإيمان”، تلك اللحظة التي يتجاوز فيها الإنسان حدود الخوف واليأس ليؤكد وجوده من خلال فعل الإيمان بالمعنى الأعلى. الكورد، في هذه اللحظة، لم يقفزوا فقط نحو الحرية السياسية، بل قفزوا نحو تأكيد وجودهم كشعب لا يمكن محوه من خريطة الوجود. هذه القفزة لم تكن خالية من الدماء، بل كانت مشبعة بالتضحيات، كما لو أن كل قطرة دم كانت توقيعًا على وثيقة الوجود الأبدي. يقول كيركغور إن الإيمان يتطلب مواجهة اليأس، وهذا اليأس تجسد في سنوات القمع التي سبقت الانتفاضة، حيث كان الكورد يعيشون في حالة من “المرض حتى الموت”، ليس موتًا جسديًا، بل موتًا روحيًا يفرضه الصمت والخوف.
لكن هذا الفجر كان أيضًا تجسيدًا لفكرة كامو عن “الإنسان المتمرد”. التمرد هنا لم يكن مجرد رفض للنظام السياسي، بل كان رفضًا للعدمية التي تحاول إلغاء الذات الكوردية. النساء اللواتي خرجن بدموع الكبرياء، والشباب الذين قادوا الزحف المقدس، والجدران التي هتفت مع الثوار، كلها كانت أفعال تمرد وجودي، تأكيد على أن الحياة تستحق أن تُعاش فقط عندما تكون حرة. كما يقول كامو: “التمرد يخلق القيمة”، وهذه القيمة تجسدت في إعادة تعريف الزمن نفسه: قبل الانتفاضة وبعدها، كما لو أن الكورد أعادوا كتابة التاريخ ليس فقط كسرد سياسي، بل كسرد ميتافيزيقي يؤكد أن الوجود لا يكتمل إلا من خلال الصراع ضد العدم.
إن دموع الرفيق التي وصفتها ليست مجرد دموع فرح أو حزن، بل هي، كما يصفها هايدغر، تجربة “الدهشة” الأنطولوجية، تلك اللحظة التي يدرك فيها الإنسان عمق وجوده في مواجهة العالم. هذه الدموع كانت تعبيرًا عن وعي جديد، وعي يدرك أن الألم ليس نهاية، بل هو بداية لتجلي جديد. إنها دموع “الولادة الثالثة”، ولادة الوعي الذي يرفض أن يكون ضحية، ويختار أن يكون فاعلاً في مصيره، مؤكدًا أن الوجود الكوردي ليس مجرد رد فعل على الظلم، بل هو فعل إبداعي يعيد صياغة المعنى في عالم يحاول إلغاءه.
يتبع __ الفصل الثاني
او زيارة موقع الفرات لقراءة الفصل كامل: