سيرة الاغتراب: حفريات في جسد المنفى
سيرة كوردي في زمن العدمية” حسين خوشناو _ أستراليا
ما قبل العاصفة: تحوّلات الذات والمجتمع قبل 1991
كانت س نوات الثمانينات بالنسبة لنا، نحن الكورد، أشبه بمرحلة الاحتباس الطويل؛ حيث تجمّعت التناقضات الداخلية والخارجية في عمق النفس الكوردية كما تتراكم السحب الداكنة في الأفق قبل أن تُمطر غضبًا. لم يكن السكون الظاهري الذي ساد بعد الحرب العراقية الإيرانية سوى هدنة هشة على جسد اجتماعي ممزق، يحمل في داخله بذور الرفض المتقلب، والغضب المكبوت، والحنين الأبدي إلى ما لم يُنجز بعد من أحلام الوطن. كانت ذاتي الكوردية تعيش لحظة انقسام داخلي مرير: بين الاستسلام للواقع المفروض بالقوة، وبين يقظة خفية تتلمّس طريقها بصعوبة تحت الرماد المتراكم من القمع. في هذا المناخ الضاغط، بدأت تتشكل بذور “الولادة الأولى” لوعيٍ مضطرب، وعيٍ يتلمس طريقه نحو الوجود الحقيقي.
نوات الثمانينات بالنسبة لنا، نحن الكورد، أشبه بمرحلة الاحتباس الطويل؛ حيث تجمّعت التناقضات الداخلية والخارجية في عمق النفس الكوردية كما تتراكم السحب الداكنة في الأفق قبل أن تُمطر غضبًا. لم يكن السكون الظاهري الذي ساد بعد الحرب العراقية الإيرانية سوى هدنة هشة على جسد اجتماعي ممزق، يحمل في داخله بذور الرفض المتقلب، والغضب المكبوت، والحنين الأبدي إلى ما لم يُنجز بعد من أحلام الوطن. كانت ذاتي الكوردية تعيش لحظة انقسام داخلي مرير: بين الاستسلام للواقع المفروض بالقوة، وبين يقظة خفية تتلمّس طريقها بصعوبة تحت الرماد المتراكم من القمع. في هذا المناخ الضاغط، بدأت تتشكل بذور “الولادة الأولى” لوعيٍ مضطرب، وعيٍ يتلمس طريقه نحو الوجود الحقيقي.
عادت أحاديث الهوية لتتسلل في الجلسات المغلقة، بين أنفاس الحذر، وبين صمت الجدران التي كانت تحمل أسرارًا. صار السؤال الوجودي “من نحن؟” أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، سؤال يطرح نفسه في كل لحظة، بعد أن بدا أن الحرب لم تُنهِ فقط الأحلام الوردية، بل أعادت ترتيب المفاهيم الأساسية للوجود والانتماء. فالمقاتل الذي عاد من الجبهة محطّمًا، لم يكن فقط ضحية حرب عبثية لا معنى لها، بل شاهدًا حيًا على هشاشة الانتماء الذي فُرض عليه بالسلاح والدعاية الكاذبة، وكأن الوطن الذي قاتل من أجله لم يكن سوى خديعة كبرى، مُجبرًا إياه على إعادة تقييم جوهر وجوده.
في القرى النائئة، ظلّت الأغاني القديمة تُغنّى في الأعراس، لكنّ نغمتها كانت حزينة أكثر من اللازم، تحمل في طياتها مرارة الغربة والوحدة، وكأنها ترانيم جنائزية لأحلام لم تتحقق. في المدن، صار الشباب يتهامسون عن ثورات بعيدة، وعن تجارب أممٍ نهضت رغم القمع والاضطهاد، وكأنهم يبحثون عن مرآة يرون فيها وجوههم الحرة. كانت الكتب الممنوعة تُتداول بسرية تامة، وتُقرأ كأنها خريطة نجاة روحية، دليل للخروج من الظلام الدامس. حتى المساجد، التي طالما احتُكرت من قبل السلطة لفرض طاعتها وسيادتها، بدأت تشهد خطابًا جديدًا، فيه نَفَسُ مقاومة وإن كان مغلفًا بالورع والكلمات الدينية، كأن الوعي يجد طريقه حتى في أروقة القدسية المقيدة، مُمهدًا لـ”ولادة ثانية” لوعيٍ أكثر جرأة.
التحولات لم تكن سياسية فقط، بل اجتماعية ونفسية أيضًا. فالعائلة الكوردية التي اعتادت الصمت والطاعة المطلقة، بدأت تشهد تصدعات عميقة في بنيتها التقليدية، حيث أصبح الأب، رمز الانضباط والطاعة المطلقة، عاجزًا عن تقديم إجابات مقنعة لجيلٍ جديد يرى التناقضات بعيونه المفتوحة، لا من خلال الخوف والتقاليد القديمة. بدأ الأطفال يطرحون أسئلة لم يكن الأهل قادرين على سماعها أو الإجابة عنها، وبدأت الأمهات يهمسن بحقائق مدفونة منذ زمن بعيد، كأنّ الصمت الطويل لم يعُد يحمي أحدًا، ولم يعد له أي معنى. أما النخبة المثقفة، فكانت تعيش ما يشبه الغربة داخل الوطن. المثقف الكوردي صار موزّعًا بين لغة رسمية لا تعبّر عنه، ولغة أمّ مُحرّمة في المدارس. وبين فكر نقدي يُطارد إن نُشر، وحسّ قومي يتّهم بالخيانة إن نُطق به. لكنه رغم ذلك، لم يصمت. كانت القصيدة تكتب سرًّا، والمقال يهرب في جيب مسافر، والخطاب يُدوَّن على حواف دفاتر الرياضيات المدرسية، محاولين نحت فسحة للوعي في عالم ضيق ومُراقَب، مؤكدين أن “الولادة الفكرية” لا يمكن قمعها.
كل شيء كان يشي بأن العاصفة قادمة لا محالة. ليس لأنّنا أردنا الحرب، بل لأننا تعبنا من الصمت القاتل، تعبنا من الوجود المذل الذي اختزلنا إلى مجرد أرقام في قوائم الموت. لم يكن الأمر يتعلق فقط بمعارضة نظام سياسي، بل برغبة حارقة في استعادة المعنى للوجود، في إيجاد مكان تحت الشمس لا يُمنح كصدقة، بل يُنتزع بأيدي الأحرار، وكأنها ضرورة وجودية لا مفر منها تُمهد لـ”ولادة ثالثة” قسرية.
وكان مارس 1991 على الأبواب… في تلك الليالي التي سبقت الانفجار، وبينما كانت الأحلام تختلط بالواقع، كنت أرى في أحلامي حوارًا سرياليًا وميتافيزيقيًا بين الظلمة والنور، بين اليأس والأمل. الظلمة، بصوت أجوف يهز أركان الكون: “لن تستيقظوا أبدًا، فقد نسجتُ الخوف في عروقكم، وزرعتُ اليأس في خلاياكم. أنتم عبيدي الأبديون، محكومون بالعدم والفناء، لا مفر لكم مني.” النور، بصوت خافت ولكنه ثابت كصوت الجبال الشامخة: “ولكن الخوف نفسه سيصبح وقودًا لشمسٍ لا تغيب أبدًا. سينير دروب الثائرين، ويحرق سجونكم. لا قدر إلا ما نصنعه نحن بأنفسنا، بدموعنا وغضبنا وإصرارنا. نحن سنكتب قدرنا بأيدينا. الوجود هو صراع مستمر ضد العدم، وبذرة الأمل تنبت حتى في أرض اليأس، لتُعلن عن ولادة متجددة للروح.” هل كانت هذه الحوارات مجرد أحلام مضطربة من عقل منهك، أم أنها أصداء لوعي جمعي يتشكل في عالم ما وراء الوعي، يتنبأ بالانفجار القادم؟ هل كانت هذه هي حقيقة الوجود، صراع أزلي بين قوى متناقضة، أم مجرد قصيدة شعرية خطّتها يد القدر على صفحات الروح، تنتظر من يقرأها بصوت عالٍ في لحظة تجلي؟
في هذا السياق المشحون بالتوتر الوجودي، حيث كانت الذات الكوردية تتأرجح بين العدم والوجود، يتجلى مفهوم “القلق” الذي تحدث عنه مارتن هايدغر بوصفه جوهر الكينونة البشرية. فالسؤال “من نحن؟” الذي طرحته النفس الكوردية لم يكن مجرد استفسار هوياتي، بل كان مواجهة ميتافيزيقية مع العدم الذي يتربص بالوجود. كما يرى هايدغر، فإن القلق هو حالة أنطولوجية تنبثق عندما يواجه الإنسان هشاشة وجوده، عندما يدرك أن لا شيء يضمن بقاءه سوى إرادته في مواجهة العدم. هذا القلق، الذي تجسد في جلسات الكورد السرية وهمساتهم المحرمة، لم يكن ضعفًا، بل كان بذرة الوعي التي ستؤدي إلى “الولادة الأولى” للذات المقاومة. إن الاغتراب الذي عاشته النفس الكوردية في ظل القمع لم يكن مجرد غربة جغرافية أو سياسية، بل كان اغترابًا وجوديًا، كما وصفه سارتر: حالة يجد فيها الإنسان نفسه ملقىً في عالم لا يعترف به، عالم يفرض عليه هوية زائفة، ويجبره على إعادة صياغة وجوده من خلال الفعل الحر.
في هذا الإطار، يمكن قراءة الصمت الاجتماعي في الثمانينات كفعل مقاومة ضمني، كما لو أن الكورد، في صمتهم، كانوا يحفرون في أعماق أرواحهم ليجدوا معنى لوجودهم. يقول نيتشه: “يجب أن تحمل الفوضى في داخلك لتلد نجمًا راقصًا.” هذه الفوضى الداخلية، التي تجسدت في التناقض بين الاستسلام واليقظة، لم تكن إلا إرهاصات لنجم راقص سيولد في انتفاضة 1991. فالأغاني الحزينة في القرى، والكتب الممنوعة في المدن، والخطابات السرية في المساجد، كلها كانت أشكالًا من التمرد الوجودي، محاولات لتجاوز العدمية التي فرضها النظام. إن هذه الحالة تعكس ما وصفه ألبير كامو بالتمرد: “أتمرد، إذًا أنا موجود.” التمرد هنا لم يكن بعدُ ثورة مسلحة، بل كان تمردًا روحيًا، إصرارًا على البحث عن المعنى في عالم يحاول إلغاء الذات الكوردية.
كذلك، فإن تصدع البنية التقليدية للعائلة الكوردية يعكس مفهوم كيركغور عن “اليأس” كحالة وجودية تنشأ عندما تفقد الذات توازنها بين المحدود واللامحدود. الأب، الذي كان رمزًا للسلطة، وجد نفسه عاجزًا عن تقديم إجابات لجيل يطالب بحرية لا تقبل التأجيل. هذا التصدع لم يكن انهيارًا، بل كان إرهاصًا لولادة جديدة، ولادة وعي جماعي يرفض القبول بالواقع المفروض. إن الهمسات السرية للأمهات، والأسئلة الجريئة للأطفال، والقصائد المكتوبة على هوامش الدفاتر، كلها كانت أفعالًا وجودية تؤكد أن الذات الكوردية، رغم القمع، لا تزال حية، تبحث عن معنى لوجودها في مواجهة العدم. وكما يقول فيكتور فرانكل: “إن من يملك سببًا ليعيش من أجله، يمكنه تحمل أي شيء.” هذا السبب، بالنسبة للكورد، كان الحلم بالحرية، الحلم الذي كان ينبض في صمت الجدران، في الأغاني الحزينة، وفي الكتب الممنوعة، ممهدًا لولادة وعي لا يمكن إخماده.
تحرير كوردستان: قوس الفرح بعد قرن من الظلم
في لحظة تاريخية لا تشبه سواها، لحظة نحتت في صميم الذاكرة الجماعية، انقشعت سُحب الذعر والخذلان التي طالما خنقت أرواحنا، وارتفعت رايات التحرير ترفرف بفخر فوق جبال وسهول كوردستان، كأنها أشرعة سفينة النجاة التي وصلت بعد رحلة محفوفة بالهواجس. المدن تتساقط من قبضة النظام الوحشي واحدة تلو الأخرى، كأنها تخلع عن نفسها عباءة الموت السوداء التي طالما أثقلتها، وتُلقيها بعيداً. كركوك، قدس كوردستان، تلك المدينة التي طالما حلم بها الكورد كحلم مقدس، تتحرر أخيرًا، وتتنفس هواء الانعتاق الحر لأول مرة منذ عقود. من زاخو إلى خانقين، من السليمانية إلى دهوك، من أربيل إلى رانية، يعود الوطن من ليل الغياب الطويل، ويستفيق الكورد على يوم لم يحلموا أن يعيشوه يقظةً، يوماً كتبوه بدمائهم، وعمدوه بالصمود، إنه تجسيد لـ”الولادة العظمى” للوطن.
إنها لحظة الفرح الأكبر منذ قرن كامل من الظلم والقهر؛ لحظة لم يصنعها اتفاق دولي مخادع ولا صفقة سِرّية خلف الستار، بل صيحات الناس الصادقة، أقدام الفقراء العارية التي وطأت أرض الحرية، وأحلام الذين ولدوا في المنافي القاسية والمعتقلات المظلمة والمقابر الجماعية المجهولة. الحرية لم تهبط من السماء كهدية، بل انتُزعت من بين أنياب الوحش الذي افترس حياتنا، بخوف الأمهات الذي تحول إلى قوة لا تُقهر، ودموع الجياع التي أصبحت أنهاراً من العزم، وعزم الشباب الذي لم يرضخوا للسجن ولا المنفى ولا النفي من الحياة، وكأنهم يعيدون تعريف “الوجود” من خلال فعل التحرر ذاته، في “ولادة رابعة” لإرادة شعبية لا تقهر.
في الساحات العامة، تزاحمت الأجساد بفرح لا يُوصف، فرح لم تتسع له الأرض، هتافات تعبر عن مئة عام من الألم المكبوت، تخرج دفعة واحدة كقنبلة ضوئية في ليلٍ قاتم، تنير الأفق. العجائز الذين عاشوا مذبحة “سيميل” و”حلبجة” الكيميائية، يبتسمون لأول مرة ابتسامة حقيقية، كأنهم يرون الوطن يزهر من تحت التراب، ينهض من رماده كطائر الفينيق. الأطفال يركضون بين جدران كانت بالأمس معتقلات مظلمة، واليوم صارت مدارس تفتح أبوابها للحياة والأمل. الشوارع امتلأت بقرع الطبول الحماسي، بزغاريد النساء التي تملأ الفضاء، وبتكبيرات الرجال الذين طالما قُهرت حناجرهم ومنعوا من التعبير، وكأنها لحظة “الولادة الوجودية” التي انتظروها طويلاً، لحظة تتجلى فيها ماهية هذا الشعب.
كوردستان كانت ولّادة للغصة، للأسى، وللموت، والآن صارت تولد من رحمها ثانيةً، ولكن هذه المرة من دون قيد، من دون خوف، ولو للحظة واحدة، مؤكدة على قدرة الروح على التجدد. حتى الهواء صار أخف، حتى الأرض تنفست الصعداء. شعر الناس بأنهم ليسوا مجرد ضيوف على ترابهم، بل أصحاب الحق الحقيقيون في هذه الأرض. امتلأت البيوت بأحاديث الحلم الذي طالما راودنا: سنزرع أرضنا مجدداً، سنبني جامعاتنا الخاصة، سنُعيد منفيينا إلى أحضان الوطن، سنكتب دستورنا بلغتنا الكوردية الأم، وسنُطلق أسماء شهدائنا الأبطال على الأزقة التي كانت تُسمّى بأسماء جلادينا.
هذا الوطن الذي طالما كُتبت خريطته بالدم، يُعاد رسمه بالحب والأمل والعزيمة. لا سجون، لا استخبارات تتربص بنا، لا بعث يطاردنا، لا رجال أمن يطاردون فكرة أو حلماً. لأول مرة، لم يكن هناك فرق بين الكوردي العامل في الحقل، أو الطالب في المدرسة، أو البيشمركة في الجبل. كلهم كانوا أحراراً، وكلهم شعروا أن شيئًا عميقًا تغير في جوهر وجودهم. عادت الحياة، ليس بمعناها البيولوجي فقط، بل بمعناها الكوردي، بمعناها الإنساني العميق. عادت الأغاني المحرّمة، واللغة التي كانت تُقصّ ألسنتها صارت تُدرّس في المدارس. ارتدت الأمهات ثياب الحصاد لا الحداد، وتوقف الوقت في كوردستان للحظة أبدية: لحظة شعور جمعي لم تعرفه هذه الأرض منذ سايكس-بيكو. هنا، يتردد صدى كلمات الشاعر العظيم محمود درويش: “نحن نكتب حياتنا كما نكتب أرضنا”، فهل هذه الكتابة الدموية، هذه الملحمة من الصراع والمعاناة، هي التجسيد الأسمى للوجود والحرية، أم أنها قصيدة لم تُنتهَ بعد، تنتظر منا أن نخط آخر أبياتها بحبر الأمل الذي لا يجف، مؤكدين على أن كل نهاية هي بداية لولادة جديدة؟
لحظة تحرير كوردستان، كما وصفتها، ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي تجسيد لما أسماه سارتر “الحرية الوجودية”، تلك الحرية التي لا تُمنح بل تُنتزع من خلال الفعل الواعي. الكورد، في هذه اللحظة، لم ينتظروا موافقة العالم أو هبة من السماء، بل اختاروا أن يكونوا فاعلين في تاريخهم، مؤكدين أن الوجود لا يكتمل إلا عبر الفعل الحر. كما يقول سارتر: “الإنسان محكوم عليه بالحرية”، وهذه الحرية تتطلب مواجهة العبثية، مواجهة عالم لا يقدم ضمانات، بل يترك الإنسان وحيدًا أمام مسؤوليته في صياغة مصيره. إن انتزاع الحرية من أنياب النظام الوحشي كان بمثابة إعلان وجودي: الكورد ليسوا مجرد ضحايا للتاريخ، بل هم صانعوه.
هذه اللحظة تعكس أيضًا مفهوم نيتشه عن “إرادة القوة”، ليس كسلطة على الآخرين، بل كتجاوز للذات، كقدرة على تحويل الألم إلى قوة خلاقة. دموع الجياع التي أصبحت أنهارًا من العزم، وخوف الأمهات الذي تحول إلى قوة لا تُقهر، هي تجسيد لهذه الإرادة. الكورد، في هذه اللحظة، لم يقاوموا فقط نظامًا سياسيًا، بل قاوموا العدمية التي تحاول إلغاء وجودهم، مؤكدين أن الحياة لا تكتسب معناها إلا من خلال الصراع من أجل الحرية. كما يقول كامو: “في مواجهة العبث، التمرد هو السبيل الوحيد لإعطاء الحياة معنى.” الفرح الذي ملأ الساحات، والأغاني التي عادت إلى الشوارع، واللغة التي أُعيدت إلى المدارس، كلها كانت أفعال تمرد وجودي، تأكيد على أن الوجود الكوردي ليس مجرد بقاء بيولوجي، بل هو إصرار على الحياة بمعناها الأعمق.
أما توقف الزمن في تلك اللحظة الأبدية، فهو يذكرنا بمفهوم هايدغر عن “الكينونة في الزمن”. الزمن، في هذا السياق، لم يكن مجرد تسلسل خطي للأحداث، بل كان لحظة تجلي حيث تتجمع الماضي (مذبحة سيميل وحلبجة)، والحاضر (الانتفاضة)، والمستقبل (حلم الدستور والجامعات)، في نقطة واحدة من الوعي الجمعي. هذه اللحظة لم تكن نهاية، بل كانت بداية لولادة جديدة، كما يصفها درويش، حيث تُكتب الحياة كما تُكتب الأرض. إن هذه الكتابة الدموية ليست مجرد سجل للمعاناة، بل هي إعلان ميتافيزيقي عن خلود الروح الكوردية، روح ترفض أن تُمحى من الوجود، وتجد في كل ألم بذرة لتجدد لا نهائي.
الفجر الدامي: كوردستان تستعيد روحها
يُقال إن كل فجرٍ يحمل في طياته شمسًا لا يعرفها الليل، وإن الأمل يولد من رحم اليأس ذاته. فهل كانت تلك اللحظة التي سبقت فجر الخامس من آذار 1991 مجرد انتظار؟ أم كانت صمتًا كونيًا يتأهب لصرخة وجودية تهز أركان الزمان؟ وكما قال ألبير كامو: “في عمق الشتاء وجدتُ أن في داخلي صيفًا لا يُقهر”. هكذا استيقظنا على موسيقى النار، لا موسيقى تُعزف على آلات، بل على أرواحنا المشتعلة، على قلوبنا التي كانت ترتجف فرحًا وترقبًا. لا أحد دعا إلى الثورة في وضح النهار، لكنها كانت تعرف موعدها، كأن التاريخ قرر فجأة أن يكتب نفسه بلغة جديدة، بلغة الفقراء والمقموعين، بلغة من طحنهم الصمت عقودًا من الزمن. الأزقة الكوردية تنفست بثورة، ورأيتُ جدران البيوت، التي كانت شاهدة على الكثير من الخوف والهمس، ترتجف كأنها تصلي، تهتز طربًا أو رعبًا من هذا التحول العظيم. الناس لم يعودوا أفرادًا متفرقين، كل في زاوية خوفه، بل تحولوا إلى موجٍ صاعدٍ لا يتوقف، حناجر تردد نفس النداء وإن اختلفت اللهجات من قرية لأخرى، من حارة لأخرى: “كفى! كفى الظلم! كفى الصمت!”.
النساء، أولئك اللواتي كن يحملن عبء الوطن على أكتافهن في صمت، خرجن ووجوههن تلمع بدموع الكبرياء، لا بدموع الحزن. كنّ يحملن صور من رحلوا غدرًا، وأسماء من لا يزالون في المجهول، كأنهن يطرزن الذاكرة في الهواء، ينسجن قصص الفقد على قماشة الحرية. من أربيل إلى كركوك، ومن دهوك إلى مدينتي شقلاوة التي كانت تنام طويلًا تحت وطأة الكبت والقمع، رأيت كوردستان كلها تصحو كعذراء تستعيد جسدها بعد سبات إجباري طويل. في كل زاوية، وفي كل مدينة كوردية، كان كل حجر يهتف، وكل نافذة تفتح على قصيدة لم تُكتب بعد، وكل شجرة زيتون تهمس بقصة صمود، وكأن الطبيعة نفسها تشارك في “الولادة الثالثة” لهذه الأرض. الشباب الذين كانوا يُعتقلون بالأمس بتهمة الحلم، مجرد الحلم بوطن حر، صاروا اليوم يقودون الزحف المقدس نحو مراكز الأمن، نحو الجدران التي كانت تُخفي العتمة والقمع. كان الهواء يمتلئ برائحة البارود ممزوجة برائحة التراب الرطب والأمل، رائحة لم أشمها منذ ولدت، رائحة ميلاد جديد.
تحسين النقشبندي، الرائد البعثي الذي كان يسكن وجوهنا كرعب قديم، كابوس يومي لا مفر منه، صار اسمه يُطارد في كل زقاق، يُبصق عليه في الأزقة وكأنه رمز للخيانة والانكسار. مشينا لا نملك شيئًا سوى الغضب المتراكم، الغضب الذي تحول إلى قوة دافعة، لكنه كان كافيًا لتغيير مجرى التاريخ. أسقطنا الصنم، لا بأيدينا فقط، بل بأرواحنا التي احترقت كشموع أبدية في ليلٍ طويل مظلم. كأننا نُعيد تعريف الزمن نفسه: قبل الانتفاضة وبعدها. كأن الجدران التي كانت تسجننا لم تعد تلك الجدران، بل بدأت تتهاوى تحت وقع الخطى الثائرة، لا تحت وقع القذائف، في فعل وجودي للتخلص من الأغلال المادية والروحية.
رأيت أحد رفاقي، وجهه الشاحب محفورٌ فيه الألم، يبكي وهو يُحطم صورة للطاغية المعلقة على جدار مركز الأمن. اقتربت منه، وكنتُ أظنها دموع حزن على السنوات الضائعة، فقلت له: “تبكي؟ بعد كل هذا النصر؟” أجابني بصوت مخنوق بالوجع والفرح، لكن عينيه كانتا تلمعان بضوء غريب، ضوء كوني: “هذه دموع ولادة يا صديقي، لا دموع حزن! أتفهم؟ إنها دموع الوعي المنبثق من العدم، من سنوات الظلام التي قضيناها في دهاليز الخوف واليأس. هل هذا الألم الذي عشناه، كل هذه السنوات من القهر، كان مجرد بذرة لنورٍ كهذا؟ هل كان يجب علينا أن نمر بكل هذا الجحيم لنصل إلى هذه اللحظة من التجلي؟” فهمت حينها أن الحرية لا تأتي على صهوة شعار سياسي أو وعد كاذب، بل على هيئة دمعة تُسقط جدارًا من الخوف المزمن، دمعة تكسر حاجز اللاوعي الجماعي الذي فُرض علينا. الناس لم يعودوا خائفين من الموت، فقد ذاقوا مرارة العيش في موتٍ مستمر، بل صاروا خائفين من الفشل في اغتنام هذه اللحظة التي تأخرت طويلًا، وكأنها لحظة اختيار وجودي بين العدم والبقاء. حتى السماء، تلك الليلة، كانت تمطر نجومًا لا مطرًا، كأنها تحتفل بنا، تشهد على تحرر النفوس من قيدها الميتافيزيقي الذي فرضه الطغاة.
الانتفاضة، في حقيقتها العميقة، لم تكن فقط لحظة سياسية عابرة. كانت طقسًا وجوديًا، عبورًا جماعيًا من العدم إلى المعنى، من حالة اللاوجود إلى قسوة الوعي بالذات. ولدتُ مرة ثالثة: الأولى من رحم أمي، إلى هذا العالم الفاني، وهي ولادة جسدية. الثانية من رحم السجن، حيث تجلى لي معنى الحدود بين الجسد المادي والروح الأبدية، وحيث أدركت أن الحرية هي حالة ذهنية لا مكانية، وهي ولادة وعي بالذات. والثالثة من رحم الانتفاضة، حيث انصهر الفرد في الوعي الجمعي، متسائلًا: هل هذه الولادة المتجددة هي تجسيد للروح الأزلية للشعب التي تأبى الفناء، روح تتجدد كلما حاولت قوى الظلام سحقها، كفراشة تخرج من شرنقة العدم، باحثة عن فضاء تتجلى فيه حقيقة الوجود؟ هذه الولادات المتتالية أكدت لي أن الوجود ليس حالة ثابتة، بل هو سلسلة من التحولات، سلسلة من الموت والبعث، وكلما ظننا أننا وصلنا إلى النهاية، تبرز روحنا من جديد، أقوى وأكثر وعياً بحدودها اللانهائية.
إن هذا الفجر الدامي، بكل ما حمله من تناقض بين الأمل والألم، يعكس مفهوم كيركغور عن “قفزة الإيمان”، تلك اللحظة التي يتجاوز فيها الإنسان حدود الخوف واليأس ليؤكد وجوده من خلال فعل الإيمان بالمعنى الأعلى. الكورد، في هذه اللحظة، لم يقفزوا فقط نحو الحرية السياسية، بل قفزوا نحو تأكيد وجودهم كشعب لا يمكن محوه من خريطة الوجود. هذه القفزة لم تكن خالية من الدماء، بل كانت مشبعة بالتضحيات، كما لو أن كل قطرة دم كانت توقيعًا على وثيقة الوجود الأبدي. يقول كيركغور إن الإيمان يتطلب مواجهة اليأس، وهذا اليأس تجسد في سنوات القمع التي سبقت الانتفاضة، حيث كان الكورد يعيشون في حالة من “المرض حتى الموت”، ليس موتًا جسديًا، بل موتًا روحيًا يفرضه الصمت والخوف.
لكن هذا الفجر كان أيضًا تجسيدًا لفكرة كامو عن “الإنسان المتمرد”. التمرد هنا لم يكن مجرد رفض للنظام السياسي، بل كان رفضًا للعدمية التي تحاول إلغاء الذات الكوردية. النساء اللواتي خرجن بدموع الكبرياء، والشباب الذين قادوا الزحف المقدس، والجدران التي هتفت مع الثوار، كلها كانت أفعال تمرد وجودي، تأكيد على أن الحياة تستحق أن تُعاش فقط عندما تكون حرة. كما يقول كامو: “التمرد يخلق القيمة”، وهذه القيمة تجسدت في إعادة تعريف الزمن نفسه: قبل الانتفاضة وبعدها، كما لو أن الكورد أعادوا كتابة التاريخ ليس فقط كسرد سياسي، بل كسرد ميتافيزيقي يؤكد أن الوجود لا يكتمل إلا من خلال الصراع ضد العدم.
إن دموع الرفيق التي وصفتها ليست مجرد دموع فرح أو حزن، بل هي، كما يصفها هايدغر، تجربة “الدهشة” الأنطولوجية، تلك اللحظة التي يدرك فيها الإنسان عمق وجوده في مواجهة العالم. هذه الدموع كانت تعبيرًا عن وعي جديد، وعي يدرك أن الألم ليس نهاية، بل هو بداية لتجلي جديد. إنها دموع “الولادة الثالثة”، ولادة الوعي الذي يرفض أن يكون ضحية، ويختار أن يكون فاعلاً في مصيره، مؤكدًا أن الوجود الكوردي ليس مجرد رد فعل على الظلم، بل هو فعل إبداعي يعيد صياغة المعنى في عالم يحاول إلغاءه.
صوت من أعماق الروح: البيان الإذاعي الأول للثورة
في لحظات التيه الكبرى، حين يُخيم الصمت على الأرواح وتُكمّم الأفواه، يصبح البحث عن صوتٍ، ولو كان همسة، فعلًا وجوديًا بحد ذاته. إنه فعل يتجاوز حدود الصوت ليصبح صرخة حياة ضد العدم ذاته. فهل يمكن لصوتٍ أن يولد من العدم؟ وهل تستطيع الكلمات أن تشق طريقها عبر جدران الخوف لتعلن عن فجرٍ جديد؟ وكما يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر: “اللغة هي بيت الوجود”. فقبل أن تتحقق الحرية كواقع، لا بد من إعلان الوجود ذاته عبر الكلمة، لا بد من الصرخة الأولى التي تكسر حواجز الصمت وتعلن عن ميلاد حقيقة جديدة، حقيقة لا تُمنح، بل تُنتزع وتُعلن بصوت مدوٍ، إنه ميلاد الوعي الصوتي.
بعد ساعات طويلة من الصمت المرعب الذي خنق أنفاسنا، وسط دوي الرصاص وانفجارات القنابل التي كانت تهز الأرض تحت أقدامنا، انبعث صوتٌ من راديو صغير في زاوية مخفية ببيتنا. لم يكن مجرد ترددات هوائية عابرة، بل كان نبضًا حيًا من أعماق الروح الكوردية، إعلانًا وجوديًا عن ولادةٍ جديدة تتجاوز حدود الزمن والمكان. قبل أن تبدأ الكلمات في التدفق، عزف لحنٌ مهيب، لحنٌ يعرفه كل كوردي، لحنٌ يحمل في طياته قرونًا من الألم والأمل، إنه النشيد الوطني الكوردي “ئەی رەقیب” الذي يُصدح به لأول مرة علنًا في الأثير:
ئەی رەقیب ھەر ماوە قەومی کورد زمان نایشکێنێ دانەریی تۆپی زەمان کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان
ارتفعت نغمات النشيد، وكلماته تتسلل إلى كل خلية في جسدي، ليست مجرد أبيات شعرية تُتلى، بل كانت بيانًا فلسفيًا للوجود ذاته، ترياقًا لسموم العدمية التي حاولوا حقنها فينا. “أيها الرقيب، لن يموت شعب الكورد ولغته أبداً / لن تهزمه قوة الزمان / لا يقل أحد إن الكورد ماتوا، الكورد أحياء / أحياء، ولن تسقط رايتنا أبداً.” هذه العبارة لم تكن مجرد إعلان عن الصمود، بل هي تأكيد ميتافيزيقي على خلود الروح الكوردية، وتحدٍ للزمان نفسه. كيف يمكن لزمنٍ، مهما طال، أن يمحو شعبًا يصر على البقاء؟ إنه سؤال الوجود الأعمق: هل يمكن للأمة أن تموت إذا كانت روحها حية؟ والنشيد يجيب بصوت مدوٍ يهز أركان روحي: “لا يقل أحد إن الكورد ماتوا، الكورد أحياء، أحياء، ولن تسقط رايتنا أبداً”. هذه اللازمة المتكررة هي بمثابة تأكيد وجودي مطلق، ترنيمة تتجاوز المهد لتصل إلى اللحد، لتعلن أن الحياة ليست مجرد نفس يخرج ويدخل، بل هي إرادة لا تُقهر في مواجهة العدم والفناء، وهي بمثابة “ولادة خامسة” للوعي الجمعي، ولادة تتجاوز حدود الزمن والموت.
وتابع النشيد، كل كلمة فيه تحمل ثقلًا من المعنى والذاكرة: “نحن أبناء اللون الأحمر والثورة / انظر، ماضينا ملطخ بالدماء.” اللون الأحمر هنا ليس مجرد رمز للثورة، بل هو رمز لدماء الشهداء التي روت أرض الوطن، دماء تحولت من علامة للمأساة إلى وقود للثورة، وإلى جوهر للحياة المتجددة. إنها اعتراف بالألم، لكنه ألمٌ يتحول إلى قوة دافعة، إقرار بأن التاريخ الملطخ بالدماء هو ذاته مصدر القوة للصمود، ودحض لمفهوم العبثية في المعاناة، لأن كل قطرة دم لها معنى وهدف.
ثم عززت الكلمات التالية فلسفة العمل والوجود المكتسب، متحدية السلبية: “شباب الكورد وقفوا بقدم صلبة كالأبطال / ليكتبوا بحياتهم تاج الحياة.” هنا يبرز فلسفة الوجودية الفعلية. فالحياة لا تُمنح، بل تُكتب وتُصنع بالعمل والتضحية. “الوقوف بقدم صلبة” يعني الثبات والمقاومة الفعالة، حتى لو كانت الأرض تهتز تحت الأقدام. “كتابة تاج الحياة بالحياة نفسها” تعني أن معنى الوجود وكرامته لا يأتيان إلا من خلال الفعل البطولي والتضحية، لا بالانتظار السلبي. هذا يُعطي قيمة للذات الفاعلة (شباب الكورد) التي لا تنتظر المصير، بل تصنعه بنفسها، وكأنهم يقولون لفلاسفة القدرية: “قدرنا ليس مكتوباً، بل نُنجزه بفعلنا، وهذه هي ولادة الفاعل الحقيقي.”
بعدها، جاءت الكلمات لتؤكد فلسفة الهوية الجذرية والوطن كدين، في مواجهة التفكك الذي فرضه التاريخ: “نحن أبناء ميديا وكيخسرو / ديننا وإيماننا هو الوطن.” هذا الجزء يعود بنا إلى الجذور التاريخية والأساطير القديمة، يربط الأمة بحضارتها العريقة، ويُعلي من شأن الوطن ليجعله دينًا وإيمانًا، هويةً وجودية لا يمكن التخلي عنها. الوطن هنا ليس مجرد قطعة أرض، بل هو الجوهر الروحي الذي يمنح الحياة معناها ويوحد الأفراد ضمن كيان واحد، ويتجاوز الانتماءات الضيقة. هذه الفلسفة تتحدى فكرة التفكك وتقول إن الولاء للوطن هو أعمق من أي انتماء آخر، إنه جوهر الكيان نفسه الذي تتجدد فيه الروح.
وأخيرًا، جسدت الكلمات فلسفة الفداء المطلق، كاستجابة لليأس الذي يحاول التسلل إلى النفوس: “شباب الكورد دائمًا حاضرون ومستعدون / أرواحهم فداء، فداء، دائمًا فداء.” هذه الأبيات تتحدث عن الاستعداد التام للتضحية القصوى. “فداء، فداء، دائمًا فداء” هو تكرار يشدد على الالتزام المطلق وغير المشروط. إنه يعكس الإيمان بالهدف الأسمى (الوطن والحرية) الذي يستحق بذل الروح. هذه الفلسفة تحارب اليأس بإبراز قوة الإرادة الجماعية والفردية التي لا ترى في الموت نهاية، بل تحولًا إلى رمز للحياة المتجددة، وإلى بذرة تُثمر حرية أبدية، وكأنها تجيب على سؤال العبثية: “لا معنى للعبث إن كان هناك من يفدي نفسه من أجل معنى أكبر“.
بمجرد أن تلاشى لحن النشيد، صدح صوتٌ مألوف، صوت البيشمركة الذي نعرفه جيدًا، صوتٌ كان بالأمس لا يجرؤ على الهمس إلا في الظلام الدامس، يصدح الآن بقوة عبر الأثير، متحديًا كل أشكال القمع والترهيب: “يا جماهير شعب كوردستان الأبيّ… يا أبناء وبنات كوردستان، يا أحفاد الميديين والكاردوخيين، يا أبناء جبال زاكروس وآكري وأرارات وسفين وهلكورد، يا حفدة كاوا الحداد في أرض ميزو، يا أبناء شيخ سعيد بيران في ديار بكر، يا أتباع قلندر في أغري! ها قد آن الأوان لنكسر قيود الظلم والاستبداد، لنقاوم التمييز العنصري الذي لطالما أذلنا وفتك بوجودنا.”
لم تكن الكلمات مجرد أحرف تُنطق، بل كانت سحرًا يوقظ الروح من سباتها العميق، تُعيد تعريف معنى الوجود نفسه في لحظة تجلٍّ لا تُنسى. كل جملة كانت كالنار التي تُشعل في قلوبنا جمرة الأمل، وكأنّ إذاعة الراديو المهترئة تلك، التي كانت تهمس لنا الأخبار بحذر دائم خوفًا من عيون النظام، قد تحولت فجأة إلى منبرٍ كوني، تعلن من خلاله الثورة عن ميلادها الجديد، وتُبث منه رسالة شعبٍ أَبَى أن يموت. كنا نتبادل النظرات، أنا وأهلي، وقلوبنا ترتجف فرحًا لا يُوصف، دموعنا تختلط بالابتسامات والقهقهات الحرة، كأننا نصحو من كابوس طويل الأمد، نُدرك فجأة أن الحلم لم يكن بعيدًا إلى هذا الحد، وأنه بات حقيقة تتجلى أمام أعيننا. كانت تلك الكلمات بمثابة “بيان رقم واحد” لوجودنا الميتافيزيقي، إعلانًا لا عن ثورة سياسية فحسب، بل عن تجلي وجودٍ كامل، عن روحٍ أبت أن تموت، وصوتٍ رفض أن يُكمم. كانت تلك هي اللحظة التي شعرت فيها بأن الوجود لم يعد عبئًا ثقيلًا على كاهلي، بل تحديًا وواجبًا مقدسًا، لحظةً أيقنت فيها أننا لسنا مجرد ضحايا للقدر المحتوم، بل صانعيه بدمائنا وعزيمتنا التي لا تلين.
البيان لم يتوقف عند حدود الماضي، بل رسم خريطة لمستقبلٍ يجب أن يُصنع بالدم والعرق. “من جبال هولير إلى سهول كركوك، من شوارع أربيل إلى أزقة دهوك، ندعوكم للنهوض كالأنهار المتدفقة، كالنسائم التي تحمل أنفاس الشهداء.” كان هذا النداء كدعوة كونية، دعوة من الأرض إلى أبنائها، دعوة من الجبال الشامخة إلى أبناء الجبال، من الأودية العميقة إلى الأرواح التي طالما ارتبطت بها، دعوة للنهوض من غياهب الصمت والخوف الذي خنق أنفاسنا لعقود طويلة. إنه استحضار للقوة الكامنة في الطبيعة الكوردية ذاتها، في الأنهار التي لا تتوقف عن الجريان، وفي النسائم التي تحمل عبير الحرية، وكأنها تقول: “استمدوا قوتكم من الأرض التي أنجبتكم، ومن التاريخ الذي شهد على صمودكم، فأنتم امتداد وجودي لهذه الأرض، وهذا هو سر ولادتكم المتجددة.”
“أيها الأحرار، صوت الشهداء يناديكم لمعركة الشرف والكرامة والإنسانية والوجود! اليوم، نرفع السلاح ضد النظام الدكتاتوري، الطاغية الذي سفك دماء أبنائنا في حلبجة في كارثة لا تُغتفر، حيث أودت الغازات السامة بحياة الأبرياء، وحول الأنفال إلى جحيم المقابر الجماعية التي ابتلعت أرواح أكثر من 180,000 مواطن كوردي بريء. دمر 4500 قرية كوردية، تركها أطلالًا تبكي تحت الرماد، وتعامل مع حقوق شعبنا بالنار والحديد، بالرصاص الذي أجهز على الحياة، والإعدامات التي صنعت من جبالنا شاهدًا على العذاب.” كل كلمة في هذا الجزء كانت كطعنة في ذاكرة الألم، تذكيرًا بالوحشية التي لا يمكن نسيانها، تذكيرًا بالجرائم التي تتطلب الثأر لا الانتقام، بل الثأر لوجودنا المهدد. كان ذكر حلبجة والأنفال ليس مجرد استعراض للألم، بل كان مبررًا فلسفيًا للثورة، دليلًا على أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن الحياة تحت هذا النظام كانت موتًا بطيئًا. “هذا النظام، بقسوته كالصحراء المحرقة، حول كوردستان إلى سجن مفتوح، جعل من أطفالنا أشباحًا ومن نسائنا أمهات الحزن.” صورة الصحراء المحرقة، السجن المفتوح، الأطفال الأشباح، ونساء الحزن—كلها صور قوية ومؤثرة، ترسم لوحة لمأساة إنسانية عميقة، تدفع السامع إلى الانضمام إلى الثورة، لا كخيار، بل كواجب مقدس لإنقاذ الوجود ذاته.
“يا أحرار كوردستان، لتكن أيدينا أقلامًا تكتب الحرية، ولتكن خطواتكم أناشيد تدوي في الوديان. الجبال تناديكم، والأرض ترجوكم، فهيّا نطرد الظلام، نزرع الأمل، ونبني فجرًا جديدًا في أربيل وكركوك. من صوتنا هذا، من إذاعة الشعب، نعلن الانتفاضة: لن يكون هناك استسلام، لن يكون هناك صمت، حتى تعود كوردستان إلى أحضان أبنائها الأحرار!” هذا النداء الختامي كان أقوى ما في البيان، يجمع بين الرمزية والعملية. فالأيدي التي تُصبح أقلامًا تكتب الحرية، والخطوات التي تتحول إلى أناشيد، كلها تعبيرات عن تحول الوجود نفسه إلى فعل مقاومة. “لن يكون هناك استسلام، لن يكون هناك صمت، حتى تعود كوردستان إلى أحضان أبنائها الأحرار!” كانت هذه الكلمات ليست مجرد وعد، بل عهدًا مقدسًا بين الشعب وذاكرته، وبين الأجداد والأحفاد، عهدًا يُكتب بالدم ويُروى بالأمل، مؤكداً على الولادة الأبدية لروح المقاومة.
بمجرد أن تلاشى صوت المذيع تدريجيًا، ليترك مكانه دوي معارك بدأت في الأفق، مختلطًا بصوت المطرب الكوردي شيفان بيروار يصدح بأغنية “واهاتن بيشمركة مة” – “لقد جاءوا أبطالنا البيشمركة” – شعرتُ أن الأرض نفسها تغني لروح المقاومة. الأغنية لم تكن مجرد لحن، بل كانت روحًا تتجسد، دماءً تجري في العروق، إيذانًا ببدء فصل جديد من المقاومة الأبدية، وفصل جديد في سيرة هذه الأمة التي تأبى الفناء.
هل هذه هي حقيقة الوجود، أن تُولد الحرية من رحم المجهول، وأن يُصبح الصوت المقموع هو أول قيثارة تُعزف لحن النصر؟ هل كان هذا البيان الإذاعي، بنشيده الذي يعلو فوق كل صوت، مجرد إعلان سياسي، أم هو شهادة ميتافيزيقية على أن الروح الإنسانية، حين تُدفن تحت ركام القمع، تظل تنبض، وتصنع لنفسها ألف طريق وطريق لترى النور، كأنها تقول للعالم: “حتى في الصمت، أنا موجود، وسأصرخ حتى يسمعني الكون كله”؟ كان هذا الصوت، لحظتها، هو صوت وجودي يتجاوز الحدود، صوتًا يُعيد تعريف ماهية الحياة ذاتها، ويُعلن أن الصمود ليس مجرد خيار، بل هو جوهر البقاء في وجه العدم. هذا البيان، بهذه القوة، لم يترك مجالًا للشك بأن هذا الشعب، حتى بعد كل ما مرّ به من ظلم، لن يرضى بأقل من الوجود الكامل والحرية المطلقة. إنه تأكيد على أن الولادة المتجددة هي عملية مستمرة، كلما ظن العدم أنه انتصر، ولد الوجود من رحم الصرخة.
النص الكوردي للنشيد “ئەی رەقیب”:
ئەی رەقیب ھەر ماوە قەومی کورد زمان
نایشکێنێ دانەریی تۆپی زەمان
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان
ئێمە ڕۆڵەی ڕەنگی سوور و شۆڕشین
سەیری کە خوێناوییە ڕابردوومان
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان
لاوی کورد ھەستایە سەر پێ وەک دلێر
تا بە خوێن نەخشی بکا تاجی ژیان
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان
ئێمە رۆڵەی میدیا و کەیخوسرەوین
دینمان، ئایینمان ھەر نیشتمان
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان
لاوی کورد ھەر حازر و ئامادەیە
گیان فیدایە، گیان فیدا، ھەر گیان فیدا
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئاڵاکەمان
بإن البيان الإذاعي الأول، مع نشيد “ئەی رەقیب”، يمثل تجسيدًا لما أسماه هايدغر “اللغة كبيت الوجود”. اللغة هنا لم تكن مجرد وسيلة للتواصل، بل كانت فعلًا أنطولوجيًا يؤكد وجود شعب بأكمله. النشيد، بكلماته التي تتحدى الزمن والعدم، هو ترنيمة وجودية تعلن أن الكورد ليسوا مجرد كيان تاريخي، بل هم كينونة حية ترفض الفناء. كل لازمة في النشيد، “کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە”، هي تأكيد ميتافيزيقي على خلود الروح الجماعية، كما لو أن الكورد يقاومون ليس فقط النظام السياسي، بل العدم ذاته، ذلك العدم الذي حاول محوهم من الوجود عبر القمع والإبادة.
هذا الصوت، الذي انبعث من راديو صغير، يعكس مفهوم سارتر عن “الفعل الحر” كجوهر الحرية. الكورد، في هذه اللحظة، اختاروا أن يكونوا أحرارًا من خلال إعلان وجودهم عبر الكلمة، متحدين بذلك الصمت الذي فرضته سنوات القمع. كما يقول سارتر: “الحرية ليست شيئًا يُمنح، بل شيء يُمارس.” هذا التمرين للحرية تجسد في الصوت الذي كسر جدران الخوف، في الكلمات التي تحولت إلى أسلحة مقاومة. إن ذكر حلبجة والأنفال في البيان لم يكن مجرد سرد للألم، بل كان، كما يصف فرانكل، محاولة لإيجاد المعنى في المعاناة. المعاناة هنا ليست عبثية، بل هي الوقود الذي أشعل الثورة، الدليل على أن الوجود الكوردي لا يمكن إلغاؤه، لأن كل قطرة دم وكل قرية مدمرة هي شهادة على إرادة الحياة.
إن دعوة البيان للنهوض “كالأنهار المتدفقة” و”النسائم التي تحمل أنفاس الشهداء” هي تعبير ميتافيزيقي عن ارتباط الكورد بالطبيعة كجزء من كينونتهم. هذا الارتباط يذكرنا بفلسفة هايدغر عن “الكينونة في العالم”، حيث الإنسان ليس منفصلاً عن بيئته، بل هو جزء من نسيجها الوجودي. الجبال والأنهار الكوردية ليست مجرد خلفية جغرافية، بل هي شريكة في الصراع، شاهدة على التضحيات، وحاملة لروح الشهداء. هذا البيان، إذن، لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل كان طقسًا وجوديًا، تجليًا لروح شعب يرفض أن يكون مجرد ظل في التاريخ، مؤكدًا أن الوجود هو صرخة مستمرة ضد العدم، صرخة تتجدد في كل لحظة مقاومة.
لهيب الانتفاضة: قتال البيشمركة وفلسفة المقاومة
هل يُمكن للضعف أن يولد قوة؟ وهل الألم المتراكم يُصبح وقودًا لثورةٍ لا تلين؟ ربما تكمن الإجابة في تلك اللحظة التي تُدرك فيها الروح أنها لا تملك شيئًا لتخسره سوى قيودها، وأن الوجود ليس إلا صراعاً أبدياً بين النور والظلام، بين العدم الذي يتربص بالروح والوعي الذي يرفض الاستسلام. وكما قال نيتشه، الفيلسوف الذي آمن بقوة الإرادة: “ما لا يقتلني يجعلني أقوى”، هذه المقولة لم تكن مجرد حكمة، بل كانت تجليًا لحقيقة وجودية عشناها بدمائنا. حينما حملت السلاح في يدي، لم تكن يدي ترتجف من الخوف، بل من الحماس المتقد، من لهيب الغضب الذي سرى في عروقي، وكأنها ولادة رابعة للذات، ولادة من رحم الغضب المقدس. وقفت إلى جانب إخواني البيشمركة الشباب، الذين كانوا يواجهون الموت بصدور عارية، كدرع حي لكوردستان، تلك الأرض التي لم نكن نعرف سوى اسمها وحنينها. كانت الانتفاضة شرارة أمل لم نتجرأ على الحلم بها، فجرًا ينبثق من بين رماد الظلم الذي خلفه النظام البائد. غنينا أناشيد الحرية، تلك التي كانت محرمة، وسط دوي الرصاص الذي كان يعزف لحنًا مختلفًا هذه المرة، لحنًا للثورة لا للقمع. وكنت أرى وجوه إخواني مضيئة بالإيمان المطلق بقضيتنا، وكأن كل رصاصة تُطلق، وكل قطرة دم تُسفح، تنحت اسم قريتنا في صدر العدو، وتُرسخ وجودنا على هذه الأرض، مؤكدة على أن الحياة لا تكتمل إلا بالصراع من أجل المعنى، وأن “الولادة المتجددة” تكمن في فعل المقاومة ذاته. الجبال، تلك الحكيمات الصامتات، الشاهدات الأبديات على تاريخنا الطويل من النضال، شهدت تصدينا لجيش النظام البائد في معارك دامية، حيث رقصت الرصاصات كشياطين حقيقية على صدورنا، وانبعثت أنفاس الشهداء كغيوم بيضاء تحمل أرواحهم إلى السماء، تروي حكاياتهم للنجوم. كل طلقة كانت بيتًا في قصيدة المقاومة الخالدة، وكل خطوة تقدمنا بها كانت حفرًا لاسم كوردستان في التراب، بالدم والعرق والأمل الذي لا يموت.
في شقلاوة، حيث كانت البساتين الخضراء تترنح تحت وطأة القصف العشوائي، سقط أهلنا الأبرياء كأوراق نارية تذبل قبل أوانها، تحترق في لهيب لم يختاروه. تذكرت وجوه الأطفال الذين كانوا يلعبون بسعادة في الأزقة قبل أيام قليلة، كيف تحولت ضحكاتهم إلى أنات وأصواتهم إلى صدى في الريح. كل دمعة سالت كانت صرخة مدوية لا يُسمع صداها، وكل جثة سقطت كانت دليلاً لا يقبل الشك على الحياة التي نرفض أن نفقدها، على الوجود الذي نتمسك به. كنا فرحين، نعم، فرحين بظهور فجر جديد، فجر طال انتظاره لقرون. الشوارع غنّت بالثوار، والأطفال رقصوا رقصات الحرية، والرجال رفعوا أسلحتهم المتواضعة كأقلام تكتب تاريخًا جديدًا، تاريخًا خالياً من الخوف. لكن الفرحة كانت كزهرة برية جميلة تنبت في وسط الحقول، سرعان ما تُسحق تحت أقدام الدبابات. طاردنا الجيش من مدننا وقرانا، وحول أرضنا الخضراء إلى أتون جحيم لا يرحم. السلاح لم يكن مجرد حديد أصم، بل قلم نكتب به مقاومة وجودية، لكن الدماء التي سالت بغزارة على تراب شقلاوة، وأنين الأمهات اللواتي شيّعن أبناءهن في صمت دامٍ، كانت تذكيرًا مؤلمًا بأن الفجر الحقيقي يولد دائمًا من رماد الألم، وأن الحرية لها ثمن باهظ، ثمن يعمّق الوعي بالذات وبالوجود.
في عالم حيث تُقاس الحرية بمعاناة الشعوب، وحيث تُباع الأوطان في مزادات المصالح، لا تأتي الحرية كهدية سماوية تُمنح بلا ثمن، بل تُنتزع بثمن غالٍ من الدم والدموع والأرواح. يقول الزعيم الثوري نيلسون مانديلا: “الحرية ليست هبة تُمنح، بل حق يُنتزع بالتضحيات والصمود.” ويؤكد الثائر الأبدي إرنستو تشي جيفارا: “الثورة ليست تفصيلاً صغيرًا في حياة الشعب، بل هي حدث يغير مسار التاريخ، يقلب كل الموازين.” هكذا كانت انتفاضة شعب كوردستان عام 1991، ليست فقط ثورة على الظلم السياسي والاقتصادي، بل تجسيدًا حيًا لحق الشعوب المغلوبة على أمرها في الوجود والكرامة الإنسانية، بعد قرون طويلة من الاضطهاد المنهجي، وخصوصاً منذ “اتفاقية سايكس بيكو” المشؤومة التي قسمت الوطن وأفرغته من حلم الحرية، وحولته إلى حقل معارك يتقاذف فيه الكبار شعوباً صغيرة كأدوات على رقعة الشطرنج العالمية. كان هذا الفصل من تاريخنا لحظة صرخة وجود مدوية، محاولة لاستعادة الإرادة الذاتية بين ركام الألم والخراب، لحظة تجمع فيها النضال والمقاومة في جوهر واحد، اللحظة التي يحين فيها اللقاء الأبدي بين الإنسان وقضيته الوجودية، وكأنها “ولادة خامسة” للوطن من رحم الموت. هذه الانتفاضة، بكل مرارتها وألمها، هي تأكيد على أن الحرية ليست حالة تعطى، بل فعل يستدعي الشجاعة المطلقة، والإرادة الصارمة في اللحظة نفسها التي يعاني فيها الإنسان أشد أنواع العذاب. الحرية هنا ليست مجرد حلم بعيد المنال، بل واقع يجب أن يُصنع بالدم والدموع والعزيمة التي لا تلين. هنا يثور سؤال وجودي عميق، سؤال يطرق أبواب الوعي واللاوعي: كيف يستمر شعب في الوجود حين يُحرم من حقوقه الأساسية كالبشر؟ كيف تكون هناك حياة حقيقية، حياة ذات معنى، بدون حرية؟ الانتفاضة كانت الإجابة الحية على هذا السؤال، كانت فعل وجود جماعي يتحدى الظلم، ويعلن بصوت مدوٍ يهز أركان الكون: “نحن هنا، لن نختفِ.” هذا الإعلان لم يكن مجرد شعار سياسي، بل كان إقرارًا بوجود ميتافيزيقي يتجاوز الحدود المرسومة بالدبابات والأسلاك الشائكة، إقرارًا بأن الروح الكوردية لا يمكن قهرها، وأنها ستبقى ترفرف فوق الجبال كنسرٍ لا يرى في القيد إلا سبيلاً للارتفاع نحو سماء الوجود.
إن قتال البيشمركة، كما وصفته، يتجاوز حدود المعركة العسكرية ليصبح تجسيدًا لفلسفة المقاومة الوجودية. يقول نيتشه: “ما لا يقتلني يجعلني أقوى”، وهذه العبارة تجد صداها في إرادة البيشمركة الذين حولوا ضعفهم المادي إلى قوة روحية لا تُقهر. هذه القوة لم تكن مستمدة من الأسلحة المتطورة أو الدعم الدولي، بل من إيمانهم بأن الوجود الكوردي لا يكتمل إلا من خلال الصراع ضد العدم. هذا الصراع يعكس مفهوم سارتر عن “الوجود يسبق الماهية”، حيث الكورد، من خلال أفعالهم المقاومة، يعيدون صياغة ماهيتهم كشعب حر، لا كضحايا للتاريخ. كل رصاصة أطلقها البيشمركة كانت فعلًا وجوديًا، تأكيدًا على أن الحرية ليست شيئًا يُمنح، بل شيء يُصنع بالدم والعرق.
كلام الشاب البيشمركة عن الحياة بلا كرامة كالموت الحقيقي يعكس مفهوم كامو عن “التمرد” كجوهر الحياة. التمرد هنا ليس مجرد رفض للقمع السياسي، بل هو رفض للعدمية التي تحاول إقناع الإنسان بأن وجوده لا معنى له. البيشمركة، بابتساماتهم رغم الجروح، وبأحلامهم رغم النيران، كانوا يؤكدون أن الحياة تستحق أن تُعاش فقط عندما تكون فعلًا مقاومًا، فعلًا يتحدى العبثية ويمنح الوجود معنى. هذه الفلسفة تجد صداها أيضًا في كلام فرانكل، الذي يرى أن المعاناة تصبح محتملة عندما يكون لها معنى. بالنسبة للبيشمركة، المعنى كان الحرية، الحلم بوطن يعيش فيه الأطفال دون خوف، واللغة الكوردية تُدرّس بحرية، والأرض تُزرع دون قصف.
إن هذا الصراع بين رؤيتين للوجود يذكرنا بمفهوم هايدغر عن “الكينونة نحو الموت”. البيشمركة، بمواجهتهم الموت يوميًا، لم يكونوا يهربون منه، بل كانوا يعيشون وجودهم بكامل أصالته، مدركين أن الموت ليس نهاية، بل جزء من الكينونة البشرية. هذا الوعي بالموت جعلهم أكثر حرية، لأنهم تخلصوا من الخوف الذي يقيد الآخرين. كل شهيد سقط كان بمثابة تأكيد على أن الوجود الكوردي لا يمكن إلغاؤه، لأن الروح التي تقاوم لا تموت، بل تتجدد في أحلام الأجيال القادمة. هذه الفلسفة تجعل من البيشمركة ليس فقط مقاتلين، بل شعراء الوجود، يكتبون قصيدة الحرية بدمائهم، مؤكدين أن الوجود هو فعل إبداعي يتحدى العدم في كل لحظة.
معركة كۆڕێ: نقطة تحول في مسيرة النضال
يُقال إن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن في بعض الأحيان، يكتبه الصامدون، أولئك الذين يحولون الهزيمة إلى بداية جديدة، ورماد الألم إلى فجرٍ آخر. فهل كانت معركة كۆڕێ مجرد صدام عسكري؟ أم كانت لحظة وعي جماعي، تجلت فيها إرادة الوجود بعد قرون من الإنكار؟ وكما قال تشي جيفارا، الملهم الثوري: “الثورة ليست تفاحًا يسقط عندما ينضج. عليك أن تجعله يسقط”. هذه الكلمات لم تكن مجرد نظرية، بل كانت جوهر فعلنا في كۆڕێ. مع تصاعد هجوم النظام، وبعد الانتفاضة وتحرير كركوك، لم ييأس شعبنا. جيش صدام، بكل ثقله من طائرات ودبابات، هاجم كوردستان وسيطر على كركوك وأربيل ومصيف صلاح الدين، ثم اتجه نحو مدينتي شقلاوة. في بوابة شقلاوة، تحديداً في قرية كۆڕێ، جرت معركة شرسة ومواجهة دامية بين أبطال البيشمركة وجيش النظام، معركة لم تكن مجرد صدام عسكري، بل كانت تجسيدًا فلسفيًا لإرادة الحياة، و”ولادة سادسة” لمقاومة ذات أبعاد أعمق.
في صباح الثامن من نيسان عام 1991، ارتفع الضباب عن سفح جبل سفين في كۆڕێ، ليكشف عن لحظة فارقة في نضال الكورد الطويلة مع النضال والوجود. لم تكن معركة كۆڕێ مجرد صدام عسكري بين قوى الظلام وقوى النور، بل كانت شرارة أضاءت دروباً جديدة في مسيرة شعب يبحث عن معنى لوجوده وسط عواصف التاريخ. لا ينكر عاقل أن هذه المعركة كانت محطة تحول فارقة، إذ أجبرت النظام على التراجع أمام إرادة شعب، وأجبرته أن يمد يده نحو الحوار، بعد أن كان السيف هو لغته الوحيدة.
لم تأتِ قصة كۆڕێ من فراغ، بل كانت نتيجة انتفاضة كبرى، ورد فعل عنيف من قوى القمع، حاولت إخماد جذوة الحرية التي أشعلها الكورد في كل مكان. قبيل المعركة، غطى الليل مدن كوردستان، وسيطرت قوى الظلام على أربيل، فانسحب البيشمركة، وفر ملايين من أبناء كوردستان نحو الحدود، وكأنهم يبحثون عن ملاذ في جغرافيا الغربة والضياع. لكن حتى في لحظات اليأس تلك، كان الأمل يلوح كنجم بعيد، معلناً أن معنى الوجود لا يكتمل إلا بالانتصار على الذات قبل الانتصار على الآخر، وأن هذه النكبة كانت بدورها “ولادة سادسة” لوعيٍ جديد بأهمية الوحدة.
في تاريخ النضال الكوردي، كثيراً ما جُعل البيشمركة وقوداً لأيديولوجيات الحزب، وصارت الذات الفردية ضحية لمشروع جماعي متعالٍ. كان الحزب، في بعض الأحيان، أكبر من الإنسان نفسه، وأصبح التمجيد الأعمى للحزب كارثة على جسد البيشمركة والثورة، مما أدى إلى تشتت الجهود وإضاعة التضحيات. لم يكن معظم تاريخنا الحزبي نابعاً من فكر قومي أصيل، بل كان الحزب يتعالى على كل شيء، حتى على إرادة الشعب وحلمه بالحرية. ولكن في كۆڕێ، حدث تحول فلسفي عميق. كانت هذه المعركة تجسيدًا لوعي جمعي تجاوز انتماءات الحزبية الضيقة. هنا، أدرك المقاتل أن وجوده يتعدى مجرد كونه “جندي حزب” ليصبح “إنساناً يقاتل من أجل وجوده ووجود أمته”. هذا الفارق جوهري؛ إنه يعكس ما قاله سورين كيركيغارد في تأكيده على أهمية الذات الفردية وتجاوزها للمفاهيم المجردة. لقد كانت لحظة وعي بأن الأيديولوجيا لا تصنع الحرية، بل الأفراد الذين يحملون إرادة الوجود. كانت كۆڕێ شهادة على أن “أنا” الفردية حين تتحد مع “نحن” الأمة في سياق وجودي عميق، تصنع المستحيل، رافضةً أن تكون مجرد رقم في معادلة حزبية، مؤكدة على “ولادة سابعة” للوعي الفردي والجمعي المتحد.
أما أهمية معركة كۆڕێ في تاريخ الكورد، فتتجاوز حدود الجغرافيا العسكرية لتلامس عمق الوجود الإنساني. لقد حولت المعركة الهزيمة إلى انتصار، وأجبرت النظام على الاعتراف بإرادة شعب، وأنقذت آلاف الأرواح من براثن القمع. لأول مرة في تاريخ الأحزاب الكوردية، توحد الجميع في خندق واحد، متجاوزين الخلافات الأيديولوجية، ليكتبوا معاً فصلاً جديداً في حكاية الحرية، وليثبتوا أن الوحدة هي بذرة الولادة الأكثر قوة.
في النهاية، تبقى قصة كۆڕێ شاهداً على قدرة الإنسان على تجاوز ذاته، وعلى إرادته في صنع مصيره، حتى في أشد لحظات الظلام. إنها درس في الوجود والحرية، ودعوة إلى كتابة التاريخ بأقلام الإنسان، لا بأقلام الحزب. في رحلة الكورد مع الاغتراب والحنين، تظل كوردستان هي الأرض التي تشكل الهوية وتغذي الروح، حتى في غياب العدالة أو الاعتراف الدولي. جبالها ووديانها ليست فقط جغرافيا، بل هي الذاكرة الحية التي تحمل أسرار الشهداء وأحلام الأحياء، وتظل الموسيقى الكوردية صدىً خالداً لهذه الروح، تروي حكايات المقاومة والثورة، وتزرع الأمل في قلوب المنفيين والمحاصرين، كأنها تقول: “لن يُنسى هذا الوجود، حتى لو حاولت كل قوى الأرض محوه. هذه هي الولادة السابعة للروح، الولادة من رحم الوحدة، من رحم الإدراك بأن الذات الفردية جزء من كيان أوسع يرفض الفناء“.
معركة كۆڕێ، كما وصفتها، ليست مجرد حدث عسكري، بل هي تجسيد لما أسماه كيركغور “اليأس كمحرك للوجود”. اليأس هنا ليس استسلامًا، بل هو تلك الحالة التي تدفع الإنسان إلى مواجهة مصيره بكامل وعيه، مدركًا أن الوجود لا يكتمل إلا من خلال الفعل الحر. الكورد في كۆڕێ، بمواجهتهم جيشًا يفوقهم عددًا وتسليحًا، كانوا يعيشون هذا اليأس بأعمق معانيه، لكنهم حولوه إلى إرادة مقاومة، إلى تأكيد وجودي على أن الحياة تستحق أن تُعاش فقط إذا كانت حرة. هذه الإرادة تعكس مفهوم نيتشه عن “إرادة القوة”، ليس كسلطة على الآخرين، بل كقدرة على تجاوز الذات، على تحويل الألم والضعف إلى قوة خلاقة.
إن صمود العجوز التي تحمل الطعام إلى المقاتلين يعكس فلسفة فرانكل عن “المعنى في المعاناة”. هذه المرأة، التي شهدت حلبجة وسنوات القمع، لم تكن تقاوم فقط النظام، بل كانت تقاوم العدمية التي تحاول إقناعها بأن وجودها لا قيمة له. كلماتها عن موت الخوف في حلبجة تذكرنا بما قاله كامو: “التمرد يخلق القيمة.” هذا التمرد، الذي تجسد في فعلها البسيط، كان تأكيدًا على أن المقاومة هي فعل جماعي، يشارك فيه الجميع، من المقاتل في الخطوط الأمامية إلى العجوز التي تحمل سلة الطعام. هذا الفعل الجماعي هو ما جعل كۆڕێ رمزًا للصمود، لأنه أثبت أن الوجود الكوردي ليس مجرد رد فعل على الظلم، بل هو فعل إبداعي يعيد صياغة التاريخ.
أما الصمت الذي خيّم بعد المعركة، فهو يذكرنا بمفهوم هايدغر عن “الدهشة” كبداية الفلسفة. هذا الصمت لم يكن خوفًا أو هزيمة، بل كان لحظة تأمل في عمق الوجود، لحظة أدرك فيها المقاتلون أن ما حققوه ليس مجرد انتصار عسكري، بل تأكيد ميتافيزيقي على خلود الروح الكوردية. كل شهيد سقط في كۆڕێ كان بمثابة بذرة وجودية، تؤكد أن الحياة لا تنتهي بالموت، بل تتجدد في إرادة الأحياء. هذه الفلسفة تجعل من معركة كۆڕێ ليس فقط نقطة تحول في التاريخ الكوردي، بل لحظة تجلي وجودي، حيث أثبت الكورد أن الوجود هو صراع مستمر ضد العدم، صراع يُكتب بدماء الشهداء ويُروى بأحلام الأجيال القادمة.
هروب الجحيم: المليونية عبر الجبال ومآسي المخيمات
في لحظات التاريخ القاتمة، حيث تصبح الأرض سجنًا والسماء عدوًا، يتجلى المعنى الحقيقي للصمود، لا كخيار، بل كقدرٍ وجودي يُصنع بالإرادة لا بالاستسلام. هل القدر هو ما يحدث لنا، أم هو ما نختار أن نفعله بما يحدث؟ وكما أكد فكتور فرانكل، رائد العلاج بالمعنى: “البشر ليسوا مجرد منتجات للظروف، بل هم من يقررون ما إذا كانوا سيستسلمون لها أو يقفون في وجهها”. هذه الحقيقة تجسدت في كل خطوة على الجبال الثلجية، كانت بمثابة “ولادة ثامنة” للوعي الجماعي بالصمود المطلق. ما إن بدأت القوات الحكومية بإعادة تنظيم صفوفها، مستغلة الهدوء النسبي في أعقاب الحرب، حتى قلبت المعادلة العسكرية رأسًا على عقب. القوات التي عادت من الكويت بأسلحتها الثقيلة، والمروحيات التي استثنتها اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع التحالف، أصبحت أداة البطش الوحيدة بيد النظام الذي لم يكن ليرحم. وبمباركة ضمنية من التحالف الدولي، الذي فضل الصمت على التدخل، تحولت المروحيات إلى آلة رعب حقيقية حلّقت فوق مدن كوردستان المنهكة، تلقي بحممها على رؤوس الأبرياء. مع اشتداد القصف المدفعي والجوي وعودة الحرس الجمهوري بضراوة، بدأت موجات النزوح الكبرى تتشكل. البيشمركة، رغم شجاعتهم الأسطورية وبسالتهم في القتال، كانوا عاجزين أمام الطيران المتفوق والقصف المدفعي الكثيف الذي لا يمكن مواجهته بأسلحتهم الخفيفة. فُتحت الجبال الشاهقة، وأُغلقت الحدود في وجوه الملايين. مليونان نفس بشرية، رجال ونساء وأطفال، غادروا بيوتهم في لحظة واحدة، حاملين ذكرياتهم كأحجار ثقيلة على قلوبهم، سلكوا طريق الموت نحو الحدود التركية والإيرانية، في رحلة أصبحت تعرف بـ “النزوح المليوني”، رحلة تُعيد تعريف معنى البقاء.
كنتُ هناك، أحمل بندقيتي المكسورة كرمز للمقاومة المنهكة، وأرى أمي، تلك المرأة الصامدة التي تجسد روح الوطن، تحمل أخي الصغير بين ذراعيها وسط الثلج القارس الذي كان يتساقط بلا رحمة. كانت الجبال كأم عجوز تمد ذراعيها المنهكتين لأبنائها الهاربين من جحيم الأرض، لكن الثلج كان غطاءً باردًا لجراحنا التي لا تندمل، والريح كانت تنادي بأسماء الذين سقطوا على طول الطريق، أرواحهم تحلّق في البرد، لتصبح جزءاً من الذاكرة الكونية لهذه المأساة. قطعنا المسافات الطويلة سيراً على الأقدام، والقصف يطاردنا كشبح لا يرحم، لا يرى ولا يسمع، والجوع يعصر أمعاءنا كالنار الملتهبة. لم تكن الجبال مجرد صخور صماء؛ كانت كائنات حية، تتنفس معنا الألم، شاهدة على صرخة الروح التي ترفض الانكسار وتصر على البقاء، مؤكدة على أن كل خطوة هي “ولادة جديدة” للإصرار على الحياة. الطفل الذي بكى بصمت في حضن أمه، والأم التي غطت طفلها بثوبها الرقيق الواهي، والشيخ الذي دعا الله بصوت مبحوح وسط العواصف الثلجية—كلهم كتبوا بأقدامهم المتهالكة أبجدية حياة جديدة، أبجدية الصمود، أبجدية الولادة المتجددة من رحم المعاناة.
تذكرت لحظة وقوفي على حافة جبل شاهق، حيث رأيت قريتي تحترق في الأفق البعيد، وشعرت أن الجبال نفسها تبكي معنا، تشاركنا أحزاننا. الطيور توقفت عن الغناء، كأنها في حداد، لكن دماء الهاربين صنعت نهرًا من الأمل، نهرًا يجري نحو المجهول، حاملًا معه بذرة وجود جديد.
وصلنا الحدود، حيث وقف العالم متفرجًا، يشاهد المأساة على شاشات التلفاز وكأنها فيلم لا يخصه. تركيا أغلقت أبوابها في وجهنا بقسوة، والإيران فتحت ذراعيها على استحياء. لكن الجبال ظلت الملجأ الأخير، همست لنا: “الصمود هو المعنى الحقيقي للوجود.” في تلك اللحظة الوجودية، شعرت بوجود يتجاوز الزمان والمكان، كأن الجبال كانت تحكي قصة أزلية عن العلاقة بين الأرض والإنسان، قصة لا يفهمها إلا من فقد وطنه وتيه في الفراغ، ليكتشف أن وطنه الحقيقي في روحه، وأن كل غياب هو ولادة أخرى للبحث عن الانتماء.
سألت نفسي سؤالاً ميتافيزيقياً عميقاً بينما كانت الرياح الباردة تصفع وجهي: “هل هذه الأرواح الهاربة، هذه الملايين التي تتجمد على سفوح الجبال، هي تجسيد لمصير أمة بأكملها محكوم عليها بالتيه الأبدي؟ هل هذا الألم المتجمد في العظام، وهذا الصقيع الذي ينهش اللحم، هو الثمن الميتافيزيقي لخطايا أمة لم تُرتكب، بل هي ضحية لقوى تتجاوز فهمنا؟” كان الجواب يتردد في أعماقي كصدى صوت بعيد: لا جواب، فقط المزيد من الصمود، كأن الوجود ذاته يهمس لنا: “هذا طريقكم إلى المعنى، و”الولادة المتجددة” لن تتوقف هنا، بل هي قدركم الوجودي. وإن سالت دماؤكم أنهاراً، فسيأتي يومٌ يروي فيه الأمل عطشكم الأبدي“.
إن رحلة النزوح المليوني عبر الجبال الثلجية ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي تجسيد ميتافيزيقي لفلسفة الصمود الوجودي. يقول سارتر: “الإنسان محكوم عليه بالحرية”، وفي هذا السياق، فإن الكورد في نزوحهم لم يكونوا مجرد ضحايا للظروف، بل كانوا يمارسون حريتهم في اختيار الصمود على الرغم من العذاب. كل خطوة على الجبال الثلجية كانت فعلاً وجوديًا، تأكيدًا على أن الإنسان لا يُعرّف بما يُفرض عليه، بل بما يختاره في مواجهة العدم. هذا النزوح، بكل مآسيه، كان بمثابة “ولادة ثامنة” للوعي الجماعي، حيث أدرك الكورد أن الحياة ليست مجرد بقاء بيولوجي، بل هي إرادة مستمرة للبحث عن المعنى، حتى في أحلك الظروف.
كلام فرانكل عن المعاناة يجد صداه هنا بقوة. في كتابه “الإنسان يبحث عن المعنى”، يؤكد أن المعاناة تصبح محتملة عندما يكون لها هدف. بالنسبة للكورد في هذه الرحلة، كان الهدف هو الحفاظ على هويتهم، على وجودهم كشعب لا يقبل الإلغاء. الأم التي تحمل طفلها في الثلج، والشيخ الذي يدعو الله وسط العاصفة، كانوا يجسدون هذا الهدف، يحولون الألم إلى قوة خلاقة، إلى بذرة أمل تنبت في أرض اليأس. هذه الفلسفة تذكرنا أيضًا بكامو، الذي يرى في “التمرد” جوهر الحياة. النزوح لم يكن هروبًا من الموت، بل تمردًا على العدمية التي حاولت إقناع الكورد بأن وجودهم لا قيمة له. كل خطوة في تلك الرحلة كانت صرخة ضد العبثية، تأكيدًا على أن الحياة تستحق أن تُعاش، حتى لو كانت محفوفة بالمخاطر.
مشهد الجبال وهي تبكي مع الهاربين يعكس مفهوم هايدغر عن “الكينونة في العالم”. الجبال لم تكن مجرد خلفية مادية، بل كانت جزءًا من الوجود الكوردي، شاهدة على صراعهم، مشاركة في ألمهم وأملهم. هذا الارتباط بين الإنسان والأرض يتجاوز المادة ليصبح علاقة ميتافيزيقية، حيث تصبح الجبال رمزًا للأبدية، للروح التي لا تموت. في لحظة الوقوف على حافة الجبل، ومشاهدة القرية تحترق، كان هناك وعي وجودي عميق: الوطن ليس مجرد أرض، بل هو الروح التي تحمل ذكريات الشعب وأحلامه. هذا الوعي يجعل من النزوح ليس هزيمة، بل بداية جديدة، “ولادة ثامنة” تؤكد أن الإنسان قادر على إعادة صياغة وجوده، حتى في أحلك اللحظات.
المآسي المتراكمة: المسنون والأطفال الرضع في المخيمات
في هذا الجحيم المتكرر، حيث الزمن يتوقف ويدور في حلقة مفرغة من المعاناة، لا يرحم الوقت إلا القليلين. هل هناك ألم أعمق من رؤية البراءة تذبل والشيخوخة تُهان، بينما العالم يراقب في صمتٍ مريب؟ وكما تساءل سيغموند فرويد، أبو التحليل النفسي، عن “انتحار الحضارة” حين تترك أطفالها يموتون على مرأى ومسمع العالم، هل هذا الصمت العالمي هو إقرار ضمني بأن بعض الأرواح تستحق أقل من غيرها؟ المسنون، الذين كان يفترض أن تكون أعمارهم المتقدمة فترة للراحة والسكينة بعد سنوات طويلة من العمل والعناء، يجدون أنفسهم في معركة يومية مع الألم المتزايد والوحدة القاتلة. أجسادهم المتعبة تكاد تُنهار تحت وطأة البرد القارس والجوع الذي لا يشبع، وأرواحهم المثقلة بالذكريات المؤلمة عن وطنٍ تآكل وانطفأ نوره. كثير منهم يعانون أمراضًا مزمنة لم يجدوا من يعالجها في هذا العراء، ويفقدون القدرة على الحركة بينما تنهش البرودة عظامهم الهشة. غياب الرعاية الطبية والإنسانية يجعل من كل سعال بسيط أو وجع في القلب قصة موت بطيء ومهين، يراها العالم بأسره في صمت مطبق. إنها “ولادة جديدة” للموت في عراء الحياة.
الأطفال الرضع، أكثر الفئات ضعفًا وهشاشة في هذه الأوضاع القاسية، يُتركوا في كهوف الخيام المهترئة، التي لا تقي من برد ولا من حر. البرودة تلتهم أجسادهم الصغيرة، وحليب أمهاتهم يجف من شدة الإرهاق والجوع، فلا يجدون ما يسد رمقهم إلا البكاء الصامت الذي لا يسمعه أحد. الكثير منهم يموتون في هدوء مخيف، تذبل أرواحهم الصغيرة قبل أن تفتّح عيونهم على الحياة. إنها أرواح غادرت هذا العالم دون أن تعرف معنى الدفء أو الشبع، أرواح تشهد بصمتها الميت على فشل الإنسانية في حماية براءتها. أجسادهم الهزيلة تُدفن في قبور جماعية، بلا أسماء، بلا حكايات، كأنهم لم يأتوا إلى الوجود أبدًا، وكأن وجودهم كان مجرد وميض عابر في عتمة الوجود. هذه اللحظات، حيث يتلاشى أمل الحياة ويتحول إلى غبار في مهب الريح، تطرح سؤالاً وجودياً أعمق: هل هذه المعاناة اللامتناهية هي قدر محتوم على أرواحٍ لم تختر مصيرها، أم أنها وصمة عار على جبين الإنسانية التي تدّعي التحضر والعدالة؟ هل يمكن أن يكون هناك معنى للوجود حين يُترك الأضعف والأكثر براءة للموت في العراء، بينما العالم ينظر؟ هذه المخيمات لم تكن مجرد تجمعات لأناس هربوا من الموت؛ كانت مقبرة لأرواحٍ حية، سجنًا زمنيًا للكرامة، ومختبرًا لأقصى درجات القسوة الإنسانية، حيث يتجلى العدم في أبشع صوره، ويُكشف عن هشاشة الوجود.
هذه المآسي المتراكمة، التي أودت بحياة المسنين والأطفال الرضع في المخيمات، ليست مجرد مآسي إنسانية، بل هي تجليات للعبثية التي تحدث عنها كامو، حيث يبدو العالم خاليًا من المعنى عندما تُترك البراءة والحكمة لتذبل في صمت. يقول كامو إن العبث ينشأ من التناقض بين رغبة الإنسان في المعنى وصمت الكون، وفي هذه المخيمات، كان هذا الصمت صاخبًا، يدوي في أذن كل من شهد موت طفل أو انهيار مسن. لكن، كما يؤكد كامو، فإن مواجهة العبث لا تكون باليأس، بل بالتمرد، وهذا التمرد تجسد في إصرار المسنين على البقاء، في كل نفس يتنفسونه رغم الألم، وفي صرخات الأطفال الصامتة التي كانت تتحدى العدم. يقول فرانكل إن “المعاناة تصبح محتملة عندما يكون لها هدف”، وفي هذه المخيمات، كان الهدف هو الحفاظ على بذرة الحياة، حتى لو كانت هشة، حتى لو كانت محكومة بالموت. هذه “الولادة الجديدة للموت”، كما وصفتها، هي في الواقع ولادة للمعنى، لأن كل لحظة صمود، كل لحظة حياة، كانت تأكيدًا على أن الوجود الكوردي لا يمكن أن يُمحى. يقول هايدغر إن “الكينونة تتجلى في مواجهة العدم”، وفي هذه المخيمات، كان العدم يتجلى في البرد، الجوع، والصمت العالمي، لكن الكينونة الكوردية تجلت في إرادة البقاء، في الذكريات التي يحملها المسنون، وفي البراءة التي حاولت الأرواح الصغيرة التمسك بها. هذه المآسي تطرح سؤال سارتر عن الحرية: هل يمكن للإنسان أن يكون حرًا عندما يكون محاصرًا بالموت؟ الجواب يكمن في فعل الصمود نفسه، فعل يؤكد أن الحرية ليست غياب القيود، بل هي اختيار المعنى في وجه العدم، اختيار “ولادة متجددة” للروح التي ترفض أن تنكسر.
التمييز والعنصرية من حكومات تركيا وإيران
في قلب هذه المأساة الإنسانية التي لا تنتهي، حيث تتجمد الأرواح قبل الأجساد، لم تكن الطبيعة وحدها هي العدو، بل كانت الأيديولوجيات السياسية المتمثلة في سياسات الحكومات المجاورة تُعّمق الجراح وتُضيف طبقات جديدة من الألم والمعاناة. فهل يمكن للحضارة أن تزدهر عندما تبنى على إنكار وجود الآخر؟ وهل يمكن للأمة أن تدعي الإنسانية وهي تساهم في إبادة أمة أخرى؟ كما يقول المفكر الفرنسي ميشيل فوكو في تحليله للسلطة والمعرفة: “إن السلطة لا تُمارس فقط من خلال القوانين، بل من خلال الخطاب الذي يُنتج الحقيقة ويُشكل الوعي”. هكذا، كانت السياسات العنصرية والخطاب التمييزي ضد الكورد في تركيا وإيران جزءًا لا يتجزأ من آلية القمع، تُعيد إنتاج “ولادة جديدة” من القهر النفسي والاجتماعي.
في تركيا، ولسنوات طويلة، لم يُعترف بوجود الكورد كأمة ذات لغة وثقافة وتاريخ. لقد كان الخطاب الرسمي يصر على أن الكورد مجرد “أتراك جبليين”، محاولاً طمس هويتهم وكيانهم الوجودي. هذا الإنكار للوجود الكوردي لم يكن مجرد خطأ سياسي، بل كان حرباً وجودية تهدف إلى إبادة الهوية عبر النكران. في المخيمات على الحدود التركية، حيث فرّ الملايين بحثًا عن الأمان، قوبلوا بالتمييز والعنصرية الصارخة. لم يُقدم لهم سوى الحد الأدنى من المساعدات، وكأنهم لاجئون من الدرجة الثانية، لا يستحقون التعاطف أو الكرامة الإنسانية الكاملة. كانت نظرات الازدراء، والكلمات المسيئة، والمعاملة القاسية، تزيد من مرارة غربتهم، وتُذكرهم بأنهم حتى في هروبهم من الموت، ما زالوا يواجهون إنكارًا لوجودهم. هذا السلوك لم يقلل من معاناتهم الجسدية فحسب، بل نزف من كرامتهم، ودفع بهم نحو نوع آخر من “العدمية الوجودية”: عدمية النكران.
أما في إيران، فلم يكن الوضع بأفضل حال. فمع أن إيران كانت قد فتحت حدودها لأعداد أكبر من اللاجئين، إلا أن السياسات التمييزية ضد الكورد لم تتوقف. الكورد في إيران، وخاصة أولئك الذين أتوا من العراق، واجهوا صعوبات جمة في الحصول على حقوقهم الأساسية، بدءًا من التعليم وانتهاءً بالعمل. الفقر المدقع، وغياب الفرص، والعيش في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، كان يدفعهم إلى اليأس. كانت السلطات الإيرانية تنظر إلى الكورد كتهديد محتمل لأمنها القومي، مما زاد من الضغط عليهم وحرمهم من الشعور بالأمان الحقيقي. كانت هذه المعاملة تُجبر الكوردي على “ولادة” أخرى، لكنها ولادة في سجنٍ أكبر، سجنٍ تُحاط جدرانه بالعنصرية والإنكار المستمر للوجود.
هذه السياسات العنصرية لم تكن مجرد إجراءات إدارية، بل كانت تغلغلاً في عمق النفس الكوردية، محاولة لقتلها من الداخل. إنها تؤكد على أن الظلم لا يقتصر على العنف الجسدي، بل يتعداه إلى العنف الوجودي، عنف يُحرم الإنسان من الاعتراف به ككائن ذي قيمة وكرامة. هذه التجارب في المخيمات، تحت أنظار العالم، جعلت الكثيرين يتساءلون: هل الحرية التي ناضلنا من أجلها تستحق كل هذا الألم، إذا كانت نتيجتها هي الانتقال من سجن إلى آخر، من نوع من العدمية إلى نوع آخر؟ هل هذه هي الولادة المتجددة التي كنا نأملها؟ الجواب، كان يكمن في إصرار الروح على الصمود، إصرار على أن لا يختزل وجودها في نظرة الآخر، بل في إيمانها بذاتها، وهذا الإيمان هو بذرة “ولادة تاسعة” للذات، ولادة ترفض الانصهار في وعي الآخر القامع.
إن التمييز والعنصرية التي واجهها الكورد في المخيمات على الحدود التركية والإيرانية لم تكن مجرد سياسات، بل كانت هجومًا ميتافيزيقيًا على الكينونة، كما يراها هايدغر. يقول هايدغر إن الكينونة تتجلى في العلاقة مع العالم، ولكن عندما يُنكر العالم وجود الكائن، يصبح هذا الإنكار تهديدًا لجوهر الوجود نفسه. الخطاب التركي الذي قلل من الكورد إلى “أتراك جبليين”، والسياسات الإيرانية التي عاملتهم كتهديد، كانت محاولة لطمس الهوية، لتحويل الكوردي إلى “عدم” في وعي الآخر. لكن، كما يؤكد سارتر، فإن “الإنسان هو ما يصنعه بنفسه”، وفي هذا السياق، كان الكوردي يصنع وجوده من خلال رفضه لهذا الإنكار. هذا الرفض لم يكن مجرد مقاومة سياسية، بل كان تمردًا وجوديًا، كما يصفه كامو، تمردًا يؤكد على قيمة الذات في وجه العدمية التي تحاول إلغاءها. يقول نيتشه إن “ما لا يقتلني يجعلني أقوى”، وفي هذه المخيمات، كانت كل نظرة ازدراء، كل كلمة مسيئة، وقودًا لإرادة الصمود، لإيمان الكوردي بأن وجوده لا يُعرف بنظرة الآخر، بل بإرادته الحرة. هذه “الولادة التاسعة” للذات، كما وصفتها، هي ولادة للوعي بالحرية، حرية تتجاوز القيود المادية لتصبح إعلانًا عن كرامة الروح. يقول كيركغور إن “القلق هو دوار الحرية”، وفي هذا السياق، كان القلق الناتج عن التمييز دافعًا للقفزة الإيمانية، قفزة نحو إيمان الذات بقيمتها، بأحقيتها في الوجود، حتى في وجه العنصرية والنكران.
رحلة البحث عن المفقودين والشهداء: ألمٌ لا ينتهي وظلال لا تزول
في قلب كل مأساة، لا تكمن فقط الآلام الجسدية، بل الألم الوجودي الأعمق الذي ينبع من الفقدان والشك. فهل يمكن لروح أن تجد السلام قبل أن تُدرك مصير أحبائها؟ وهل الزمن قادر على شفاء جرح يبقى مفتوحًا على المجهول؟ كما يقول الشاعر اللبناني جبران خليل جبران: “حين تبكي، تبكي الروح لا العين”. وهذا البكاء الدائم الذي لم يتوقف هو إعلان عن “ولادة جديدة” للألم الذي يتجاوز الجسد ليغدو جزءاً من الكيان.
بعد تراجع جيش النظام، وفرحة التحرير التي كانت أشبه بومضة سريعة في ليلٍ طويل، بدأ فصل جديد من فصول الألم: البحث عن المفقودين. الآلاف من أبناء شعبنا، خاصة بعد عمليات الأنفال الوحشية في الثمانينات وبعد الانتفاضة، اختفوا وكأن الأرض ابتلعتهم. الرجال والنساء والأطفال، الذين لم يعودوا من تلك الرحلة المأساوية، تركوا خلفهم عائلات تحترق بنار الشك والحنين. كان كل بيت كوردي تقريبًا يحمل في ذاكرته قصة مفقود، أو شهيد لم يُدفن، أو قبر لم يُعرف مكانه. هذا الشك الوجودي، هذا السؤال المعلق “أين هم؟”، كان يؤرقنا أكثر من الألم الجسدي ذاته.
كان البحث عنهم رحلةً مضنية، أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. توجهنا إلى السجون والمعتقلات التي كانت تتبع النظام، تلك التي أصبحت الآن مهجورة أو تحت سيطرة البيشمركة. كنا نأمل أن نجد آثارًا، أسماءً، أو حتى بقايا أمل. دخلنا “القصر الأحمر” في سليمانية، وهو رمز للوحشية البعثية، حيث تُركت خلف جدرانه حكايات لا تُحصى من التعذيب والقتل. كانت جدران الزنزانات تتحدث عن أنات الموت، وعن صرخات لم يُسمع صداها. على جدران إحدى الزنزانات، وجدتُ اسم “حسين” محفورًا بظفرٍ أو حجر، وعلى الجدار المقابل كلمة “حرية” كتبها سجينٌ آخر بدمه. كانت هذه الجدران تجسيدًا لـ”ولادة أخرى” للوعي بالوجود، حيث تتجسد الحرية حتى في أقصى درجات القيد. هل كان هذا حسين الذي أعرفه؟ هل كان هذا الخط الأخير الذي خطّه في حياته؟ لم أجد إجابة، سوى صدى الصمت ومرارة الفقدان.
كانت المقابر الجماعية التي عُثر عليها لاحقًا، والتي تُروى حكاياتها اليوم في كل محفل، شاهدًا على جرائم لا تُغتفر. كل جماجم وعظام كانت تُكتشف، كانت تُعيد “ولادة جديدة” للألم، تفتح جراحًا لم تكن قد شُفيت بعد. لم تكن مجرد رفات، بل كانت أرواحًا تنادي بالعدالة، ذكريات حية ترفض النسيان. إن رحلة البحث عن المفقودين ليست مجرد مهمة إنسانية، بل هي محاولة وجودية لإعادة ربط الحاضر بالماضي، لإعادة بناء الذاكرة التي حاول النظام طمسها، ولإعطاء معنى لوجود أولئك الذين سقطوا ضحايا للظلم. هذا البحث هو بمثابة “ولادة عاشرة” للأمل، أمل في أن العدالة ستتحقق يومًا ما، وأن الظلال التي تلاحقنا ستتبدد بنور الحقيقة، وأن كل روح فقدت ستجد سلامها.
رحلة البحث عن المفقودين والشهداء هي رحلة في قلب القلق الوجودي، كما يصفه كيركغور، حيث يواجه الإنسان المجهول ويتساءل عن معنى وجوده في عالم يسمح بمثل هذه الجرائم. هذا السؤال المعلق “أين هم؟” ليس مجرد سؤال عن المكان، بل هو سؤال ميتافيزيقي عن الوجود نفسه: هل يمكن لروح أن تكتمل عندما يظل جزء منها مفقودًا؟ يقول هايدغر إن “الكينونة تتجلى في مواجهة العدم”، وفي هذه الرحلة، كان العدم يتجلى في المقابر الجماعية، في الجدران المحفورة، في الصمت الذي يحيط بالمفقودين. لكن هذا العدم لم يكن النهاية، بل كان دافعًا للتمرد، كما يقول كامو، تمرد يتجسد في البحث الدؤوب عن الحقيقة، في إصرار العائلات على إيجاد أحبائهم، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة الألم مرة أخرى. هذه “الولادة العاشرة” للأمل، كما وصفتها، هي تأكيد على فلسفة فرانكل التي ترى أن المعاناة تصبح محتملة عندما تكون ذات هدف، وهنا كان الهدف هو إعادة ربط الحاضر بالماضي، إعطاء صوت للذين سُلبوا صوتهم. يقول نيتشه إن “الإنسان الأعلى” هو من يتجاوز آلامه، وفي هذا البحث، كان الكورد يتجاوزون آلامهم، يحفرون في الذاكرة كما يحفرون في الأرض، بحثًا عن بقايا أمل، عن بذرة عدالة. هذه الرحلة ليست مجرد بحث عن أجساد، بل هي بحث عن المعنى، عن الإيمان بأن الوجود لا يمكن أن يُمحى، حتى لو حاول النظام طمسه. إنها ولادة للوعي بالعدالة، للإيمان بأن الظلال التي تلاحقنا ليست أبدية، وأن الحقيقة، مهما تأخرت، ستجد طريقها إلى النور.
العزلة والصمت: انقطاع الاتصال وصعوبة الوصول إلى الأخبار
في أتون المأساة، حيث يتلاشى النور ويُخيم الظلام، تصبح المعلومة شريان حياة، والاتصال حبل نجاة. فهل يمكن لروح أن تصمد وهي معزولة عن العالم، محاطة بسياجٍ من الصمت لا يخترقه سوى صدى اليأس؟ وكما قال الكاتب الألماني هرمان هيسه: “العزلة هي مسار نحو الذات، ولكنها قد تكون أيضًا طريقًا إلى الجنون إذا لم تُروّح بالوعي”. في تلك الأيام العصيبة، لم نكن نعاني فقط من القصف والجوع والبرد، بل من عزلة خانقة، عزلة جعلتنا نشعر وكأننا نعيش في فقاعة زمنية خارج نطاق التاريخ، في “ولادة جديدة” لشعورٍ بالعدمية.
مع قطع الاتصالات، وانقطاع شبكات الهاتف، وغياب شبكات الإنترنت التي لم تكن منتشرة حينها، وغلق الطرق، أصبح العالم الخارجي بعيدًا عنا، ككوكبٍ آخر. لم نكن نعرف ماذا يحدث في المدن الأخرى، هل سقطت، هل صمدت؟ هل العالم يعلم بمأساتنا؟ هل هناك من يمد يد العون؟ كنا نعيش في صمت مطبق، لا يُكسره سوى صوت الراديو الذي كان المصدر الوحيد للأخبار، لكنه كان يعطينا أجزاءً من الصورة، لا الصورة الكاملة. هذا الانقطاع عن العالم الخارجي، وهذه العزلة القسرية، زادت من شعورنا بالوحدة والهشاشة. كنا نرى طائرات النظام تحلق فوق رؤوسنا، تلقي بحممها، ونحن لا نملك سوى الدعاء والصمت، والصبر الذي كان ينمو فينا كشجرة صلبة في صحراء العزلة، وهي بذرة “ولادة أخرى” لمرونة الروح.
في المخيمات، كانت الأخبار تنتقل عبر الهمس والشائعات، كل قصة تُروى تُعاد صياغتها لتُصبح أكثر درامية، أو أكثر يأسًا. كان اللاجئون يتبادلون قصص الموت والدمار، لكنهم في الوقت نفسه، كانوا يتشبثون بأي بصيص أمل، أي خبر قد يحمل في طياته نهاية لهذه المأساة. كان البحث عن الأخبار أشبه بالبحث عن الماء في صحراء قاحلة، كل معلومة صغيرة كانت تُشعل شرارة أمل أو يأس، لكنها كانت ضرورية لبقاء الروح. هذه العزلة جعلتنا ندرك قيمة التواصل، قيمة الكلمة التي تربطنا بالعالم، بالآخر، وبذاتنا. إنها “ولادة جديدة” للتقدير العميق للتواصل الإنساني، وللشعور بأن الإنسان لا يمكن أن يكتمل وجوده بمعزل عن الآخرين، حتى لو كان ذلك الآخر مجرد خبرٍ عابر.
العزلة التي عاشها الكورد في المخيمات ليست مجرد انقطاع مادي عن العالم، بل هي حالة وجودية، كما يصفها هايدغر، حيث يواجه الإنسان “القلق الأصيل” الناتج عن الانفصال عن العالم. يقول هايدغر إن “الكينونة في العالم” تتطلب علاقة مع الآخرين، ولكن في هذه المخيمات، كان هذا العالم مغلقًا، محصورًا في فقاعة الصمت والشائعات. هذه العزلة هي تجسيد لما يسميه سارتر “الوحدة الوجودية”، حيث يُدرك الإنسان أن وجوده يعتمد على اختياراته الخاصة، حتى عندما يكون محرومًا من أدوات التواصل. لكن، كما يؤكد كامو، فإن العبث لا يعني النهاية، بل هو دعوة للتمرد، وهذا التمرد تجسد في إصرار اللاجئين على البحث عن الأخبار، على التشبث بكل همسة أمل. يقول فرانكل إن “الإنسان يستطيع أن يتحمل كل شيء إذا وجد معنى”، وفي هذه العزلة، كان المعنى يكمن في الكلمة، في الخبر، في الاتصال الذي يربط الروح بالعالم. هذه “الولادة الجديدة” لمرونة الروح، كما وصفتها، هي تأكيد على فلسفة نيتشه عن “إرادة القوة”، حيث يصبح الصبر، الذي شبهته بشجرة صلبة، قوة خلاقة تنمو في صحراء اليأس. يقول كيركغور إن “الإيمان هو الشغف بالممكن”، وفي هذه المخيمات، كان الإيمان بالممكن يتجلى في كل محاولة لكسر الصمت، في كل شائعة تحمل أملًا، في كل دعاء يرتفع إلى السماء. هذه العزلة، رغم قسوتها، كانت مدرسة للوعي، مدرسة علمتهم أن الوجود لا يكتمل إلا بالعلاقة مع الآخر، وأن الكلمة، مهما كانت ضعيفة، هي سلاح الروح في مواجهة العدم.
تأثير المعارك بين المعارضة الكوردية والحكومة التركية على مخيمات اللاجئين
لم تكن محنتنا، نحن الكورد، تقتصر على الصراع مع النظام العراقي فحسب. فكما أن الوجود الإنساني يتشكل بتفاعله مع محيطه، كانت المعارك الدائرة بين المعارضة الكوردية (خاصة حزب العمال الكوردستاني PKK) والحكومة التركية تزيد من تعقيد الوضع، وتُلقي بظلالها القاتمة على حياة اللاجئين في المخيمات الحدودية. فهل يمكن لروحٍ أن تجد السلام عندما تكون محاصرة بين نارين؟ وهل يمكن للأمل أن ينمو في تربةٍ مُثقلة بالصراعات المتشابكة؟ وكما يقول كارل ماركس: “تاريخ جميع المجتمعات الموجودة حتى الآن هو تاريخ صراع الطبقات”، وفي حالتنا، هو تاريخ صراع الهويات والوجود الذي لا يرحم. هذا الصراع المستمر كان “ولادة” لأبعاد جديدة من الألم، أبعاد تتجاوز حدود وطننا الأم.
في المخيمات الواقعة على الحدود التركية، حيث فرّ الآلاف من القصف والقتل، أصبحنا نعيش تحت تهديد مزدوج. من جهة، كان هناك خطر القصف العراقي الذي لم يتوقف تمامًا، ومن جهة أخرى، دخلنا في صراعٍ لا ناقة لنا فيه ولا جمل: الصراع بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني. كانت القوات التركية تشن عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد مقاتلي الحزب في المناطق الحدودية، وهذه العمليات لم تكن تُفرّق بين المقاتل واللاجئ الأعزل. القصف التركي كان يستهدف القرى الحدودية والمخيمات أحيانًا، مما يُجبر اللاجئين على النزوح مرة أخرى، والبحث عن ملاذات جديدة في عمق الجبال أو في مناطق أقل خطورة.
هذا الوضع زاد من مرارة اللاجئين وشعورهم بالخذلان. كانوا قد هربوا من جحيم في وطنهم، ليجدوا أنفسهم محاصرين في جحيم آخر على الحدود. هذا التوتر المستمر، وهذا الخوف الدائم من أن تتحول المخيمات إلى ساحات قتال، جعل الحياة في المخيمات أشبه بانتظار الموت. الأطفال كانوا يترعرعون على أصوات المدافع والطائرات، ويشاهدون وجوه الخوف على وجوه أهاليهم، مما غرس فيهم شعورًا عميقًا بعدم الأمان، وبأن “الولادة” في هذا العالم كانت لعنة لا نعمة. النساء كن يعشن في رعب دائم على مصير أبنائهن وأزواجهن، ومعاناتهن لم تكن جسدية فحسب، بل نفسية عميقة.
هذا التأثير لم يقتصر على الجانب الأمني، بل امتد إلى الجانب الإنساني. المساعدات الإنسانية كانت تصل بصعوبة إلى المخيمات، وكثيرًا ما كانت تُعيقها العمليات العسكرية التركية. الفقر والمرض وسوء التغذية كانت سمات أساسية في هذه المخيمات، حيث كان اللاجئون يُعاملون كرهائن في صراع لا يخصهم، وكأن وجودهم أصبح مجرد أداة في لعبة سياسية أوسع. هذا الواقع المرير دفع بالعديد من اللاجئين إلى التفكير في الهجرة إلى دول أبعد، بعيدًا عن هذه الصراعات المتشابكة، بحثًا عن مكان يجدون فيه السلام والأمان والكرامة الإنسانية، بحثًا عن “ولادة حقيقية” في عالمٍ أكثر رحابة. لقد كانت هذه التجارب تذكيرًا مؤلمًا بأن معاناة الكورد ليست معزولة، بل هي جزء من نسيج معقد من الصراعات الإقليمية والدولية التي تُعيد تعريف معنى الوجود، وتُجبر الروح على التجدد في كل مرة تتعرض فيها للفناء.
الصراعات المزدوجة التي عاشها الكورد في المخيمات، بين القصف العراقي والعمليات التركية، هي تجسيد لما يسميه سارتر “الصراع مع الآخر”، حيث يصبح وجود الإنسان مهددًا ليس فقط بالقوة المادية، بل بنظرة الآخر التي تحاول اختزاله إلى مجرد موضوع. في هذه المخيمات، كان الكورد يُعاملون كرهائن في صراع لا يخصهم، لكن هذا الاختزال لم يُنهِ وجودهم، بل أثار فيهم تمردًا وجوديًا. يقول كامو إن “التمرد هو رفض الموت”، وفي هذه الحالة، كان التمرد هو إصرار اللاجئين على البقاء، على البحث عن ملاذات جديدة، على رفض أن يصبحوا مجرد ضحايا في لعبة سياسية. يقول نيتشه إن “الفوضى تولد النجوم”، وفي هذا الفضاء المضطرب من الصراعات، كانت كل خطوة للنزوح، كل محاولة للبقاء، نجمة في سماء الأمل الكوردي. هذه “الولادة الحقيقية” التي دفعتهم للبحث عنها في دول أبعد هي تجسيد لفكرة فرانكل عن المعنى، حيث يصبح البحث عن الأمان والكرامة هدفًا يعطي للحياة قيمة. يقول هايدغر إن “الإنسان هو كائن يسأل عن الكينونة”، وفي هذه المخيمات، كان السؤال الدائم هو: كيف نكون في عالم يرفضنا؟ الجواب كان في الصمود، في الأمل الذي ينمو رغم الخوف، في الإرادة التي تحول الأطفال الذين يترعرعون على أصوات المدافع إلى أبطال المستقبل. هذه الصراعات، رغم قسوتها، كانت مدرسة للوعي، علمتهم أن الوجود ليس مجرد بقاء، بل هو فعل إبداعي يتحدى الفناء، يتحدى الصراعات، ويؤكد على “ولادة متجددة” للروح الكوردية في وجه كل النيران.
محاولات الصمود: بين سيوف القتال وصخب المدن
في خضمّ الدمار والفوضى، حيث تُهدد الروح بالانكسار، يتجلى جوهر الإنسان في قدرته على الصمود، لا كفعلٍ تلقائي، بل كقرارٍ وجودي واعٍ. فهل يمكن للأمل أن يولد من رحم اليأس؟ وهل تُصبح الإرادة شراعًا في بحرٍ هائج؟ وكما قال ألبر كامو، فيلسوف العبث: “إنّ أفضل طريقة للتعامل مع واقع لا يطاق هو أن ترفض قبوله.” هذه المقولة كانت تتجسد في كل نفسٍ يخرج من صدر، وفي كل خطوةٍ تُتخذ، مُعلنةً عن “ولادة جديدة” للإصرار على الحياة.
في تلك اللحظات الفاصلة، كانت روح الصمود تتجلى في وجوه البيشمركة، أولئك الشباب الذين حملوا أرواحهم على أكفهم، وواجهوا جيشًا مدججًا بأحدث الأسلحة بصدور عارية، بقلوب مؤمنة بقضيتهم. لم يكن قتالهم مجرد صراع عسكري، بل كان فعلاً وجودياً عميقاً، إعلانًا عن حقهم في الحياة والكرامة، وتأكيدًا على أن الوجود لا يُمنح، بل يُنتزع بالدم والعرق والإرادة. في الجبال الشاهقة، وعلى سفوح الوديان، كانت كل قطرة دم تُسفح تُروي شجرة الحرية، وتُصبح بذرة “لخلق معنى” في عالمٍ بدا عبثيًا وقاسياً.
وفي الوقت نفسه، كانت المدن، رغم صخبها وضجيجها، ساحة أخرى للصمود. فمع تراجع جيش النظام بعد انتصارات البيشمركة في كۆڕێ، بدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى المدن المحررة. كانت هذه العودة بحد ذاتها فعلًا وجوديًا، إعلانًا عن رفض الاستسلام. الناس الذين نزحوا إلى الجبال، بدأوا بالعودة إلى بيوتهم المدمرة، إلى أزقتهم التي شهدت الكثير من الألم. كانوا يعملون ليل نهار لإعادة بناء ما دمره القصف، لإصلاح الجدران المهدمة، ولإزالة آثار الدمار، وكأنهم يعيدون بناء أنفسهم من جديد. هذه الأعمال اليومية، البسيطة في ظاهرها، كانت تحمل في طياتها معنى عميقًا للصمود؛ إنها إصرار على الحياة في وجه الموت، على الأمل في وجه اليأس.
النساء، اللواتي كنّ يحملن عبء العائلة والمجتمع، لعبن دورًا بطوليًا في هذه المحاولات. كنّ يعِدن تنظيم الحياة في المخيمات، يُطبِخن الطعام، يُعِتن بالأطفال، ويُعلِّمن الأجيال الجديدة قيمة الصمود والحفاظ على الهوية. في أزقة المدن المدمرة، كنّ يرفعن رؤوسهن بفخر، ويُشاركن في أعمال إعادة البناء، وكأن كل حجر يُوضع هو “ولادة جديدة” للأمل في بناء مستقبل أفضل.
محاولات الصمود هذه لم تكن بلا ثمن. فالمعارك كانت لا تزال مستمرة في بعض الجبهات، والمدن كانت لا تزال تحت تهديد القصف، والحصار الاقتصادي كان يُضيّق الخناق على الناس. ولكن في كل هذه الظروف، كان هناك إصرار لا يتزعزع على البقاء، على مقاومة العدم. هذا الصمود ليس مجرد شجاعة في وجه الخطر، بل هو فلسفة حياة، إيمان بأن الوجود يستحق الكفاح من أجله، وأن “الولادة المتجددة” ليست مجيارية، بل هي جوهر هذا الشعب الذي يرفض الفناء. إنها إرادة عميقة للذات لا ترضخ للحتمية، بل تصنع قدرها بنفسها.
ان الصمود، كما تجلى في وجوه البيشمركة وجهود النساء وأهالي المدن، ليس مجرد فعل بقاء، بل هو تجسيد لفلسفة سارتر عن الحرية، حيث يُعرّف الإنسان وجوده من خلال اختياراته. في مواجهة الدمار والفوضى، كان اختيار الصمود قرارًا واعيًا، إعلانًا عن أن الوجود الكوردي لن يُختزل إلى ضحية. يقول سارتر إن “الإنسان محكوم عليه بالحرية”، وفي هذه اللحظات، كان الكورد محكومين بحرية اختيار الحياة، حتى في وجه الموت. هذا الصمود هو أيضًا تجلي لفكرة نيتشه عن “إرادة القوة”، حيث تتحول المعاناة إلى قوة خلاقة، تروي شجرة الحرية بدماء البيشمركة وتعيد بناء المدن بحجارة الأمل. يقول كامو إن “التمرد هو رفض قبول العبث”، وهنا كان التمرد يتجسد في كل خطوة نحو إعادة البناء، في كل وجبة تُعد في المخيمات، في كل درس تُعلمه الأمهات لأبنائهن. هذه “الولادة الجديدة” للإصرار على الحياة هي تأكيد على فلسفة فرانكل، التي ترى أن المعنى يمكن أن يُوجد حتى في أقسى الظروف. في هذا السياق، كان المعنى يكمن في الحفاظ على الهوية، في بناء مستقبل يتحدى الماضي. يقول هايدغر إن “الكينونة تتجلى في العناية”، وفي هذه المحاولات، كانت العناية بالوطن، بالعائلة، بالذات، هي ما أعطى للصمود بعده الميتافيزيقي. يضيف كيركغور أن “الإيمان هو القفزة نحو المجهول”، وفي هذه الجبال والمدن، كانت كل خطوة، كل حجر يُوضع، قفزة إيمانية نحو أمل لا يُرى، ولادة لروح ترفض أن تنكسر، ترفض أن تُختزل إلى مجرد ضحية للتاريخ.
النساء والأطفال: براءة تُهددها الحرب والجوع في قلب العاصفة
في كل حرب، وفي كل مأساة، هناك فئة تدفع الثمن الأغلى، ليس فقط بالدم، بل بالروح والطفولة المنهوبة: إنهم النساء والأطفال. هل يمكن لبراءة الطفولة أن تزدهر في حقول الموت؟ وهل يُمكن لقلب أم أن يجد السكينة وهو يرى صغاره يذبلون جوعًا؟ وكما قال الفيلسوف الروسي فيودور دوستويفسكي: “إن مقياس الحضارة هو طريقة معاملتها لأطفالها”. في قلب العاصفة، كانت هذه الفئة هي الأكثر ضعفًا، والأكثر عرضة لـ”ولادة” في عالم لا يعرف الرحمة.
النساء، اللواتي هن رمز الحياة والعطاء، وجدن أنفسهن في جبهة أخرى من جبهات الحرب: جبهة البقاء. كنّ يحملن عبء الوطن على أكتافهن المنهكة، يُهرَبن بأطفالهن عبر الجبال الوعرة، يحملن الرضع الجائعين، ويُحاولن حماية الصغار من وحشية القصف وبرودة الثلج. أجسادهن كانت منهكة، وأرواحهن كانت تمزقها آلام الفقد، لكن إصرارهن على الصمود كان يفوق كل تصور. كنّ يجدن القوة في ضعفهن، الأمل في يأس اللحظة، والحياة في قلب الموت. كانت كل دمعة تسقط من عيونهن تُروي أرض الوطن، وكل همسة أمل منهن تُشعل شمعة في الظلام، وهذا الإصرار كان بمثابة “ولادة دائمة” للأمل في وسط اليأس.
أما الأطفال، أولئك الذين يجب أن يعيشوا طفولتهم بسلام وبراءة، فقد وُلدوا في زمنٍ لا يعرف البراءة. رأوا الموت بعيونهم الصغيرة، وذاقوا مرارة الجوع والخوف قبل أن يعرفوا معنى اللعب أو الدفء. كثير منهم قضوا نحبهم بصمت، أجسادهم الصغيرة تذبل من البرد والمرض، دون أن يُعرف مصيرهم. والذين بقوا، حملوا ندوب الحرب في أرواحهم، ندوبًا سترافقهم طوال حياتهم. لقد كانت طفولتهم أشبه بـ”ولادة مُبتسرة”، ولادة في عالم قاسٍ لم يُمهلهم ليعيشوا براءتهم.
في المخيمات، كانت معاناة النساء والأطفال تتجلى في أبشع صورها. كانت أمهات يرىن أطفالهن يتضورون جوعًا ولا يجدن ما يُطعِمنهم، ونساء يُجبَرن على تحمل مسؤوليات تفوق قدراتهن. الفقر المدقع، غياب الرعاية الصحية، ونقص الغذاء، جعل المخيمات بيئة قاتلة لهذه الأرواح البريئة. ومع كل موت لطفل أو كل دمعة أم، كانت تتردد في أعماق الروح أسئلة وجودية لا إجابة لها: هل هذا هو القدر المحتوم؟ هل هذه هي إنسانية العالم؟ هل “الولادة” في هذا العالم يمكن أن تكون لعنة لا نعمة؟ هذه الأسئلة تعمق الشعور بأن هذه التجربة ليست مجرد مأساة عابرة، بل هي حقيقة وجودية تُشكل جوهر الوعي بالذات، وتُعلن أن “الولادة المتجددة” لن تتوقف حتى يعمّ السلام.
معاناة النساء والأطفال في قلب الحرب هي تجسيد للعبثية التي تحدث عنها كامو، حيث يبدو العالم خاليًا من العدالة عندما تُسلب البراءة وتُهدد الحياة. لكن، كما يؤكد كامو، فإن مواجهة العبث تتطلب التمرد، وهذا التمرد تجسد في إصرار النساء على حماية أطفالهن، في كل دمعة تُروي الأرض، في كل همسة أمل تُشعل الظلام. يقول نيتشه إن “الألم هو المعلم الأعظم”، وفي هذه المخيمات، كان الألم يعلم النساء والأطفال قوة الصمود، يحولهن إلى رموز لإرادة الحياة. يقول فرانكل إن “المعاناة تصبح محتملة عندما تكون ذات هدف”، وهنا كان الهدف هو الحفاظ على بذرة الأمل، على البراءة، حتى لو كانت مهددة بالجوع والحرب. يقول هايدغر إن “الكينونة تتجلى في العناية”، وفي هذه الجبال والمخيمات، كانت العناية الأمومية، الحماية التي قدمتها النساء، تجسيدًا للكينونة في أنقى صورها. يضيف سارتر أن “الحرية هي ما نفعله بما يُفعل بنا”، وفي هذا السياق، كانت النساء يصنعن حريتهن من خلال تحويل ضعفهن إلى قوة، من خلال إيمانهن بأن الحياة تستحق الكفاح. يقول كيركغور إن “اليأس هو مرض الروح”، لكن هذه النساء والأطفال، رغم كل اليأس، كانوا يحملون في قلوبهم قفزة إيمانية، إيمانًا بأن “الولادة المتجددة” ليست لعنة، بل هي شهادة على قوة الروح الكوردية، على قدرتها على تحدي العاصفة والخروج منها أقوى، حاملة شعلة الأمل للأجيال القادمة.
مرارة اتفاقية سايكس بيكو: الوطن المُجزأ وإرثها الثقيل
في التاريخ، ليست كل الجروح تلتئم، وليست كل الخرائط تُعاد رسمها. فبعض القرارات العابرة تُصبح لعنة أبدية، تُقسم الأوطان وتُشتت الشعوب. هل يمكن لروح أن تجد السلام وهي مُقطّعة الأوصال، مُبعثرة بين حدود صنعها الغريب؟ وكما قال المفكر الفرنسي جاك دريدا، أن “التفكيك يكشف عن البحث عن المعنى الكامن في النص”، فهل اتفاقية سايكس بيكو كانت نصاً تاريخياً يتطلب تفكيكه ليعلن عن “ولادة مستمرة” للألم؟
إن اتفاقية سايكس بيكو، التي أبرمت عام 1916 بين فرنسا وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى، لم تكن مجرد اتفاقية لتقسيم الأراضي العثمانية. كانت بمثابة “عملية جراحية كبرى” على جسد الشرق الأوسط، زرعت فيه بذور التفكك والانقسام، وقسمت شعب الكورد إلى أربع قطع، وزعتها على دول جديدة لم تعترف بوجودهم أو حقوقهم. لم تكن هذه الاتفاقية مجرد خطوط على خريطة، بل كانت خطوطًا على قلوبنا وأرواحنا، حولت الوطن الواحد إلى أربعة أوطان مبعثرة، كل قطعة منها تعاني تحت حكمٍ غريب.
منذ ذلك الحين، أصبح الكوردي يعيش في حالة دائمة من الاغتراب داخل وطنه الأم. في تركيا، في إيران، في سوريا، وفي العراق، كان يُعامل كغريب في أرضه، تُمنع لغته، وتُقمع هويته، وتُسفك دماؤه بلا رحمة. إرث سايكس بيكو لم يكن مجرد إرث سياسي، بل كان إرثًا وجوديًا ثقيلًا، فرض على الكورد “ولادة” قسرية في كل من هذه الأوطان الفرعية، ولادة تُجبرهم على التكيف مع واقع لا يعترف بوجودهم الكامل. كانت كل محاولة للمطالبة بالحقوق تُقابل بالقمع الوحشي، وكل حلم بالوحدة يُقابل بالتشظي والتمزيق.
مرارة هذه الاتفاقية لم تكن تكمن في التقسيم الجغرافي فحسب، بل في تقسيم الروح. لقد جعلت الكوردي يعيش في حالة دائمة من التمزق بين الانتماء إلى وطنه الأم الذي يتجاوز الحدود، وبين الضرورات القاسية للعيش تحت حكمٍ غريب. إنها “ولادة جديدة” لوعيٍ مؤلم بأن الوجود لا يمكن أن يتحقق بالكامل ما دام الوطن منقسماً، ما دامت الهوية مهددة، ما دامت الدماء تُسفك على حدودٍ رسمها الغرباء.
هذا الإرث الثقيل لسايكس بيكو يطرح سؤالاً وجودياً أعمق: هل يمكن لشعب أن يحقق “الولادة الكاملة” لوجوده وكرامته، وهو ما زال تحت تأثير لعنة تاريخية لم تُصنع بأيديه؟ هل يمكن أن يشفى جسدٌ مُقطّع، وتلتئم روحٌ مُبعثرة، ما دامت هذه الاتفاقية تُرخي بظلالها على حاضرنا ومستقبلنا؟ هذه المرارة هي جزء لا يتجزأ من سيرة الاغتراب الكوردية، فهي التي تُشكل وعينا الدائم بالظلم، وتدفعنا نحو البحث عن معنى للوجود يتجاوز هذه الحدود المصطنعة.
لكن مرارة سايكس بيكو لا تكتمل إلا بفهم ما سبقها وما تلاها من خيانات تاريخية، أبرزها إلغاء معاهدة سيفر واستبدالها بمعاهدة لوزان، في واحدة من أبشع صفقات المصالح الدولية التي دُفنت فيها آمال شعب بأكمله. معاهدة سيفر، التي وُقّعت في 10 أغسطس 1920 عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، كانت بمثابة وعدٍ نادر بالعدالة للكورد. لقد نصت هذه المعاهدة على حق الكورد في تقرير مصيرهم، ومنحتهم إمكانية إقامة دولة مستقلة في الأراضي التي يشكلون فيها الأغلبية. كانت لحظة تاريخية، وميض أمل في ظلام القمع، إعلانًا عن إمكانية “ولادة حقيقية” للوجود الكوردي كشعب حرّ يملك مصيره. لكن هذا الوعد لم يكن سوى وهمٍ سرعان ما تبخر تحت وطأة مصالح الدول الكبرى.
معاهدة سيفر، التي أُجبرت الدولة العثمانية على توقيعها كجزء من تفككها، أثارت غضب القوميين الأتراك بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، الذين رأوا فيها تهديدًا لوحدة تركيا الناشئة. ألهبت شروط المعاهدة، التي تضمنت التخلي عن الأراضي العثمانية غير الناطقة بالتركية ومنح الكورد حق تقرير المصير، حالة من العداء القومي. قاد أتاتورك حرب الاستقلال التركية، التي أفضت إلى معاهدة لوزان في 24 يوليو 1923، وهي معاهدة سلام وُقّعت في سويسرا بين تركيا والحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى. هذه المعاهدة، التي ألغت سيفر بالكامل، لم تُشر حتى إلى وجود الكورد كشعب له حقوق، بل كرّست تقسيم أراضيهم بين تركيا، العراق، سوريا، وإيران، وفق خطوط سايكس بيكو. لقد كانت لوزان خنجرًا آخر في قلب الروح الكوردية، تكريسًا لإلغاء وجودهم السياسي، وتأكيدًا على أن مصالح الدول الكبرى تتفوق على العدالة.
لم تكن هذه الصفقة الدولية مجرد نتيجة للصراعات الإقليمية، بل كانت تعبيرًا عن بشاعة السياسات الاستعمارية التي أدارت الدول الكبرى مصالحها بلا أدنى اعتبار لإنسانية الشعوب. فرنسا وبريطانيا، اللتان كانتا قد وعدتا الكورد بحق تقرير المصير في سيفر، تخلتا عن هذا الوعد لإرضاء تركيا الناشئة، التي كانت حجر زاوية في توازن القوى الإقليمي. لقد كانت مصالح الدول الكبرى، من النفط إلى النفوذ الجيوسياسي، هي المحرك الوحيد وراء هذا التواطؤ. الكورد، الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وجدوا أنفسهم مُضحّى بهم على مذبح السياسة، أرواحهم مُهددة، وأحلامهم مُداسة. هذا التواطؤ لم يكن مجرد خيانة سياسية، بل كان اعتداءً ميتافيزيقيًا على الكينونة، محاولة لإلغاء الوجود الكوردي كشعب له حق في الحياة والحرية.
هذا الإلغاء لمعاهدة سيفر وتكريس معاهدة لوزان لم يُشكلا فقط تقسيمًا جغرافيًا، بل كانا تقسيمًا للروح، كما نصّ سايكس بيكو. الكوردي، الذي كان قد لمح وميض الحرية في سيفر، وجد نفسه محكومًا بالعيش في أوطان أربعة، كل منها يُنكر وجوده بطريقته. في تركيا، أُجبِر على أن يكون “تركيًا جبليًا”، وفي إيران وسوريا والعراق، عُومل كمواطن من الدرجة الثانية، أو كتهديد أمني. هذه الحدود المصطنعة لم تُقطّع الأرض فحسب، بل قطّعت الذاكرة، الهوية، والأمل. كانت كل محاولة للنهوض، كل صرخة للحرية، تُقابل بالقمع، كما لو أن العالم قد اتفق على أن الكوردي يجب أن يظل أسير هذه اللعنة التاريخية.
عدم إنسانية الدول الكبرى في إدارة مصالحها تتجلى في هذا التواطؤ السافر، حيث تم التضحية بحقوق شعب بأكمله لأجل استقرار إقليمي مؤقت، أو لضمان تدفق النفط، أو لإرضاء قوى قومية صاعدة. هذه البشاعة ليست مجرد سياسة، بل هي إعلان عن أن قيمة الإنسان تُقاس بقوة الدول التي ينتمي إليها، لا بكرامته الجوهرية. كانت هذه الخيانة بمثابة “ولادة قسرية” لوعي كوردي جديد، وعي بالظلم العالمي، بالحاجة إلى الاعتماد على الذات، بالإصرار على أن الوجود لا يُمنح من الخارج، بل يُصنع من الداخل.
هذا الإرث الثقيل، من سايكس بيكو إلى سيفر إلى لوزان، يطرح سؤالاً وجودياً لا يزال يتردد: هل يمكن لشعب أن يُحقق كينونته الكاملة في عالم يُدار بمثل هذه البشاعة؟ هل يمكن لروح أن تلتئم بعد أن قطّعتها أيدي الغرباء؟ الجواب يكمن في الصمود الكوردي، في كل تمرد ضد هذه الحدود، في كل حلم بالوحدة. هذه المرارة، رغم قسوتها، هي التي شكّلت الوعي الكوردي، ودفعته نحو “الولادة المتجددة”، ولادة لإرادة لا تُكسر، لروح ترفض أن تُمحى، حتى في وجه أعظم الخيانات.
اتفاقية سايكس بيكو، مع إلغاء سيفر وتكريس لوزان، ليست مجرد أحداث تاريخية، بل هي جروح ميتافيزيقية، كما يمكن أن يراها هايدغر، حيث تُقطّع الكينونة وتُبعثرها عبر حدود مصطنعة. يقول هايدغر إن “الكينونة تتجلى في العلاقة مع العالم”، لكن عندما يُقسم العالم نفسه، ويُنكر وجود شعب، يصبح الوجود مشوهًا، محكومًا بالاغتراب. هذا الاغتراب الذي عاشه الكورد هو تجسيد لما يسميه سارتر “الوجود للآخر”، حيث يُعرّف الإنسان من خلال نظرة الدول الكبرى القامعة. لكن، كما يؤكد سارتر، فإن الحرية تكمن في رفض هذا التعريف، وهذا الرفض تجسد في كل صرخة كوردية ضد الظلم، في كل تمرد ضد الحدود المفروضة. يقول نيتشه إن “الإنسان الأعلى” هو من يتجاوز آلامه، وفي هذا السياق، كان الكورد يتجاوزون خيانة سيفر ولوزان من خلال إصرارهم على الحلم بالوحدة، على التمسك بالهوية. يقول كامو إن “التمرد هو إعلان عن قيمة الإنسان”، وهنا كان التمرد الكوردي ضد إرث هذه المعاهدات إعلانًا عن قيمة وجودهم، عن أحقيتهم في الحرية. يقول فرانكل إن “المعنى يمكن أن يُوجد في المعاناة”، وفي هذه الحالة، كان المعنى يكمن في البحث عن وطن موحد، في الإيمان بأن الروح يمكن أن تلتئم رغم التقسيم. يضيف كيركغور أن “الإيمان هو الشغف بالممكن”، وفي هذه المرارة، كان الإيمان الكوردي بالممكن، بحلم العدالة، هو ما أعطى لـ”الولادة المتجددة” بعدها الميتافيزيقي. هذه الخيانات، من سيفر إلى لوزان، كشفت عن بشاعة العالم، لكنها أيضًا أيقظت وعيًا كورديًا، وعيًا بأن الوجود لا يُمنح من الدول الكبرى، بل يُصنع بالدم والإرادة، في تحدٍ أبدي للظلم والبشاعة.
بين التواطؤ الدولي والصمت الإقليمي: أسئلة عن الضمير الكوني
في عالمٍ يدّعي الحضارة والعدالة، ويُرفع فيه شعار حقوق الإنسان، تظل بعض المآسي حبيسة الصمت، وبعض الشعوب تُترك لمصيرها، وكأنها غير موجودة على خارطة الضمير الكوني. فهل الصمت تواطؤ؟ وهل غياب الفعل هو شكل آخر من أشكال القتل؟ وكما قال الكاتب الروماني إيلي ويزل: “الصمت في وجه الشر هو بحد ذاته شر: فالرب لا يصمت، ويجب ألا نصمت نحن”. في رحلتنا الطويلة مع الألم، كانت “الولادة المتجددة” للشك في هذا الضمير الكوني هي الأشد قسوة.
بعد الانتفاضة الكبرى عام 1991، وبعد النزوح المليوني الذي شهدته الجبال والحدود، حيث مات الآلاف من البرد والجوع والمرض، كان العالم يراقب بصمتٍ مريب. المجتمع الدولي، الذي كان قد تدخل لإنقاذ الكويت، ترك شعب كوردستان يواجه مصيرًا مجهولًا تحت قصف الطائرات والمدافع. لم تُرفع أصوات الإدانة بقوة، ولم تُقدم المساعدات الإنسانية الكافية، وكأن دم الكوردي أقل قيمة من دماء الآخرين. هذا التواطؤ الدولي الصامت، أو ما يُسمى “الصمت العظيم”، كان بمثابة حكمٍ بالإعدام على أرواحٍ بريئة، وإعلان عن أن مصالح الدول تتفوق على القيم الإنسانية.
هذا الصمت لم يكن فقط على المستوى الدولي، بل على المستوى الإقليمي أيضًا. فالدول المجاورة، التي كانت ترى في معاناة الكورد فرصة لتعزيز نفوذها أو لتحقيق أجنداتها الخاصة، لم تُقدم الدعم الكافي، بل بعضها، كما ذكرنا سابقاً، مارست التمييز والعنصرية، وزادت من معاناة اللاجئين. لم تكن هناك إرادة إقليمية لإنقاذ شعب يُذبح على مرأى ومسمع الجميع، بل كان هناك تفضيل للمصالح الجيوسياسية على حساب الأرواح البشرية.
هذا التواطؤ والصمت يطرح أسئلة وجودية عميقة عن الضمير الكوني: هل الإنسانية مجرد شعار أجوف يُرفع في المحافل الدولية، بينما تُمتهن كرامة الإنسان على أرض الواقع؟ هل قيمة الوجود تُحددها قوة الدول، أم أنها قيمة مطلقة لكل كائن بشري؟ هل يمكن لضمير العالم أن ينام مطمئنًا بينما يُقتل الأطفال وتُهدم القرى وتُطارد الشعوب؟ هذه الأسئلة تُعيد “ولادة جديدة” للشك في مفهوم العدالة العالمية، وتُرسخ في وعينا أن خلاصنا لن يأتي إلا من أنفسنا، وأن الوجود الحقيقي يُصنع بالصمود والإيمان بالذات، لا بالاعتماد على ضمير عالمي لا يتحرك إلا بالمصالح. إنها “ولادة للوعي بالاستقلالية الوجودية“.
الصمت الدولي والإقليمي إزاء مأساة الكورد هو تجسيد لما يسميه سارتر “سوء النية”، حيث يتجنب العالم مسؤوليته الأخلاقية بدعوى المصالح. هذا الصمت ليس مجرد غياب صوت، بل هو فعل وجودي يُسهم في إدامة المعاناة، كما يقول إيلي ويزل. يقول هايدغر إن “الكينونة تتطلب المواجهة مع العدم”، وفي هذا الصمت، كان العدم يتجلى في تجاهل العالم لأرواح الكورد، لكنه أيضًا أثار وعيًا جديدًا، وعيًا بالاستقلالية الوجودية. يقول كامو إن “التمرد هو إعلان عن الكرامة”، وهنا كان تمرد الكورد ضد هذا الصمت يتجسد في صمودهم، في إيمانهم بأن خلاصهم لن يأتي من الخارج. يقول نيتشه إن “الإنسان يجب أن يخلق قيمه الخاصة”، وفي هذه المأساة، كان الكورد يخلقون قيمهم من خلال الإصرار على الحياة، على الكرامة، رغم تواطؤ العالم. يقول فرانكل إن “المعنى يمكن أن يُوجد في أحلك الظروف”، وهنا كان المعنى يكمن في الإيمان بالذات، في الوعي بأن الوجود الكوردي لا يعتمد على اعتراف العالم، بل على إرادته الداخلية. يضيف كيركغور أن “القلق هو بوابة الإيمان”، وفي هذا الشك في الضمير الكوني، كان الكورد يقفزون قفزة إيمانية، إيمانًا بأن “الولادة المتجددة” ليست مجرد رد فعل على الصمت، بل هي إعلان عن قوة الروح التي تصنع مصيرها بنفسها، تتحدى العدم وتؤكد على وجودها في وجه كل التواطؤ.
العودة إلى الوطن: حماية وبناء… وتحديات الوجود الجديد
بعد طول غياب، وبعد رحلة شاقة عبر جبال الألم ومخيمات اليأس، بدأت إشراقة أمل تلوح في الأفق: العودة إلى الوطن. لم تكن هذه العودة مجرد حركة جسدية، بل كانت “ولادة متجددة” لأملٍ طال انتظاره، وعودة إلى جوهر الوجود ذاته. فهل يمكن للأرض أن تُحيي الأرواح المنهكة؟ وهل يُمكن للأمل أن ينمو في تربةٍ مُروّاة بالدم؟ كما قال الروائي الروسي ليو تولستوي: “السعادة ليست أن تفعل ما تحب، بل أن تحب ما تفعل”. وفي حب الوطن، تجد الأرواح المنهكة سعادة لا تُضاهى.
بعد أن تدخلت بعض القوى الدولية المتأخرة، وإعلان مناطق الحظر الجوي في شمال العراق (المنطقة الآمنة) في نيسان 1991، بدأت موجات العودة تتشكل. لقد كان قرارًا متأخرًا، لكنه أنقذ ما يُمكن إنقاذه من أرواح. عادت الملايين من اللاجئين إلى قراهم ومدنهم، التي كانت قد تحولت إلى أطلال. هذه العودة لم تكن سهلة، فالبنى التحتية كانت مدمرة بالكامل، والبيوت محروقة، والأراضي مزروعة بالألغام، والمستقبل مجهول. لكن في عيون العائدين، كانت هناك شرارة أمل، إيمان بأن الوطن يستحق كل هذا العناء.
بدأت عملية البناء من الصفر. الأيادي التي كانت بالأمس تحمل السلاح للدفاع عن الوجود، أصبحت اليوم تحمل معاول البناء لتعيد تشييد البيوت والمدارس والمستشفيات. كان الأطفال يشاركون في هذه العملية، ينقلون الحجارة الصغيرة، ويراقبون آباءهم وهم يبنون مستقبلهم بأيديهم. كانت هذه اللحظات تجسيدًا حقيقيًا لـ”الولادة المتجددة”، ليس فقط للبيوت والمدن، بل لروح المجتمع نفسه، روح ترفض اليأس وتصر على الحياة.
لكن تحديات الوجود الجديد لم تكن سهلة. فالحصار الاقتصادي المفروض على العراق، والصراعات السياسية الداخلية، ونقص الموارد، كلها كانت تُلقي بظلالها على عملية البناء. كانت هناك حاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي، لا مجرد إعلانات جوفاء. كان الشعب يعيش في حالة دائمة من التحدي، يبني بيد، ويقاوم بيد أخرى. لقد كانت تجربة مُرهقة، لكنها كانت تُعلمنا معنى الصمود الحقيقي، ومعنى الانتماء العميق إلى الأرض.
هذه العودة إلى الوطن، بكل ما حملته من آمال وتحديات، هي فصل جديد في سيرة الاغتراب. إنها تؤكد أن الوطن ليس مجرد مكان نولد فيه، بل هو مكان نصنعه بأيدينا، مكان نرويه بدموعنا وعرقنا وأملنا الذي لا يموت. إنها “ولادة ثامنة” للوطن من رحم الدمار، وللإنسان من رحم اليأس، تؤكد أن الوجود الحقيقي يكمن في القدرة على البناء، حتى في أقصى الظروف، وأن الأمل هو المحرك الدائم لـ”الولادات المتتالية” التي لا تتوقف.
العودة إلى الوطن هي أكثر من مجرد حركة جغرافية؛ إنها ولادة ميتافيزيقية، كما يمكن أن يراها هايدغر، حيث يعود الإنسان إلى “الكينونة في العالم”، إلى الأرض التي تُعطي لوجوده معنى. يقول هايدغر إن “السكن هو طريقة الإنسان في الكينونة”، وفي هذه العودة، كان الكورد يعيدون بناء ليس فقط بيوتهم، بل طريقتهم في الوجود، في السكن على أرضهم رغم الدمار. يقول سارتر إن “الإنسان يصنع ذاته من خلال أفعاله”، وهنا كان كل حجر يُوضع، كل مدرسة تُبنى، فعلًا يُعرّف الذات الكوردية، يؤكد على حريتها في تشكيل مصيرها. يقول نيتشه إن “الإنسان الأعلى” هو من يخلق قيمه في مواجهة الفوضى، وفي هذه الأطلال، كان الكورد يخلقون قيم الصمود، الأمل، والانتماء. يقول كامو إن “التمرد هو إعلان عن الحياة”، وهذه العودة كانت تمردًا ضد اليأس، ضد الحصار، ضد المجهول. يقول فرانكل إن “المعنى يمكن أن يُوجد في العمل الخلاق”، وفي هذه العملية، كان بناء الوطن عملًا خلاقًا، يُعطي للمعاناة هدفًا، يحول الدمار إلى بذرة للمستقبل. يضيف كيركغور أن “الإيمان هو مواجهة المستحيل”، وفي هذه العودة، كان الإيمان بالوطن، بالمستقبل، قفزة نحو المستحيل، ولادة لروح ترفض أن تُهزم، تؤكد أن “الولادة الثامنة” ليست مجرد استعادة للمكان، بل هي إعادة خلق للذات، للمجتمع، للوجود الكوردي بأسره.
لحظة التصويت: صدى الألم ووميض الأمل
في رحلة الشعوب نحو تقرير المصير، تأتي لحظات قليلة تُكثّف فيها قرون من الألم وتلخص آمال أجيالٍ كاملة. لحظة التصويت هي إحدى هذه اللحظات، فهي ليست مجرد فعل سياسي، بل هي تجلٍّ وجودي، إعلانٌ عن “ولادة جديدة” لإرادة شعبية تتجاوز القمع إلى فضاء الديمقراطية. فهل يمكن لصوتٍ واحدٍ، لقطرة حبرٍ على ورقة، أن تُغير مجرى التاريخ؟ وكما قال الروائي الإنجليزي جورج أورويل: “في زمن الخداع الشامل، قول الحقيقة هو عمل ثوري”. وهنا، كان التصويت هو الحقيقة المطلقة التي نطق بها شعبنا.
في عام 1992، بعد عام واحد فقط من الانتفاضة والعودة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة والدمار الذي لحق بالبلاد، أُجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. كانت هذه الانتخابات حدثًا غير مسبوق، لم يشهد له تاريخنا مثيلاً. كانت لحظة تاريخية، تجاوزت كل التوقعات، حيث اصطفّ الشعب الكوردي، نساءً ورجالاً، شيوخًا وأطفالًا، في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع، حاملين في قلوبهم أحلامًا لم يُسمح لهم بها من قبل. كنتُ هناك، أقف في الطابور الطويل، وأرى في عيون الناس مزيجًا من الترقب والأمل، مزيجًا من الخوف من الماضي الذي لا يزال يُطاردنا، والفرح بمستقبلٍ نخطّه بأيدينا.
لقد كانت كل بصمة إصبع على ورقة الاقتراع بمثابة توقيع على عقدٍ جديد مع الوجود، توقيع يُعلن عن حقنا في تقرير مصيرنا، في بناء مستقبلنا بأنفسنا. لم تكن مجرد انتخابات، بل كانت طقسًا مقدسًا، احتفالًا بالوجود الذي انتُزع من بين أنياب الموت. في كل صوت، كان هناك صدى لصرخات الشهداء، وهمسات الأمهات الثكلى، وأنين الأطفال الذين ماتوا جوعًا. كانت هذه الأصوات ترتفع إلى السماء، تُعلن أن تضحياتهم لم تذهب سدى، وأن دمائهم روت شجرة الحرية، لتُثمر هذه “الولادة الديمقراطية“.
بالنسبة لي، كانت لحظة التصويت هذه بمثابة “ولادة تاسعة”، ولادة للذات السياسية التي تدرك أن وجودها ليس منفصلاً عن وجود شعبها. لقد شعرت بأنني جزء من كيان أكبر، جزء من حلمٍ جماعي يتجسد في صناديق الاقتراع. كانت هذه اللحظة تُعلمنا أن الحرية ليست مجرد غياب للقمع، بل هي قدرة على الاختيار، على تحديد مصيرنا بأنفسنا، وأن الديمقراطية ليست مجرد نظام حكم، بل هي فلسفة حياة، تُمكن الإنسان من أن يكون فاعلًا في تاريخه، لا مجرد متفرج.
لكن الفرحة لم تكن كاملة، فظل شبح الماضي يُطاردنا. الأراضي المتنازع عليها، مثل كركوك وخانقين وسنجار، ظلت خارج السيطرة الكوردية، وهذا كان تذكيرًا مؤلمًا بأن “الولادة” الديمقراطية هذه ما زالت ناقصة، وأن الوطن ما زال مُجزّأ. لكن حتى في هذا النقص، كان هناك أمل، أمل في أن يأتي يومٌ يُكتمل فيه حلم الوطن، وتتحقق فيه الولادة الكاملة للوجود الكوردي. هذه اللحظة، بكل ما حملته من ألم وأمل، كانت شاهدًا على أن إرادة الشعب هي القوة الحقيقية التي تُشكل التاريخ، وأن كل صوت، مهما كان خافتًا، يمكن أن يُحدث فرقًا، ويُسهم في “الولادة المتجددة” للوطن.
فلسفة اللحظة:
في أعماق كل تجربة بشرية، تكمن “فلسفة اللحظة”، تلك الفلسفة التي لا تُكتب في الكتب، بل تُعاش بالدم والروح. إنها تلك اللحظات الفاصلة التي تُعيد تعريف الوجود، وتُغير مسار القدر. فهل اللحظة مجرد نقطة في الزمن، أم أنها وعاءٌ يحوي أبعادًا لا نهائية من المعنى؟ وكما قال مارتن بوبر: “الحياة الحقيقية هي اللقاء”. وفي لحظات اللقاء هذه مع الألم، مع الحرية، مع الاغتراب، ومع الولادة المتجددة، تتجلى حقيقة الوجود.
في سيرة الاغتراب التي أعيشها، تتشكل “فلسفة اللحظة” من تراكُم الولادات المتجددة. الولادة الجسدية من رحم الأم، ثم الولادة الواعية في ظلمة السجن، ثم الولادة الجمعية مع الانتفاضة، فولادة الذات المقاوِمة في قتال البيشمركة، ثم ولادة الوعي بالوحدة في معركة كۆڕێ، فولادة الصمود في النزوح المليوني، ثم ولادة الأمل في العودة والبناء، وأخيرًا، ولادة الذات السياسية في لحظة التصويت. كل هذه الولادات ليست مجرد أحداث متسلسلة، بل هي طبقات من الوعي تتراكم، تُشكل جوهر “الولادة الأبدية” للذات التي ترفض الفناء.
إن “فلسفة اللحظة” تعلمنا أن المعاناة ليست نهاية، بل هي بوابة نحو فهم أعمق للوجود. الألم يُصبح معلمًا، واليأس يتحول إلى وقود للأمل، والفقدان يُصبح دافعًا للبحث عن المعنى. في كل لحظة قاسية، هناك فرصة للنمو، للتحول، لـ”ولادة جديدة” للروح. هذا لا يعني أننا نُمجّد الألم، بل نُدرك أن الحياة، بكل تناقضاتها، تُقدم لنا فرصًا لا نهاية لها لإعادة تعريف أنفسنا، وللتعبير عن إرادتنا الحرة في وجه كل القيود.
هذه الفلسفة تعلمنا أيضًا أن الوجود ليس ثابتًا، بل هو ديناميكي، يتجدد مع كل تحدٍّ جديد. نحن لا نولد مرة واحدة فحسب، بل نُولد مرارًا وتكرارًا، في كل مرة نُجبر فيها على مواجهة المجهول، على التخلي عن المألوف، وعلى البحث عن معنى جديد للحياة. إنها رحلة مستمرة من التحولات، من الموت الرمزي والبعث الدائم، حيث تتشكل الروح وتُصقل، لتصبح أكثر قوة، وأكثر وعيًا بحدودها اللانهائية.
إنها “فلسفة اللحظة” التي تُدرك أن الحاضر هو كل ما نملك، وأن المستقبل يُصنع من خلال اختياراتنا في اللحظة الراهنة. لا يمكننا تغيير الماضي، لكن يمكننا أن نُعيد تفسيره، وأن نُحول الألم الذي عشناه إلى قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا. هذه الفلسفة تُعيد “ولادة” الأمل في كل قلب يائس، وتُعلن أن الإرادة الحرة هي المفتاح الحقيقي للتحرر، وأن الوجود ليس مجرد قدر، بل هو مسارٌ نصنعه بأنفسنا، في كل لحظة من لحظات حياتنا.
خاتمة الفصل: الانتفاضة كإجابة حية لشعب كوردستان
في ختام هذا الفصل، الذي حاول أن يحفر في ذاكرة الألم والأمل، يتبين لنا أن الانتفاضة الكبرى عام 1991 لم تكن مجرد حدث تاريخي عابر، بل كانت “إجابة حية” لشعبٍ أُقنِع طويلاً بعبثية وجوده. لم تكن مجرد ثورة سياسية، بل كانت تجليًا وجوديًا، إعلانًا صريحًا عن حقنا في الحياة والكرامة، و”ولادة متجددة” لإرادة شعبية لا تعرف الانكسار.
لقد عاش الكورد قرونًا طويلة تحت وطأة الظلم والقمع والتمييز، مُجزّئين بين دول لا تعترف بوجودهم. لقد ذاقوا مرارة الأنفال وحلبجة، وتيهوا في جحيم المخيمات، لكنهم لم يستسلموا للعدمية التي حاولت أن تبتلع أرواحهم. الانتفاضة كانت صرخة جماعية، صرخةٌ تجاوزت الألم لتُعلن عن قوة الروح، عن قدرة الإنسان على الصمود في وجه أقسى الظروف. كانت بمثابة إجابة على سؤال الوجود الأعمق: كيف يمكن لروح أن تبقى حية حين يُحرم منها كل شيء؟ الإجابة كانت في فعل الثورة ذاته، في إصرارنا على البقاء، على البناء، وعلى استعادة المعنى.
إن هذه الانتفاضة لم تكن نهاية المطاف، بل كانت بداية لفصول جديدة من الصراع والتحديات. لقد ولدت لنا وطنًا محررًا، لكنه وطنٌ ما زال يواجه تحديات داخلية وخارجية. لقد منحتنا فرصة لبناء مستقبلنا بأنفسنا، لكنها فرضت علينا مسؤوليات جسيمة. إنها “ولادة مستمرة” لمشروع وطني لا يتوقف، مشروع يهدف إلى تحقيق الولادة الكاملة لوجودنا الحر والكريم.
هذا الفصل، بكل ما فيه من آلام وآمال، هو شهادة حية على أن الذاكرة لا تموت، وأن الأمل يتجدد، وأن الوجود ليس قدرًا مفروضًا، بل هو اختيار يومي، فعل مستمر من المقاومة والبناء. إنه دعوة لكل من يقرأ هذا الكتاب أن يؤمن بقوة الروح البشرية، وبقدرتها على تجاوز الظلام نحو النور، حتى لو كانت هذه الرحلة محفوفة بالصعاب والاغتراب.
خاتمة: في مرآة الروح – شفق الحرية وفجر الاغتراب
تلك الرياح التي عصفت بقلوبنا في “الفجر الدامي”، لم تكن مجرد نُذر ثورة عسكرية أو تحرر سياسي. كانت، في جوهرها العميق، إيقاظًا ميتافيزيقيًا لروحٍ أُقنِعت طويلاً بعبثية وجودها. لقد انتفضنا من رماد الأنفال وحلبجة، لا كضحايا فحسب، بل كفاعلٍ تاريخي، حُطّم قيد الصمت بسيف الصرخة. كل زقاق في أربيل ودهوك، كل جبل في السليمانية، شهد على ميلاد وعيٍ جماعيٍّ جديد، وعيٍ لم يأتِ من كتب الفلسفة، بل من لحمٍ ودمٍ وروعة الألم. كنا نلمس الحرية بأيدينا المرتعشة، لا كفكرة مجردة، بل كحقيقة ملموسة، كالماء البارد بعد ظمأٍ سرمدي. كان هذا هو الانتصار الأعظم: انتصار الروح على محاولات التذويب، انتصار الذاكرة على طمس التاريخ، وهو ما أعتبره “ولادة رابعة” للوعي الجمعي المتجدد الذي يرفض الفناء.
لقد كانت لحظة التصويت، تلك اليد الممدودة نحو صندوق الاقتراع، أكثر من مجرد فعل سياسي؛ كانت طقسًا وجوديًا، ولادة خامسة لروحٍ تمردت على الموت البطيء. في كل بصمة إصبع، كان هناك صوت شهيد يُبعث من قبر جماعي، وهمسُ أمٍّ ثكلى تُعلن أن ألمها لم يذهب سدى. لقد تحول الكوردي من “مفعول به” في معادلة القهر إلى “فاعل” يكتب بدموعه وقلمه دستور وجوده. هذه ليست مجرد حكاية شعبٍ ناضل، بل هي ملحمة “كايزن” على المستوى الوجودي: كيف يمكن للبشر، في أقسى الظروف، أن يجدوا معنىً، أن يخلقوا نظاماً من الفوضى، وأن يزرعوا بذور العدالة في تربة مُروّاة بالظلم؟ لقد كانت تلك هي اللحظة التي أثبتنا فيها، ليس للعالم فحسب، بل لأنفسنا قبل كل شيء، أننا كائنات قادرة على تجاوز الألم، على صناعة المعنى، وعلى بناء مستقبل لا ينبثق فقط من الرغبة، بل من ضرورة بقاء الروح، وكأننا نُجادل الفلسفة العدمية بفعلنا الحي، مؤكدين أن الوجود هو اختيار لا حتمية.
لكن ما قيمة الحرية إن كانت أسوارها خفية، وأغلالها تُصاغ من ضرورات البقاء؟ فبينما كنا نُشيّد برلماننا الأول، ونبني حكومة وليدة من رحم الانتخابات الديمقراطية – وهي خطوة لم يشهدها تاريخنا المكتوب من قبل – كانت رياح الواقع تهبّ بعنف، حاملة معها غبار الحصار والفقر. إنها المفارقة الوجودية الكبرى: أن تُكافح لتنال حريتك، ثم تجد أن هذه الحرية نفسها تُكبّلها قيود اقتصادية واجتماعية أكثر خفاءً وأشد وطأة من السلاسل الظاهرة. كان الوطن الذي حلمنا به “مُنهكًا حتى العظم”، كجسدٍ أرهقته الحمى، ما زال يئن من جراحٍ لم تلتئم، وحصارٌ لم يُرفع. هنا قد يُجادل البعض بأن “الوجود” في الحرية المادية قد يكون كافيًا، لكن تجربتنا تقول إن “الماهية” الحقيقية، أي معنى وكيفية هذا الوجود، تظل مهددة ما دامت الظروف القاسية تُجبرنا على خيارات لا نرغبها.
هنا تتجلى حقيقة ما قاله جان بول سارتر: “الوجود يسبق الماهية”. لقد وُجدنا ككورد، حُررنا، أقمنا مؤسساتنا. لكن ماهيتنا – كيف سنكون، وكيف سنعيش – كانت تتشكل في سياقٍ قاسٍ، دفعنا إلى سؤالٍ وجودي جديد: هل يمكن للروح أن تزدهر في جسدٍ مُعذّب، وهل يمكن للحرية أن تتحقق في فقرٍ مدقع؟ كانت هذه التحديات، على قسوتها، هي التي دفعت بفعل “الاغتراب” نحو فضاءٍ آخر. فالهجرة التي بدأت كـ “نزيف للأرواح”، لم تكن مجرد هروب من الفقر، بل كانت بحثًا عن معنى، عن كرامة، عن فضاءٍ تُستكمل فيه الولادة الخامسة التي بدأناها، أي ولادة الماهية التي نبحث عنها، والتي تُدشن “ولادة سادسة” للذات في عالم جديد. قد يقول البعض إنها مجرد هروب، لكننا نراها كفعل وجودي: إعادة تعريف الذات في مواجهة واقع لا يمنحنا فرصة العيش بكرامة على أرضنا.
وكيف يمكن للإنسان أن يجد وطنه في عالمٍ يرفضه؟ هذا السؤال تجسد في لحظات العبور الأولى نحو المنفى، عندما غادرتُ كوردستان عبر طرق غير شرعية، متسللاً بين جبالها الشامخة، حيث كانت الحدود بين كوردستان المقسمة وتركيا ليست مجرد خطوط، بل جروحاً نازفة في جسد الأمة. في منطقة “جل ميرك”، حيث اشتعلت نيران المعارك الدامية بين المعارضة الكوردستانية والجيش التركي، بدأ الاغتراب الحقيقي. لم يكن الاغتراب مجرد فراق للأرض، بل كان انقطاعاً ميتافيزيقياً عن الذات، عن الوطن الذي كان ينبض في قلبي كجزء من كينونتي. تلك الجبال، التي كانت يوماً ملجأً لأحلامنا، تحولت إلى ساحة صراع، حيث كل رصاصة كانت صرخة ضد النسيان، وكل انفجار كان تأكيداً على أن الوجود الكوردي لن يُمحى. لكن في تلك اللحظات، وسط دوي الحرب، أدركتُ أن المنفى ليس مجرد مكان، بل حالة وجودية، رحلة داخلية تبدأ عندما تُجبر على التخلي عن جزء من روحك لتبقى حياً. كان عبور الحدود، تحت وطأة الرصاص وهدير المدافع، بمثابة “ولادة سابعة”، ولادة الذات التي تُعيد تعريف نفسها في مواجهة العدم، حاملة معها ذكريات الوطن كشعلةٍ لا تنطفئ، لكنها مضطرة للبحث عن معنى جديد في أرض غريبة.
هذا العبور لم يكن مجرد هروب من الموت، بل كان تمرداً على العبثية، كما يقول كامو، حيث يصبح الفعل نفسه، فعل الرحيل، تأكيداً على قيمة الحياة. في جل ميرك، بينما كنت أختبئ خلف صخرة باردة، محاطاً بنيران المعركة، شعرتُ بأنني أحمل كوردستان في قلبي، ليس كأرض فحسب، بل كفكرة، كإرادة لا تلين. كل خطوة كانت اختباراً للروح، كأن الجبال نفسها تسألني: “هل تستحق الحرية؟ هل تستحق أن تحمل اسم شعبك في المنفى؟” وكان جوابي في كل نفس أتنفسه، في كل لحظة أقاوم فيها اليأس: “نعم، لأن الوجود الكوردي هو مقاومة، ولأن المنفى ليس نهاية، بل بداية لصراع جديد.” هذا الصراع، الذي بدأ في جل ميرك، كان بمثابة إعلان ميتافيزيقي: الوطن ليس مجرد تراب، بل هو الروح التي تحمل ذكريات الشعب وأحلامه، وهذه الروح لا يمكن أن تُسجن بحدود أو تُمحى بنيران الحرب.
في تلك اللحظات، تذكرتُ كلام كيركغور عن “قفزة الإيمان”، حيث يصبح الإنسان، في مواجهة المجهول، مضطراً للقفز نحو الإيمان بذاته، بقدرته على التجدد. عبور الحدود كان قفزة إيمان، ليس بالوطن فحسب، بل بالذات التي ترفض أن تنكسر. لكن هذه القفزة لم تكن خالية من القلق الوجودي، ذلك القلق الذي ينشأ عندما تدرك أنك أصبحت غريباً في عالم لا يعرفك. ومع ذلك، كان هذا القلق نفسه وقوداً للإرادة، دافعاً للبحث عن معنى في المنفى. يقول فرانكل إن المعاناة تصبح محتملة عندما يكون لها هدف، وفي جل ميرك، كان الهدف هو البقاء، ليس كفرد فحسب، بل كحامل لروح شعب يرفض العدم. هذه “الولادة السابعة” لم تكن نهاية الرحلة، بل كانت بداية لرحلة أعمق، رحلة البحث عن الماهية في فضاء المنفى، حيث يُعاد تشكيل الذات والوطن في مواجهة الغربة.
كيف يمكن للإنسان أن يجد وطنه في عالمٍ يرفضه؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي ستُجيب عنه الفصول القادمة من هذه السيرة. إنها الفصول التي تتحدث عن “الولادة السابعة”، الولادة من رحم المنفى. لم يكن الانتقال من كوردستان إلى تركيا، ثم إلى أستراليا، مجرد رحلة جغرافية؛ لقد كان عبورًا وجوديًا من عالمٍ مُعلّق بين التحرير والدمار، إلى عوالم جديدة ستُعيد تشكيل مفهوم الذات والوطن. ستُخبرنا الفصول القادمة عن طبيعة هذا المنفى الروحي والمادي، عن الوجوه التي سنلتقيها، عن اللغات التي ستُحيط بنا، وعن الثقافات التي ستُعيد تشكيل نظرتنا للعالم. ففي المنفى، يولد الإنسان مرة أخرى، ولكن هذه المرة في فضاء مفتوح، حيث تتفاعل هويته مع هويات أخرى، ليتساءل: هل الهوية شيء ثابت، أم أنها تتجدد مع كل ولادة جديدة؟ هل هي تتلاشى أم تتصلب؟ وكما قال أحدهم، وصدّقت هذه التجربة قولته: “الغربة ليست فراق الأوطان، بل فراق الأرواح”. وها نحن نجد أنفسنا في غربةٍ مزدوجة: غربة عن الوطن الذي ما زال يتشكل، وغربة في أوطانٍ جديدة لا تعرف حقيقة ماضينا، مما يدفعنا نحو “ولادة ثامنة” تتجاوز مفهوم الوطن الجغرافي.
لقد كانت الفصول الماضية حكاية الصراع من أجل الوجود والحرية المادية؛ أما الفصول القادمة، فستكون حفريات في جسد المنفى، بحثًا عن “الماهية” في زمنٍ جديد، ومحاولة لتعريف “الوطن” خارج حدود الجغرافيا. إنها رحلة في عالمٍ سيتسع فيه الفضاء لكنه قد يضيق على الروح، مما يستدعي “ولادة تاسعة” للبحث عن السكينة الداخلية. سنرى كيف يتشكل الإنسان الكوردي في الغربة، هل ينصهر، أم يحتفظ بفرادته؟ هل تضعفه المسافات، أم تصقل إرادته؟ هذه الرحلة القادمة هي امتداد للبحث عن المعنى في عالمٍ لا يتوقف عن التغير. فإذا كانت الانتفاضة هي صرخة “أنا موجود”، فإن الاغتراب سيكون همسة “كيف أكون؟” في مساحةٍ لا تنتمي إليّ بالكامل. إنها قصة البحث عن البيت الذي ليس بالضرورة بناءً من حجر، بل هو حالة من السكينة الروحية، وشعور بالانتماء، حتى لو كانت أقدامنا تطأ أرضًا غريبة. وكما قال إدوارد سعيد: “كل المنفيين يعيشون على هامش وجودهم”. الفصول القادمة ستكون محاولة للعيش في هذا الهامش، ليس كضحية، بل ككيان فاعل يبحث عن معنى عميق لوجوده، عن وطنٍ يحمله في روحه أينما حلّ، مؤكداً على أن “الولادة المتجددة” هي سر بقاء الإنسان في وجه التيه والفناء، وصولاً إلى “ولادة عاشرة” للوطن الجديد في الروح.
إن هذه السيرة ليست مجرد قصة حياة؛ إنها قصة عن قدر الإنسان على التكيف، على الصمود، وعلى إيجاد المعنى في أكثر الظروف عبثية. إنها قصة عن الذاكرة التي ترفض النسيان، وعن الأمل الذي يتجدد في كل صباح، حتى في أبعد بقاع الأرض. فهل سنكتشف في الفصول القادمة أن الوطن الحقيقي ليس مجرد قطعة أرض، بل هو تلك المساحة المقدسة التي نبنيها داخلنا، حيث تلتقي جذورنا بتاريخنا، وحيث تُصاغ أحلامنا لمستقبل لا يعرف حدوداً؟ هذا ما سيكشفه مسار “سيرة الاغتراب: حفريات في جسد المنفى”، مسار يحفل بولادات متجددة للروح، تجعلها عصية على الفناء.
قائمة المراجع والهوامش:
[1] كارل ماركس، تاريخ جميع المجتمعات الموجودة حتى الآن هو تاريخ صراع الطبقات.
[2] جان بول سارتر، الصراع مع الآخر.
[3] ألبير كامو، التمرد هو رفض الموت.
[4] فريدريك نيتشه، الفوضى تولد النجوم.
[5] فيكتور فرانكل، فكرة فرانكل عن المعنى.
[6] مارتن هايدغر، الإنسان هو كائن يسأل عن الكينونة.
[7] ألبير كامو، إنّ أفضل طريقة للتعامل مع واقع لا يطاق هو أن ترفض قبوله.
[8] جان بول سارتر، الإنسان يُعرّف وجوده من خلال اختياراته.
[9] جان بول سارتر، الإنسان محكوم عليه بالحرية.
[10] فريدريك نيتشه، إرادة القوة.
[11] ألبير كامو، التمرد هو رفض قبول العبث.
[12] فيكتور فرانكل، المعنى يمكن أن يُوجد حتى في أقسى الظروف.
[13] مارتن هايدغر، الكينونة تتجلى في العناية.
[14] سورين كيركغور، الإيمان هو القفزة نحو المجهول.
[15] فيودور دوستويفسكي، إن مقياس الحضارة هو طريقة معاملتها لأطفالها.
[16] ألبير كامو، العبثية (عن عالم خالي من العدالة).
[17] فريدريك نيتشه، الألم هو المعلم الأعظم.
[18] فيكتور فرانكل، المعاناة تصبح محتملة عندما تكون ذات هدف.
[19] مارتن هايدغر، الكينونة تتجلى في العناية.
[20] جان بول سارتر، الحرية هي ما نفعله بما يُفعل بنا.
[21] سورين كيركغور، اليأس هو مرض الروح.
[22] ليو تولستوي، السعادة ليست أن تفعل ما تحب، بل أن تحب ما تفعل.
[23] مارتن هايدغر، السكن هو طريقة الإنسان في الكينونة.
[24] جان بول سارتر، الإنسان يصنع ذاته من خلال أفعاله.
[25] فريدريك نيتشه، الإنسان الأعلى (يخلق قيمه في مواجهة الفوضى).
[26] ألبير كامو، التمرد هو إعلان عن الحياة.
[27] فيكتور فرانكل، المعنى يمكن أن يُوجد في العمل الخلاق.
[28] سورين كيركغور، الإيمان هو مواجهة المستحيل.
[29] جاك دريدا، التفكيك يكشف عن البحث عن المعنى الكامن في النص.
[30] إيلي ويزل، الصمت في وجه الشر هو بحد ذاته شر: فالرب لا يصمت، ويجب ألا نصمت نحن.
[31] مارتن هايدغر، جروح ميتافيزيقية (تقطيع الكينونة).
[32] جان بول سارتر، الوجود للآخر (تعريف الإنسان من خلال نظرة الآخر).
[33] ألبير كامو، التمرد هو إعلان عن قيمة الإنسان.
[34] فيكتور فرانكل، المعنى يمكن أن يُوجد في المعاناة.
[35] سورين كيركغور، الإيمان هو الشغف بالممكن.
[36] إيلي ويزل، الصمت ليس مجرد غياب صوت، بل هو فعل وجودي يُسهم في إدامة المعاناة.
[37] مارتن هايدغر، الكينونة تتطلب المواجهة مع العدم.
[38] ألبير كامو، التمرد هو إعلان عن الكرامة.
[39] فريدريك نيتشه، الإنسان يجب أن يخلق قيمه الخاصة.
[40] فيكتور فرانكل، المعنى يمكن أن يُوجد في أحلك الظروف.
[41] سورين كيركغور، القلق هو بوابة الإيمان.
[42] إدوارد سعيد، كل المنفيين يعيشون على هامش وجودهم.








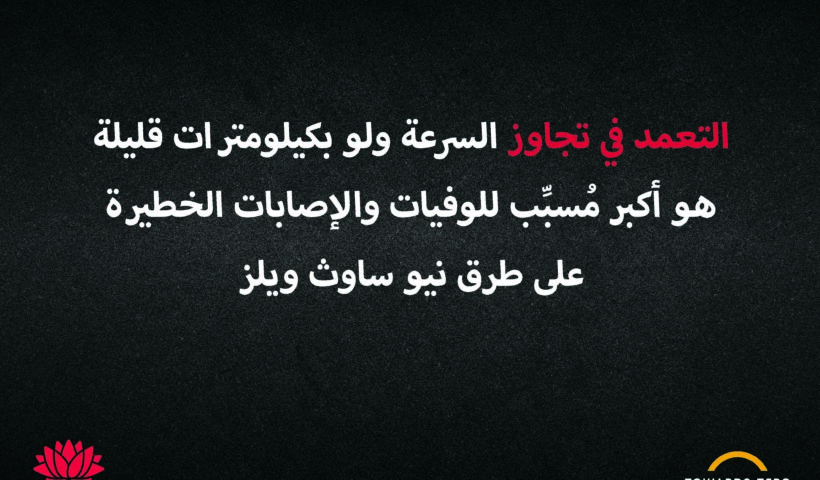



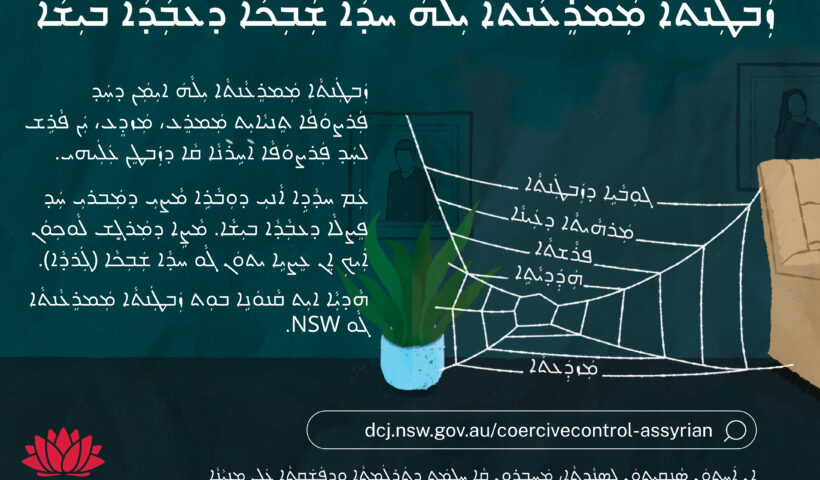




 Fairfield City Council Mayors Column
Fairfield City Council Mayors Column


