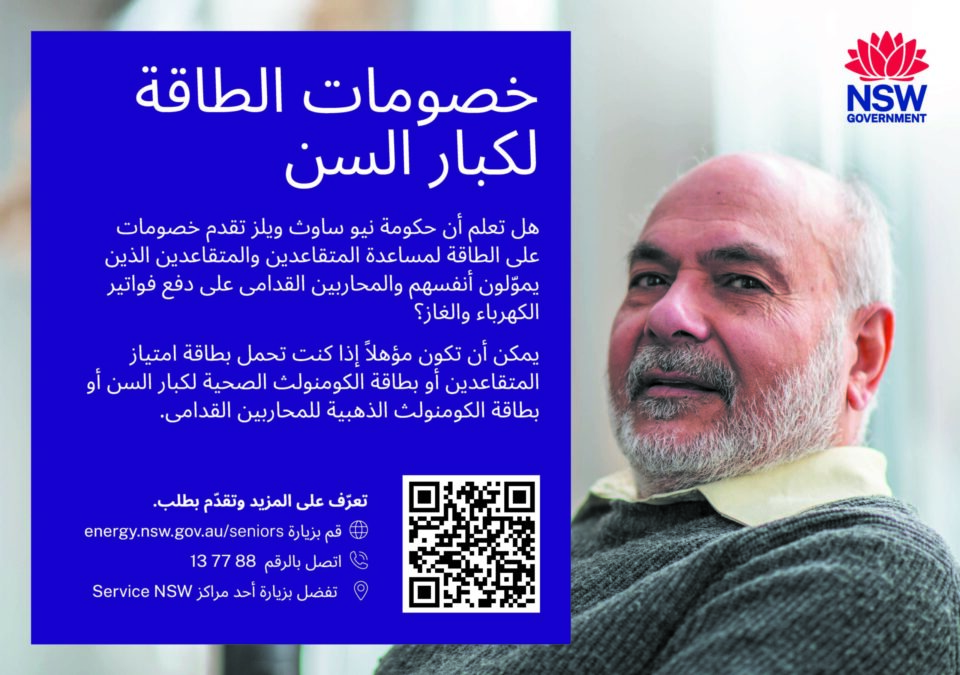سيرة الاغتراب: حفريات في جسد المنفى.-**”سيرة كوردي في زمن العدمية
> “هذا ليس مقالًا، بل نشيدٌ جنائزيٌّ للوطن الذي نحمله فينا، ونخاف أن يموت قبلنا.”
—
## البداية: سيرة التشظي
كُتبت هذه الكلمات بيدٍ ترتجفُ مِن سَكَرات الذاكرة، وقلبٍ ينزفُ كوردستانَ كلَّما همسَ له صوتٌ مِن شقلاوة.
ثلاثونَ عامًا وأنا أحفرُ في صخور المنفى، أبحثُ عن بصمةٍ لي في عالمٍ لا يعترفُ إلا بالغرباء.
وُلِدْتُ بين بساتين الكروم التي تُغنّي لأجدادي، وشبعتُ مِن رائحة الشاي التي كانت تُحمصُ على نار الحطب، حينما كان صوتُ حجر الرحى يُشبه أنشودةَ الخلود.
أكتبُ هذه السطورَ بيدٍ تترنحُ تحت وطأة ثلاثينَ عامًا مِن التشظِّي، وكأنما أحفرُ بأظافري في جدران الزمن.
وُلِدْتُ بين أحضان بساتين وجبال شقلاوة، حيث تُغنّي أشجارُ الجوز لحنًا قديمًا لكلِّ مَن يمرُّ بها، وتتنفَّسُ الأرضُ قصصَ الأجداد مع كلِّ نسيمٍ يعبرُ حقولَ القمح في “دشتي هولير” و”هرير”.
تنفَّستُ هواءَ هولير، المدينة التي لا تُشبه غيرَها، حيثُ تَعانَقَ عَرَقُ التاريخِ وَدَمُ الحُروبِ فوقَ مَقاهي الشّاي.
في قهوة “مَجكو” تحتَ ظلِّ القلعةِ التي وقَفَتْ في وَجهِ هولاكو، يَلُفُّ الدخانُ حِكاياتِ الأجدادِ كأشباحٍ تَتَهادى بَينَ الأكواب.
هذهِ القلعةُ التي تَحملُ تاجَ المَجدِ، تَخبئُ تحتَ أحجارِها دَمَ العُشّاقِ وَغُبارَ الثّورات.
وفي المئذنةِ العاليةِ، حيثُ كانَ الحاجُ لقلقُ يُنسّقُ هِجراتِه كسطورٍ مَنسيّةٍ في دَفتَرِ الزمنِ، صارَ عُشُّهُ التّذكاريُّ – بَعدَ رَحيلِه العَبثيّ – وَسماً أزرقَ على جَبينِ السّماءِ.”
—
## الفصل الأول: اغترابٌ وجوديٌّ
المنفى: موتٌ يوميٌّ في عالم مارتن هايدغر.
لم أكن أعلم أن الغربةَ ستكون جريمةً وجوديةً بهذا الوضوح.
كان هايدغر محقًّا حين وصف الاغترابَ كفقدانٍ للانتماء إلى «العالم-الحياة» (Lebenswelt، مصطلح إدموند هوسرل).
يقول الفيلسوف: “الوجود الإنساني هو وجودٌ مُلْقًى به في العالم”.
لكن ماذا لو كان «العالمُ الذي أُلْقِينا فيه» لا يتحدثُ بلغة القلبِ بل بلغة الأرقام؟
الغربة هنا ليست مجرد بُعدٍ جغرافيٍّ عن كوردستان، بل انفصامٌ عن “الذات” التي تشكَّلت في حضن الوطن.
الفيلسوف الوجودي سورين كيركغور يصف هذا الألم فيقول: “أعمق أشكال اليأس هو أن تفقدَ نفسك… وتدركَ أنك غريبٌ حتى عن ذاتك”.
في غربتي — فقدتُ نفسي، وفقدتُ الروابطَ التي تُعطي الحياةَ معنًى:
صوتَ الأمِّ في بساتين شقلاوة، ضحكةَ الإخوة والأصدقاء في سوق هولير القديم، حنانَ الأبِ وصراخَه، ضجيجَ الأطفال، غناءَ السكارى، دخانَ المطاعم، صوتَ “شالور” وماءَ “دنكارة”، حتى رائحةَ الترابِ بعد مطر كوردستان و أولادي وعائلتي وفوقَ هذا كلِّه، فقدتُ “نوروز” ونارَها الأزلية المقدسة.
قيل لي يومًا: “أعمقُ اليأس أن تفقدَ ذاتَك”.
لكنهم لم يخبروني أنَّ فقدانَ الذاتِ يبدأُ بفقدانِ رائحةِ خبزِ الأمِّ في الصباح.
الفيلسوف ألبير كامو يرى في الغربة تعبيرًا عن العبثية:
“الإنسانُ غريبٌ في كونٍ لا صوتَ له يردُّ على صراخه”.
يشير كامو إلى أن الجسدَ هو “الحقيقة الوحيدة المؤكدة” في مواجهة غياب المعنى.
لكن عبثيةَ كامو باردةٌ، أما غربتُنا فمحشوَّةٌ بذاكرةٍ دافئةٍ تزيدُ مِن قسوة الألم.
هنا، في ضواحي سيدني، صرتُ شبحًا بين لغتين: الكورديةُ تموتُ في حلقي مثل طائر ، والإنجليزيةُ جافةٌ لا تحملُ رائحةَ التينِ مِن بستان جدي.
«الوجودُ في العالم» كما وصفه هايدغر، لم يعد ممكنًا لي هنا.
تحوَّلَ المنفى مِن مجرَّد مسافةٍ جغرافيةٍ إلى انكسارٍ وجوديٍّ.
اللغةُ الكورديةُ تختنق في حلقي كطائر محبوس كلَّ يوم، فليس هناك مَن يسمعُها.
طقوسُ الصباحِ فقدت قداستها: قهوةٌ سريعةٌ مِن ماكينةٍ بدلًا مِن ذلك الطقسِ المقدَّس حيث كان أبي يعدُّها.
في أستراليا، حتى شايُ الصباحِ لا يُشبه شاي أمي في شقلاوة.. تلك التي كانت تُحمصُ على نار الحطب، وكُنا نسمعُ صوتَ رنين الاستكان كأنه أنشودةٌ للوطن.
الغربةُ هنا ليست نقصًا في المواطنة، بل هي اغترابٌ وجوديٌّ كما يعرفه هايدغر:
فقدانٌ للانتماء إلى «العالم-الحياة».
—
## الفصل الثاني: جسد المنفى
، في أرضٍ لا تعرفُ طعمَ الرمان الكورديِّ، أصابني السُّكَّري ..
الأطباءُ يقولون: “قلِّلْ مِن السكر”، لكنهم لا يفهمون أن المرضَ ليس جسديًّا فقط.
سُكَّري الروحِ أقسى من الجسد: عطشٌ إلى ترابٍ لم أعد أستطيعُ لمسَه. حتى ضغطُ الدمِّ يرتفعُ كلَّما سمعتُ نشيدًا وطنيًّا.
لأطباءُ يقولون إن السببَ وراثيٌّ، لكنني أعرفُ أن للاغترابِ يدًا في ذلك.
سُكَّري الروحِ فلا دواء له وهو أشدُّ قسوةً مِن سُكَّري الجسد.
إنه عطشٌ لا يُرْوَى، حنينٌ إلى ترابِ الوطنِ الذي لم أعد أستطيعُ لمسَه.
في المستشفيات الأسترالية، يعاملونني كآلةٍ مكسورةٍ: “مستوى السكر 250، خُذْ إبرةَ الأنسولين”!
لكنّ لا احد يستطيع ان يعالجُ ذلك الألمَ الذي ينخرُ روحي.
في عيادات سيدني، أتذكَّرُ مقولةً قديمة: “ذاكرةُ الوطنِ كندبةٍ في الجسد”.
نعم، كلُّ ندبةٍ في جسدي تُعيدُ رسمَ خريطةِ شقلاوة.
(غاستون باشلار: «ذاكرةُ الوطنِ كندبةٌ في الجسد»).
لكنني أرى أن المرضى في المنفى هو شاهد حي على جريمة الغربة”.
المرض الجسدي – كما أعانيه – يضاعف وحدة الروح.
الفيلسوف “فريدريك نيتشه” الذي عانى الأمراض طويلًا كتب كثيرا عن الامراض بمعنى ان:
“المرض يجعل العالم سجنًا، والجسد قضبانًا”.
لكنني أضيف: المرض في الغربة سجن بلا نوافذ لمحكوم بريء بالإعدام.
في كوردستان، كان المرضُ طقساً جماعياً، أمٌّ تضعُ يدها على جبين المريض، جاراتٌ يأتين بالحلوى، أصواتُ الدعاءِ تملأ الغرفة والمراقد تهتز.
### الفصل الثالث: خيانة الساسة الكورد.
لم أكن أعلم أن الخيانة ستأتي مِن الذين قاتلتُ مِن أجلهم.
أيها الزعماء الكورد بجميع ألوانكم وأصنافكم وانتماءاتكم، لقد نسيتُمونا! وطويتمونا في سجل النسيان!
لقد حوَّلتم دمَنا إلى عملةٍ في سوقِ النخاسةِ السياسية.
سُجِنتُ وعُمري ستةَ عشرَ عاماً ، وتعرَّضتُ للتعذيب لأنني رفضتُ أن أنكرَ هويتي… مثل آلافٍ مِن خيرة شباب قوميتي.
قدَّمتُ دَمي وحياتي لأجل قضية كوردستان، خَدمتُ ضمن صفوف البيشمركة… تَغَرَّبتُ… تاركًا وَطني وأهلي وحياتي.
ثلاثون عامًا وأنا أرى وجوهَكُم تُزيّنُ شاشاتِ الفضائيات… بينما عظامُ رفاقي تُزيّنُ المقابرَ والمنفى.
المفكر **”اللورد آكتون”** يقول: *«السُّلطة تُفْسِد… والسُّلطة المُطْلَقَة تُفْسِدُ بشكلٍ مُطْلَق»*.
قبل ثلاثون عاما وانا لوحدي في الغربة أسَّستُ أولَ صحيفةٍ كورديةٍ في أستراليا باسم “الكورد”، أطلقتُ أولَ إذاعةٍ كورديةٍ في جنوب أستراليا “صوت الكورد”.
وفي نيسان ، يوم سقوطِ صَنَمِ الطاغية ، أصدرتُ صحيفةَ “الفرات” بثلاث لغاتٍ (الكوردية، العربية، الإنجليزية)، لأُوثِّقَ أن الهويةَ لا تُقتَل، وأن كوردستانَ لا تُدفَنُ تحت أنقاض التاريخ.
منذ ثلاثون ربيعا وأنا أُمسكُ بِحرفٍ كورديٍّ أخضرَ في برية الغربة…
صحيفتان يولدان مِن دمي، وإذاعةٌ تَصُدحُ بصوتٍ يعبرُ المحيطات، ومقالاتٌ تُحوِّلُ آلامي إلى خريطةٍ للوجود.
كتبتُ عن البيشمركة و الشهداء والابطال و جبال زاغروس وسفين وخواكورك و عن كركوك وهي تُنزفُ دمَها الأسودَ في سجلات التاريخ…
عن رجالٍ رفعوا أسم كوردستانَ على أطراف الرماح، فصارت قبورُهم شواهدَ على أرضٍ لا تعترفُ إلا بالأرقام.
“ كتبت عن حبِّ الوطن، وعن الغربة التي تأكل الروح، وعن شعبي الكوردي الذي لا يزال يُذبَحُ على مذبح الجغرافيا السياسية
أريدُ أن أقولَها بِمَرَارَةٍ: لقد خانني السِّياسيون الكورد قبل أن تخونني الغربة!
نعم، أولئك الذين رفعتُ صوتَهم في الإذاعات والصحف التي أسَّستُها، وكاتبتُ زعماء العالم مِن أجلهم، نَسُوني كأنني غُبارٌ على جبين التاريخ.
والان الصحفَ صارت أوراقًا تأكلها النيرانُ في ساحات الدبلوماسية، والإذاعاتَ صارت صرخاتٍ تختنقُ في زجاجاتِ السياسة الفارغة.
اليوم، وأنا أُساقُ إلى سجنٍ أكبرَ: سجنِ النسيان و الانكار .
قد تنسونني، لكن التاريخ سيذكر أن رجلاً واحدًا في المنفى صنع إعلامًا للقضية بينما كنتم تصنعون لنفسكم قصورًا.
تعلمون ما هو جُرْمي؟
أنني لم أنتمِ إلى سياستهم ضدَّ بعضهم، ولم أكتبْ ضدَّ الذين عارضوهم واختلفوا معهم.
وكلما طلبتُ دعمًا لأيِّ شيءٍ يُخفِّفُ مِن معاناة الغربة… قالوا:
*«لا نُمَوِّلُ المَنافي!»* بينما اشتروا فيلاتٍ وعقاراتٍ وفنادقَ في مدنِ وسواحلِ أستراليا بعشرات الملايين مِن دولاراتِ المسروقة من قوت شعبِ كوردستان المظلوم.
اليوم، وأنا أموت وحيدًا، لا أحد منهم يتذكَّر أن رجلاً كورديًّا في أستراليا دافع عنهم يوم كانت أستراليا تجهل حتى اسمَ “كوردستان”.
حولتُ دمي إلى حبرٍ في صحفٍ صارت وقودًا لسياساتهم
جُرْمي أنني آمنتُ بِـ “كوردستان” التي تَجمعنا، لا بالزعيم الذي يُفرِّقنا. دافعت عن وطن لا املك شبرا من أرضها.!.
### الفصل الرابع: محاولات البقاء
اخترعتُ طقوسًا للبقاء:
اخترعتُ طقوسًا لأسرق الحياةَ مِن فَكِّ الغربة:
–
> – أسمعُ نشيدَ *”ئەی رەقیب”* كلَّ صباحٍ… كأنِّي أردِّدُ مع الأبطال: *”لا تُسلَبوا كوردستانَ منّا مرتين: مرةً بالحدود، ومرةً بالنسيان والخيانة”*.
> – أشربُ شايَ الصباحِ مع تينٍ مجفَّفٍ من بستان جدي… كي لا تذوبَ آخرُ بصماتِ التربةِ التي مشيتُ عليها حافيًا.
> – أصابعي تتجوّلُ على خريطةِ أربيلَ المُتهالكة… كأنما ألمسُ وجهَ أمٍّ نسيَتها عيوني لكنّ قلبي لا يزال يُناديها.
> – قصائدُ *”الهيراني”* تتدفّقُ مِن شفتيَّ قبل النوم… فتُعيدُ للّغةِ الكوردية نبضَها في عروقي كـ *”نهرٍ يبحثُ عن منبعه”*.
> – أنامُ على صوت *”طاهر توفيق”* يُناجي: *”شيرين بهاره… شيرين أنها الربيع واتذكر ملامح ابي المسكين وهو يردد كلماتها”*… فأحلمُ بأنَّ الغربةَ مجرَّدُ كابوسٍ.
ربما لم تُغنِ هذه المحاولاتُ عنّي وَحشةَ المنفى…
لكنّها صنعتْ لي وطنًا مؤقتًا: حروفٌ تُشبهُني، تُولدُ كلَّ صباحٍ مِن رماد الذاكرة.
### مقارنة رمزية بين الماضي والحاضر:
«في كوردستان ، كنتُ أطارد الفراشات في حقول القمح وأشمُّ رائحةَ تبنِ “كارة” المُعتَّقِ تحت أشعة الشمس**، وعندما يُثقِلُ التعبُ جفوني، ألقي بنفسي في احضان الأرضِ كطفلٍ ينام في حضنِ أمه، “أسمعُ همسَ حجرِ الرَّحى يطحنُ القمحَ كأنه يُناجي الأجداد”.
أحلمُ بفراشةٍ ذهبيةٍ تحملني إلى حيثُ **رائحةُ “الشيلان” تختلطُ بأنفاسِ النهرِ القديم**…
أما هنا، فأجري خلف مواعيد الاطباء وأضيع في مترو سيدني وفي شوارعها الضيقة كمتشردٍ يبحث عن ظلٍّ لجرحه، أو كمجنونَ هربَ من مصحَّةٍ لا تعالجُ إلا الأجسادَ وتقتلُ الأرواح”*.
*”ألتفتُ. من حولي مفزوعا… أشباحٌ… عيونٌ بلا نظرات، وأجسادٌ تتحركُ كآلاتٍ نُزعت أرواحُها”*.
لقد عَلِمتُ يومًا أن الأولى كانت حُريةً… والثانية سجنٌ مُذهَّبٌ يُعلِّمُك أن **صوتَ آلةِ المصنعِ أغلى مِن ضحكةِ طفلٍ**».
*”كنت أحلمُ بأن أبني مدرسةً في شقلاوة تُعلِّم الأطفالَ كيف يقرأون نبضَ الأرضِ قبل الحروف، ويَسألون عن سرِّ موت الفراشاتِ أكثرَ مِن سُرعةِ الإنترنت”*.
لكنّ الغربة جعلتني ترسًا في ماكينةٍ لا تعرفُ إلا صريرَ الإنتاج.
*”كما لو أن ماركوز كان يخاطبني شخصيًّا: «أنت في المصنع مجرد ذاكرةٍ مشوَّهةٍ لطفل كان يرقصُ مع الفراشات!»”*.
**”هربرت ماركوز”** (مِن مدرسة فرانكفورت) يُعلِّق: *« **”الأنظمة تختزلنا إلى أرقامٍ في جدولٍ إكسيل، بينما تدفنُ أحلامَنا تحت ركام الإنتاج، فتقتل فيه روح الإبداع»*.
“في شقلاوة أسمعُ في الليلِ صوتَ ماء “دةنكارة” يهمسُ بأسماء أصدقائي المفقودين والمعدومين، اما هنا أستيقظُ على رائحةِ دخان واصوات السيارات ُنذرُ بيومٍ آخرَ بلا معنى.
الغربةُ ليست مكانًا.. بل رائحةٌ تختنقُ بها الروح، وصوتٌ يقطعُ أوتارَ الذاكرة.
“في المنفى، حتى الروائحُ تخونك.. رائحةُ التينِ الكرديِّ تموتُ في أنفك، ليحلَّ محلَّها عطرُ مُعقّماتٍ تقتلُ جرحَ الذاكرة وتعمق الضياع.
في “كريكور” (شقلاوة) كان صوتُ خرير ماء (زندور) يُهدهدني كأغنيةٍ لم تكتمل،**”أما في سيدني، فصوتُ القطارِ يُشبهُ أنينَ روحٍ تُحاكيها آلةٌ بلا قلب”.**
في “تم تم” كنت أشمُّ رائحةَ الترابِ بعد مطرٍ عابرٍ ، فتختلطُ بي ذكرياتُ أمي وهي تُعَلِّقُ الغسيلَ بين أشجار الجوز.
أما هنا، تَلتصقُ بي رائحةُ البلاستيكِ كجلدٍ ثانٍ تُذكّرني بِخِيانةِ الزمن”.
لقد سرقت مِنّي الغربةُ شبابي وأولادي وصحتي…
الوحدة في الغربة ليست اختيارًا، بل قدرًا مفروضًا حين ينقطع حبل التواصل مع الماضي.
الفيلسوفة حنة أرندت تقول: “أسوأ ما في المنفى أن الآخرين لا يسمعونك، أو يسمعونك لكنهم لا يفهمون”.
هذا ما حدث مع أولادي، فالحضارة الغربية علمتهم الفردية والأنانية، لكنها نسيتهم أن الإنسان جذور وكوردستان وانا جذورهم.
“سيمون دي بوفوار”** تصف هذا الضياع: *«الشيخوخة ليست عدد السنوات… بل الفجوة بين مَن كُنتَ ومَن أصبحتَ»*.
وتقول أيضًا: *«لو عَرَضَ المرءُ نفسَهُ صفحةً مقروءةً أمام غيره بكل نزاهةٍ… فإن الجميعَ تقريبًا سيجدون أنفسهم متورطين»*.
فيا تُرى… مَن هم المتورطون معي؟!
“أحيانًا أسأل نفسي: هل أنا الخائن لأني تركت كوردستان؟
فيجيبي صوتٌ من أعماقي:
بل أنت الضحية.. ضحية حدودٍ رسمها المستعمر، وشتّتت شعبًا كان يجب أن يكون دولة” و وقع تحت حكم الاخوة الاعداء الفاسدين.
: اعترافات منفيّ
“حلمتُ…
عدتُ طفلًا في كوردستان.
أركضُ حافيًا في بستان أبي.
آكلُ الترابَ فرحًا…
أسقطُ.
يختلطُ دمي بالتراب.
أستيقظُ.
صوتُ إنذار السكري يصرخ:
«هذا ليس وطنك!».
—
أعترفُ:
أنني لم أعد أتذكرُ وجة أمي بوضوح، وأنني بدأت أخلطُ بين أسماءِ إخوتي وأنسى أسماءَ الأزقةِ في أربيل،ولا أعرفُ كيف أتعاملُ مع مَنْ حولي” ،لكنني ما زلتُ أعرفُ كيف أبكي بالكوردية وارقص عطشاً كطير “القبج” المذبوح الذي ضحى بحياته من اجل انقاذ جنسه من القفص …..
ربما أموتُ هنا قريباً، في هذه الأرض البعيدة.
لكنّي سأطلبُ أن يُكتب على قبري:
“هنا يرقدُ كورديٌ حفر اسمَ وطنه على صخور الغربة..
فهل تسمعونه أخيراً؟”
ربما لن تنتهي غربتي بموتي، بل بموت آخر يتذكر كوردستان كما عرفتها.
سأظل أحفر في جسد المنفى، ليس بحثًا عن بصمة لي، بل عن بصمة للوطن في .
وعندما أعلم أن صوت حجر الرحى سيختفي يومًا، وأن رائحة شاي أمي ستتبخر من ذاكرتي.
حينها، سوف اصبح غريبًا حتى عن ذاتي ولن اتذكر حتى أسمي…
لكن اليوم، ما زلت أستطيع البكاء بعيون الشهداء… وما زلت أصرخ: ها هي ذي كوردستان — ليس فقط في الجغرافيا والخرائط المزيفة، بل في الجرح الذي احمله في اعماق روحي الذي لا يندمل, حتى الطائر المحبوس قد يغرد ذات صباح هنا كوردستان.
الخاتمة: رسالة إلى أبنائي.. وإلى كل شابٍّ….
لا تبيعوا ذاكرتكم كما باعوا دمي.
سأموت هنا غريبًا، لكنّ حروفِي ستظلُّ تُنزفُ اسمَ كوردستان على جدار الغربة.
(محمود درويش كان محقًا: المنفى هو آخر الأماكن… والوطنُ أولُّها.
لا تبيعوا ذاكرتكم في سوقِ الغربِ الرقميِّ.
الوطنُ ليس أرضًا فحسب… بل رائحةُ شايٍ تُرافقُ الموتَ في المنفى.
سيقولون لكم: “المستقبلُ هناك”.
لكن اِعلَموا أنَّ المستقبلَ سرابٌ…
إذا نسيتم أنَّ الماضيَ ينزفُ في عروقكم.
لا تنخدعوا ببريق الغرب، ولا بخطابات السياسيين الفارغة.
الغربة خيانةٌ مزدوجة: خيانةٌ للوطن الذي غادرتَ، وخيانةٌ للذات التي فقدتَ».
كما كان إدوارد سعيد محقاً حين قال: “المنفى هو المكان الذي يأتيك فيه البريد السياسي.. لكنه لا يأتي أبدًا من الوطن”.
أما أنا اصبحت كشجرة الدلب الكوردية (الشانة) التي تُقتلع من جبال زاغروس لِتُزرع في أرض غريبة..
تظل حية، لكن أوراقها تذبل، ولا تُزهر إلا حين تهمس لها الرياح بلغة كوردستان”.
“كما قال جبران خليل جبران” محقاً: “الغربة صمتٌ يابسٌ.. تشرب ماءه فلا يرتوي الظمأ”.
أعيشُ على “حقن الأنسولين” وذكريات الماضي، لكنني سأظلُّ أحذّركم:
لا تبيعوا عمركم في سوق الغربة.. فالشباب لا يعود، والأحلام إذا ماتت لا تُعود.
“سأموت غريبًا و وحيدا… لكن حروفي ستظل تنزف اسم كوردستان على جدار الغربة”
.. كتبتُ كي لا أموت.. وبقيتُ أموت كي أكتب….
**
*هوامش فلسفية وأدبية:
مارتن هايدغر:
“الوجود الإنساني هو وجودٌ مُلقى به في العالم”
سورين كيركغور:
“أعمق أشكال اليأس هو أن تفقد نفسك.. وتدرك أنك غريبٌ حتى عن ذاتك”
ألبير كامو:
“الإنسان غريب في كون لا صوت له يردُّ على صراخه” ” اسطورة “سيزيف”
اللورد أكتون:
“السلطة المطلقة تُفسد بشكل مطلق”
نعوم تشومسكي:
“السياسي الفاسد كالثعبان.. يلدغ حتى يدافع عن نفسه”
بول ريكور (الذاكرة، التاريخ، النسيان):
“الذاكرة هي آخر ملجأ للهوية حين يُنهب الوطن”
غاستون باشلار:
“ذاكرة الوطن تظل كندبة في الجسد، تُؤلم كلما اقترب المطر”
هربرت ماركوز:
“الأنظمة تختزل الإنسان في كونه مُنتجًا ومستهلكًا فقط”
سيمون دي بوفوار:
“الشيخوخة ليست عدد السنوات، بل الفجوة بين من كنتَ ومن أصبحت”
جبران خليل جبران:
“الغربة صمتٌ يابسٌ.. تشرب ماءه فلا يرتوي الظمأ” .
محمود درويش:
“المنفى هو هذا المكان الأخير.. الوطن هو هذا المكان الأول”
حسين خوشناو :
كتبتُ كي لا أموت.. وبقيتُ أموت كي أكتب. انين الغربة.
هوامش اخرى:
– اي رقيب (بالكوردية: «Ey Reqîb» أو «ئەی رهقیب») قصيدة كتبها الشاعر الكوردي دلدار أثناء وجوده في أحد المعتقلات في كوردستان إيران في 1938، ولحّنها حسين البرزنجي. المعنى الحرفي لعنوان النشيد «أيها الرقيب» إذ يخاطب الشاعر رقيب الذي سجنه .
اتخذت هذه القصيدة نشيداً وطنياً لجمهورية مهاباد التي نشأت في شمال غرب إيران واستمرت 11 شهراً.
وهي كذلك النشيد الوطني في إقليم كوردستان وتعتبر من مقداسات الشعب الكوردي في العالم.
. نوروز (Newroz/نەورۆز)
رأس السنة الكوردية: يُحتفل به في 21 آذار/مارس.
الطقوس: إشعال النيران (رمزًا للنور والانتصار على الظلم)، والرقصات الفلكلورية، وارتداء الملابس التقليدية.
الرمزية: يرتبط بأسطورة كاوا الحداد الذي انتصر على الطاغية ضحّاك، وفق الميثولوجيا الكوردية.
في النص: عبَّر الكاتب عن حزنه لفقدان نوروز في المنفى، كجزء من اغترابه الوجودي.
– شقلاوة (Şeqlawe/شەقڵاوە)
الموقع: مدينة صغيرة تابعة لمحافظة أربيل في إقليم كوردستان ، تقع على شمال شرق مدينة أربيل، عند سفح جبل سفين.
السِّمات: تشتهر ببساتين الجوز والكرز، وشلالاتها الطبيعية، وجبالها المغطاة بأشجار الصنوبر.
الثقافة: تُعتبر مركزًا للتراث الكوردي، حيث تُقام فيها مهرجانات شعرية وفنية. ذُكرت في النص كمهد الكاتب الذي ارتبط بذكريات طفولته.
. هولير (Hewlêr/ههولێر)
الاسم الكوردي لمدينة أربيل: عاصمة إقليم كوردستان ، وتُعد من أقدم المدن المأهولة في العالم (يعود تاريخها إلى 6000 ق.م).
المعالم: تشتهر بقلعتها التاريخية (قلعة أربيل) المُدرَجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
في النص: عبَّر الكاتب عن حنينه لرائحة المدينة التي تختلط فيها “رائحة الشاي بِدَمِ الحروب”، إشارة إلى تاريخها المليء بالصراعات والأمل.
دةشتي هولير (Dashtî Hewlêr/دەشتى ههولێر)
المعنى: “سهل أربيل” بالكوردية.
الموقع: سهل واسع يحيط بمدينة أربيل، يُستخدم لزراعة القمح والشعير.
الأهمية: يُعد مصدرًا رئيسيًّا للحبوب في كوردستان، ويرمز إلى الخصوبة والعطاء في الأدب الكوردي.
– هرير (Herîr/هەریر)
منطقة زراعية: تقع في محافظة أربيل، تشتهر بحقول القمح الممتدة.
في النص: ذُكرت كرمز للذاكرة الزراعية الكوردية التي تربط الإنسان بالأرض.
. جبال زاكروس (Zagros/زاجرۆس)
أطول سلسلة جبال في كوردستان: تمتد من إيران عبر العراق وتركيا.
الأهمية: تُعتبر رمزًا للهوية الكوردية ومقاومة الشعب الكوردي عبر التاريخ.
في النص: ذُكرت كخلفية لقصص الأجداد وكرمز للصمود.
. سفين (Sefîn/سفين)
جبل في شقلاوة: يُشكل معلمًا طبيعيًّا بارزًا، تُحيط به غابات صنوبر وبساتين فاكهة.
في النص: ارتبط بذكريات الكاتب عن طفولته في أحضان الطبيعة والوطن والنضال.
. خواكورك (Xwakurk/خواكورك)
جبل قريب من شقلاوة: يشتهر بتضاريسه الوعرة وينابيع المياه العذبة.
– جبل كارة يبلغ ارتفاع قمة جبل كاره 2151 م، عن سطح البحر وتقع شمال شرق مدينة دهوك. تعتبر قمة جبل كاره موقعاً سياحياً طبيعياً , وهي من اجمل جبال المنطقة.
الأهمية: ارتبط اسمه بالتراث الكوردي، حيث تُروى حوله حكايات شعبية عن الشجاعة والصمود.
في النص: ذُكر كرمز للذاكرة الجبلية التي تُمثِّل هوية الكورد
. دنكارة (Dengare/دەنگارە)
نهر ينبع من جبل سفين: يمر عبر شقلاوة، ويُستخدم لري البساتين.
في النص: ذُكر كرمز لـ “صوت الطبيعة” الذي كان يُهدهد الكاتب في طفولته.
. زندور (Zendûr/زەندۆر)
جدول ماء في شقلاوة: يتفرع من نهر دنكارة، ويجري بين بساتين الجوز.
الثقافة: ارتبط بصوت خرير المياه الذي يصفه الكورد بـ “أنشودة الطبيعة”.
. كريكور وتم تم (Krikor & Tem Tem/کریکۆر و تەم تەم)
منطقتان سكنيتان في شقلاوة: يُعتقد أن أسماءهما تعود إلى عائلات أرمنية عاشت في المنطقة تاريخيًّا.
التاريخ: خلال الحرب العالمية الأولى، هاجر العديد من الأرمن إلى كوردستان، وتركوا بصمتهم في أسماء الأماكن.
– مجكو” باللغة الكوردية ” مەچکۆ” مقهى أو “چايخانة “مجكو” تاسست في عام 1940م على يد مجيد إسماعيل المعروف بـ (مجكو)، تجاوزت”مجكو” في أربيل دورها كمجرد مكان تجمع لقضاء أوقات الفراغ وتناول المشروبات، لتختص بنشاط سياسي وثقافي موازٍ لدورها الأساسي، وتتحول إلى رمز يفوح منه عبق التاريخ ويجسد روح أربيل التاريخية.
تفصيل أدبي: ورد في النص أن والد الكاتب عمل في مقهى “مەچکۆ” (مجكو) التاريخي في أربيل خلال الخمسينيات.
. طاهر توفيق (Tahir Tawfiq/تاهر تەوفیق)
فنان كوردي: مغنٍّ وملحّن كوردي (1930–1998)، يُعتبر أحد أعمدة الغناء الكلاسيكي الكوردي.
أشهر أغانيه: “شيرين بهاره” (شيرن انها الربيع)، التي ذُكرت في النص كجزء من طقوس الكاتب للبقاء في المنفى.
التأثير: ارتبطت أغانيه بذاكرة جيل كامل من الكورد المناضلين الذين شاركو في تاسيس جمهورية مهاباد وانتكاسة 1974 ، حيث تجسّد الحنين إلى الوطن والنضال والحرية ضمن اغنية سياسية .
. صافي الهيراني (Safi Hirani/سافى ھەیرانی)12ز م
شاعر كوردي صوفي من هيران – شقلاوة، عُرف بجمعِه بين الروحانيات والرومانسية. ينتمي إلى عائلة دينية أرستقراطية حملت لقب “كاك” (السيد)، وكانت رائدة في نشر الطريقة القادرية الصوفية. تُغنّى قصائده في المناسبات الدينية والاحتفالات، وتحوّلت بعضها إلى أغانٍ خالدة بأصوات فنانين مثل طاهر توفيق. وعدنان كريم يُعتبر رمزًا للهوية الكوردية التي تقاوم النسيان عبر الكلمة والموسيقى.